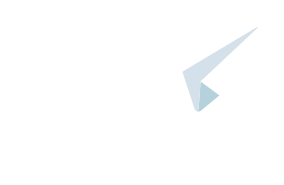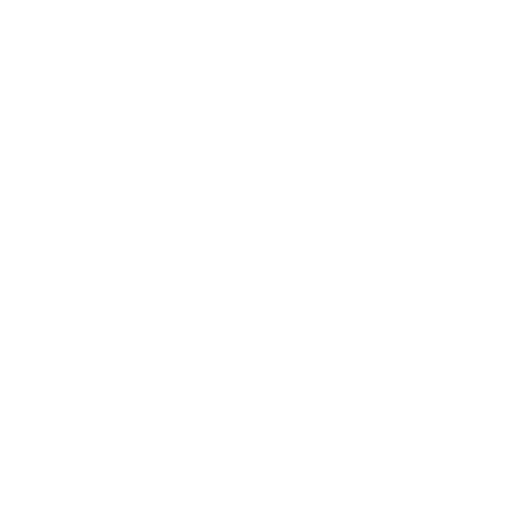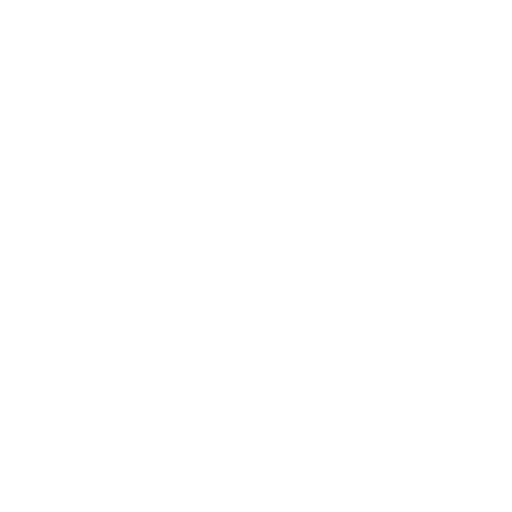التاريخ والحضارة

التاريخ

الحضارة

ابرز المؤرخين


اقوام وادي الرافدين

السومريون

الساميون

اقوام مجهولة


العصور الحجرية

عصر ماقبل التاريخ

العصور الحجرية في العراق

العصور القديمة في مصر

العصور القديمة في الشام

العصور القديمة في العالم

العصر الشبيه بالكتابي

العصر الحجري المعدني

العصر البابلي القديم

عصر فجر السلالات


الامبراطوريات والدول القديمة في العراق

الاراميون

الاشوريون

الاكديون

بابل

لكش

سلالة اور


العهود الاجنبية القديمة في العراق

الاخمينيون

المقدونيون

السلوقيون

الفرثيون

الساسانيون


احوال العرب قبل الاسلام

عرب قبل الاسلام

ايام العرب قبل الاسلام


مدن عربية قديمة

الحضر

الحميريون

الغساسنة

المعينيون

المناذرة

اليمن

بطرا والانباط

تدمر

حضرموت

سبأ

قتبان

كندة

مكة


التاريخ الاسلامي


السيرة النبوية

سيرة النبي (صلى الله عليه وآله) قبل الاسلام

سيرة النبي (صلى الله عليه وآله) بعد الاسلام


الخلفاء الاربعة

ابو بكر بن ابي قحافة

عمربن الخطاب

عثمان بن عفان


علي ابن ابي طالب (عليه السلام)

الامام علي (عليه السلام)

اصحاب الامام علي (عليه السلام)


الدولة الاموية

الدولة الاموية *


الدولة الاموية في الشام

معاوية بن ابي سفيان

يزيد بن معاوية

معاوية بن يزيد بن ابي سفيان

مروان بن الحكم

عبد الملك بن مروان

الوليد بن عبد الملك

سليمان بن عبد الملك

عمر بن عبد العزيز

يزيد بن عبد الملك بن مروان

هشام بن عبد الملك

الوليد بن يزيد بن عبد الملك

يزيد بن الوليد بن عبد الملك

ابراهيم بن الوليد بن عبد الملك

مروان بن محمد


الدولة الاموية في الاندلس

احوال الاندلس في الدولة الاموية

امراء الاندلس في الدولة الاموية


الدولة العباسية

الدولة العباسية *


خلفاء الدولة العباسية في المرحلة الاولى

ابو العباس السفاح

ابو جعفر المنصور

المهدي

الهادي

هارون الرشيد

الامين

المأمون

المعتصم

الواثق

المتوكل


خلفاء بني العباس المرحلة الثانية


عصر سيطرة العسكريين الترك

المنتصر بالله

المستعين بالله

المعتزبالله

المهتدي بالله

المعتمد بالله

المعتضد بالله

المكتفي بالله

المقتدر بالله

القاهر بالله

الراضي بالله

المتقي بالله

المستكفي بالله


عصر السيطرة البويهية العسكرية

المطيع لله

الطائع لله

القادر بالله

القائم بامرالله


عصر سيطرة السلاجقة

المقتدي بالله

المستظهر بالله

المسترشد بالله

الراشد بالله

المقتفي لامر الله

المستنجد بالله

المستضيء بامر الله

الناصر لدين الله

الظاهر لدين الله

المستنصر بامر الله

المستعصم بالله

تاريخ اهل البيت (الاثنى عشر) عليهم السلام

شخصيات تاريخية مهمة

تاريخ الأندلس

طرف ونوادر تاريخية


التاريخ الحديث والمعاصر


التاريخ الحديث والمعاصر للعراق

تاريخ العراق أثناء الأحتلال المغولي

تاريخ العراق اثناء الاحتلال العثماني الاول و الثاني

تاريخ الاحتلال الصفوي للعراق

تاريخ العراق اثناء الاحتلال البريطاني والحرب العالمية الاولى

العهد الملكي للعراق

الحرب العالمية الثانية وعودة الاحتلال البريطاني للعراق

قيام الجهورية العراقية

الاحتلال المغولي للبلاد العربية

الاحتلال العثماني للوطن العربي

الاحتلال البريطاني والفرنسي للبلاد العربية

الثورة الصناعية في اوربا


تاريخ الحضارة الأوربية

التاريخ الأوربي القديم و الوسيط

التاريخ الأوربي الحديث والمعاصر
دوافع الهجرة من مكة إلى المدينة
المؤلف:
السيد جعفر مرتضى العاملي.
المصدر:
الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله
الجزء والصفحة:
ج 4، ص 156- 166
3-6-2021
3043
دوافع الهجرة من مكة إلى المدينة :
إننا بالنسبة لدوافع الهجرة من مكة إلى المدينة يمكننا الإشارة إلى ما يلي :
أولا : إن مكة لم تعد أرضا صالحة للدعوة ، فقد حصل النبي «صلى الله عليه وآله» منها على أقصى ما يمكن الحصول عليه ، ولم يبق بعد أي أمل في دخول فئات جديدة في الدين الجديد ، في المستقبل القريب على الأقل.
وقد كان ثمة مبرر لتحمل الأذى والمصاعب ، حينما كان يؤمل أن تدخل في الإسلام جماعات تقويه ، وتشد من أزره.
أما بعد أن أعطت مكة كل ما لديها فأخرجت جماعات من شبان المؤمنين ، ومن المستضعفين ، ولم يبق فيها إلا ما يوجب الصد عن سبيل الله ، ويضع الحواجز والعراقيل الكثيرة أمام تقدم هذا الدين ، ويمنع من انتشاره واتساعه ؛ فإن البقاء في مكة ليس فقط لا مبرر له ، بل هو خيانة للدعوة الإسلامية ، ومساعدة على حربها ، والقضاء عليها ، ولا سيما بعد أن جندت قريش كل طاقاتها للصد عن سبيل الله ، وإطفاء نوره ، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون.
نعم ، لقد كان لا بد من الانتقال إلى مركز آخر ، تضمن الدعوة فيه لنفسها حرية الحركة ، في القول والعمل ، بهدوء بال ، واطمئنان خاطر ، بعيدا عن ضغوط المشركين ، وفي منأى عن مناطق سيطرتهم ونفوذهم.
وقد رأينا : أنهم كانوا يلاحقون تحركات النبي «صلى الله عليه وآله» ، ويرصدونها بدقة ، ويتهددون ، بل ويعذّبون كل من يدخل في هذا الدين الجديد ، ويخيفون كل من يحتمل دخولهم فيه.
ثانيا : إن الإسلام وممثله وداعيته الرسول الأكرم «صلى الله عليه وآله»
لا يمكن له أن يقتنع بهذا النصيب المحدود من التقدم ، لأن دينه دين البشرية جمعاء : (وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ)(١).
وما حصل عليه حتى الآن لا يمكّنه من تطبيق تشريعات الإسلام كافة ، وتحقيق كامل أهدافه ، ولا سيما بالنسبة إلى ذلك الجانب ، الذي يعالج مشاكل الناس الاجتماعية وغيرها ، مما يحتاج إلى القوة والمنعة في مجال فرض القانون والنظام.
ومن الناحية الأخرى : إنه إذا كان بنو عبد المطلب والهاشميون قد استطاعوا أن يؤمنوا الحماية لشخص الرسول من اعتداءات الآخرين على شخصه الكريم ، فإنهم لم ولن يستطيعوا أن يؤمنوا له القدرة على حماية أصحابه ، الذين دخلوا في هذا الدين ، وقبلوا رسالة السماء.
فضلا عن أن يتمكنوا من تأمين الحد الأدنى من الحماية له ، فيما لو أراد أن يتوسع في نشر رسالة الإسلام ، وفرض هيمنة هذا الدين وسلطانه ، إذا احتاج الأمر إلى ذلك.
وأما بعد وفاة أبي طالب «رحمه الله» فإن الأمور قد تطورت بشكل مخيف ، حتى بالنسبة إلى شخص النبي الأعظم «صلى الله عليه وآله» ، كما رأينا وسنرى.
ثالثا : ولقد صمد أولئك الذين أسلموا سنوات طويلة في مواجهة التعذيب والظلم والاضطهاد ، حتى لقد فر قسم منهم بدينه إلى بلاد الغربة ، وبقي الباقون يواجهون محاولات فتنتهم عن دينهم ، بمختلف وسائل القهر تارة ، وبأساليب متنوعة من الإغراء أخرى.
وإذا استثنينا أشخاصا معدودين ، كحمزة أسد الله وأسد رسوله ، وبعض من كانت لهم عشائر تمنعهم (2) ، فإن بقية المسلمين كانوا غالبا من ضعفاء الناس ، الذين لا يستطيعون حيلة ، ولا يجدون سبيلا إلا الصبر ، وتحمل الأذى.
وإذا فرض عليهم أن يستمروا في مواجهة هذه الآلام والمشاق ، دونما أمل أو رجاء ؛ فمهما كانت قناعتهم بهذا الدين قوية وراسخة ؛ فإن من الطبيعي ـ والحالة هذه ـ أن يتطرق اليأس إلى نفوسهم ، ثم الهروب والملل من حياة كهذه.
وقد تستميلهم بعض الإغراءات العاجلة ، فيهلكون ويهلكون ؛ فإنه ليس بمقدورهم أن يقضوا حياتهم بالآلام والمتاعب.
بل إن بعضهم ـ كما سيأتي ـ يهم بالعودة إلى الشرك ، ويتطلب السبل لمصالحة مشركي مكة ، حينما أشيع في غزوة أحد : أن النبي «صلى الله عليه وآله» وسلم قد قتل. وقد نزل في ذلك قرآن يتلى إلى يوم القيامة : (وَما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ)(3).
رابعا : لقد رأت قريش أخيرا : أنها قد اهتدت للطريقة التي تستطيع بواسطتها أن تقتل النبي «صلى الله عليه وآله» ، دون أن تكون مسؤولة أمام الهاشميين بشكل محدد ، أو بالأحرى دون أن يستطيع الهاشميون أن يطالبوا بدم النبي «صلى الله عليه وآله» ، وذلك بأن يقتله عشرة ، كل واحد منهم من قبيلة ، فيضيع دمه في القبائل ، ولا يستطيع الهاشميون مقاومتها جميعا ؛ لأنهم إما أن يقاتلوا القبائل كلها ، وتكون الدائرة عليهم ، وإما أن يقبلوا بالدية ، وهو الأرجح.
وإذا قتل النبي «صلى الله عليه وآله» ، فإن القضاء على غيره من أتباعه يكون أسهل وأيسر ، ولا يشكّل لقريش مشكلة ذات شأن.
بل وحتى لو تركوهم على ما هم عليه ، فإن أمرهم لسوف يصير إلى التلاشي والاضمحلال.
هكذا كانت تفكر قريش وتخطط ، وهو تفكير محكوم بالعصبية القبلية ، ولكنه ذكي جدا.
وبالإمكان تحقيق الأهداف الشريرة تجاه الرسول والرسالة من خلاله.
ولكن عناية الله سبحانه وإن كانت تشمل النبي «صلى الله عليه وآله» وترعاه ، إلا أن من الواضح : أن إقدام قريش على تنفيذ مخططاتها ـ فشلت أو نجحت ـ لسوف يعرض علاقاتها مع الهاشميين لنكسة خطيرة ، ولسوف تزيد مضاعفاتها بشكل مخيف ببقاء النبي «صلى الله عليه وآله» في مكة.
كما أن سنة الله قد جرت على أن لا يحول بين أحد وبين تنفيذ إرادته ، بشكل قهري وقسري ، إلا بنحو من العنايات والألطاف التي تشمل ذلك النبي الذي يكون حفظه ضروريا لحفظ الدين والإنسان.
فإرادة الإنسان حرة طليقة ، ولكن الله يسدد ويلهم ويؤيد من تستهدفه تلك الإرادة بالشر والأذى.
وبعد كل ما تقدم يتضح : أنه كان لا بد للنبي الأعظم «صلى الله عليه وآله» ، ولمن معه من المسلمين من الخروج من مكة إلى مكان أمن وسلام لا يشعرون فيه بأي ضغط ، يملكون فيه حرية الحركة ، وحرية الكلمة ، وحرية التخطيط لبناء مجتمع إسلامي يكون فيه النبي «صلى الله عليه وآله» قادرا على القيام بنشر دعوته ، وإبلاغ رسالته ، على النحو الأفضل والأكمل.
سر اختيار المدينة :
وأما عن سر اختيار النبي «صلى الله عليه وآله» ـ الذي لا ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحي يوحى ـ للمدينة بالذات دارا لهجرته ، ومنطلقا لدعوته ، دون غيرها كالحبشة مثلا ؛ فذلك يرجع إلى عدة عوامل ، نذكر منها ما يلي :
١ ـ إن مكة كانت ـ كما قدمنا ـ تتمتع بمكانة خاصة في نفوس الناس ، وبدون السيطرة عليها ، والقضاء على نفوذها الوثني ، واستبداله بالنفوذ الإسلامي ؛ فإن الدعوة تعتبر فاشلة ، وكل الجهود تبقى بدون جدوى ؛ فإن الدعوة كانت بحاجة إلى مكة ، بنفس القدر الذي كانت مكة بحاجة فيه إلى الدعوة.
فلا بد من اختيار مكان قريب منها ، يمكن أن يمارس منه عليها رقابة ، ونوعا من الضغط السياسي والاقتصادي ، وحتى العسكري إن لزم الأمر في الوقت المناسب ، حينما لا بد له من أن يفرض سلطته عليها.
والمدينة ، هي ذلك الموقع الذي تتوفر فيه مقومات هذا الضغط ، فهي تستطيع مضايقة مكة اقتصاديا ؛ لوقوعها على طريق القوافل التجارية المكية ، وقريش تعيش على التجارة بالدرجة الأولى.
كما أن ذلك يهيئ للنبي «صلى الله عليه وآله» الفرصة لعرض دعوته على القوافل التي تتجه من بلاد الشام والأردن وفلسطين وغيرها إلى مكة ، والتمهيد لإفشال كثير من الدعايات التي يمكن للمكيين أن يطلقوها ضد الإسلام وأهله.
وقد تقدم قول المشركين لعبد الله بن أبي ، حين بيعة العقبة : «ما من حي أبغض من أن تنشب الحرب بيننا وبينه منكم».
وتقدم أيضا : أنهم لما أخذوا سعد بن عبادة بعد بيعة العقبة وعذبوه ، جاء الحارث بن حرب وجبير بن مطعم وخلصاه ، لأنه كان يجير لهما تجارتهما.
وإذا كانت قريش قد لقيت من أبي ذر ما لقيت ، حين أخذ عليها طريق تجارتها ، فإن ما سوف تلقاه من أهل المدينة سيكون أشد ، وأعظم خطرا ، وأبعد أثرا ، ولا سيما إذا عقد الرسول «صلى الله عليه وآله» تحالفات مع سائر القبائل المقيمة في المنطقة ، كما حصل بالفعل ، وكانت المعاهدة بصورة تجعلهم مضطرين لقطع علاقاتهم بالمشركين (4).
٢ ـ لقد عرفنا مما تقدم : أن الهجرة إلى المدينة هي الحل المفروض ، الذي لا خيار معه ؛ وذلك لأن الهجرة إلى الطائف لم تكن بالتي تجدي نفعا ، بعد أن رأينا : أن أهلها رفضوا الاستجابة إلى النبي «صلى الله عليه وآله» حينما هاجر إليهم ، لأنهم يرون : أن مكة هي التي تستطيع أن تضايقهم اقتصاديا ، وهم إليها أحوج منها إليهم.
ولأجل ذلك فإنهم لا يستطيعون في المستقبل المنظور على الأقل إلا أن يدوروا سياسيا في فلكها ، وأن يخضعوا لسيطرتها.
وأما سائر قبائل العرب ؛ فلا يجدون في أنفسهم القدرة على ذلك ، وقد جرب أن يعرف مدى استعدادهم لقبول دعوته ، والدفاع عنها ؛ فوجد ما لا ينقع غلة ، ولا يبل صدى ، إن لم نقل إنه وجد ما يزيد الطين بلة ، والأمر خطورة.
وأما اليمن ، وفارس ، والروم ، وبلاد الشام وغيرها ؛ فقد كانت خاضعة لسلطة الدولتين العظميين ، اللتين لن يكون نصيب الرسول والرسالة منهما سوى المتاعب والأخطار الجسيمة.
وقد تكلمنا عن شيء من ذلك عند الحديث عن عوامل انتصار الإسلام وانتشاره في أواخر الباب الأول من هذا الكتاب.
ولسوف نرى أن كسرى قد حاول أن يقوم بعملية خطيرة تجاه الرسول ورسالته حينما أرسل إليه «صلى الله عليه وآله» يدعوه إلى الإسلام.
وأما الحبشة فهي بحكم موقعها الجغرافي مفصولة عن مكة ، كما أنها بحكم واقعها الاجتماعي ، والسياسي ، والبشري ، والعنصري ، وبحكم كونها بلدا أفريقيا ، فإنها ليست بلدا قادرا على أن يقود عملية التغيير العالمية الشاملة ، لا اقتصاديا ، ولا سياسيا ، ولا عسكريا ، ولا حتى فكريا ، واجتماعيا.
أضف إلى ذلك : أن مهاجمة مكة بجيش من الحبشة لسوف يدفع العرب كافة إلى الوقوف إلى جانب قريش ضده ، بخلاف ما لو كانت عملية التغيير منطلقة من الداخل حينما يؤمن بدعوته الفقراء ، والمستضعفون ، ويواجه هؤلاء الملأ والمستكبرين من قومهم بالذات.
وهكذا يتضح : أنه ليس ثمة إلا المدينة ، والمدينة فقط ، موقعا مناسبا للهجرة فكانت الهجرة إليها.
٣ ـ ومن الجهة الأخرى ، فإن المدينة كانت أغنى من مكة زراعيا ، أي أنها لو فرض عليها أن تتعرض لضغط تجاري من نوع ما ـ مع أنه ليس باستطاعة مكة أن تفعل شيئا من ذلك ـ فإنها تستطيع أن تقاوم هذا الضغط ، وتحتفظ لنفسها بنوع من الحياة ، ولو بصعوبة ما ، من دون أن تستسلم لإرادة الآخرين ، وتنساق وراء رغباتهم ، كما كان الحال بالنسبة لغيرها.
هذا عدا عن أن الدعوة التي تحتاج إلى نشاط واسع ، وجهد شامل ، لأنها تريد أن تقود عملية التغيير الشامل على مستوى عالمي ـ هذه الدعوة ـ تحتاج إلى استقرار اقتصادي داخلي ، يستطيع أن يوفر الفرصة لحملة هذه الرسالة للحركة في سبيل نشر دينهم ، وبث رسالتهم.
٤ ـ وإذا كان الحج من أهم تشريعات الإسلام ؛ فما دامت مكة في أيدي الوثنيين ؛ فإنه سوف يفقد أثره وفعاليته في مجال التربية السياسية ، والاجتماعية ، وفي غير ذلك من مجالات ، وأيضا ، فما دامت مكة في أيدي الوثنيين ، فلسوف يبقى لهم نفوذ واسع في القبائل العربية ، وقدسية من نوع ما في نفوسهم.
فلا بد إذا من إخراجها من أيديهم ؛ لينتهي ما لهم من رصيد معنوي في نفوس الناس ، ولتنفتح القلوب بكل ما لديها على الدين الجديد ، وليتمكن المسلم من أن يؤدي إحدى أعظم شعائره ـ الحج ـ بحرية تامة ، دونما رادع أو زاجر.
ويدل على ذلك ، ما يرويه الطبراني وغيره : أنه لما عرض النبي الإسلام على ذي الجوشن الضبابي ، أبى أن يدخل فيه إلا أن يرى النبي «صلى الله عليه وآله» قد غلب على الكعبة.
وفي رواية أخرى ، أنه قال له : «رأيت قومك قد كذبوك ، وأخرجوك ، وقاتلوك ، فانظر ماذا تصنع ؛ فإن ظهرت عليهم آمنت بك ، واتبعتك ، وإن ظهروا عليك لم أتبعك» (5).
وبعد هذا ، فإن أقرب المواقع إلى مكة هو المدينة ، وهي التي تملك إلى جانب قوتها الاقتصادية كثافة سكانية جيدة ، تستطيع أن تقوم بالمهمة التي توكل إليها تجاه مكة على أكمل وجه ، ولا توجد هذه الميزة في أي من المناطق القريبة إلى مكة.
ونلاحظ : أن إيجاب الهجرة على من يسلم ، قد جعل المدينة ـ بعد هجرة الرسول «صلى الله عليه وآله» إليها ـ في حالة نمو سكاني مستمر ، يؤهلها لتحمل مسؤولية بناء دولة ، وحماية منجزاتها على المدى المنظور.
٥ ـ إن أهل المدينة كانوا في الأصل من مهاجري اليمن ، التي كانت تمتلك شيئا من الحضارة البدائية في قديم الزمان ، فهم ليسوا أعرابا ؛ لتكون قلوبهم ممعنة في القسوة.
ولا كان ثمة زعامات ومصالح خطيرة لهم في المنطقة ، كما كان الحال بالنسبة لقريش ، ولا كانوا يعيشون في تلك الأجواء النفسية المعينة ، كما كانت تعيش قريش ؛ نتيجة لموقعها النسبي في العدنانية ، ولموقعها في زعامة مكة ، وحجابة البيت.
ثم هناك التنافس الظاهر بين العدنانية والقحطانية ، حيث لا يسع القحطانيين ، حتى ولو لم تكن ثمة دوافع دينية وعقيدية : أن يسلّموا النبي «صلى الله عليه وآله» إلى أعدائه.
ويشهد لهذا : أننا نجد بقايا هذا التنافي حتى إلى ما بعد وفاة النبي «صلى الله عليه وآله» ؛ فنجد أن عمر بن الخطاب قد فضل العدنانية على القحطانية في العطاء ، الأمر الذي مهد السبيل أمام الأمويين لاستغلال هذه الروح وإشعال الفتن بين اليمانية والقيسية ، إبان حكمهم البغيض.
بينما نجد أمير المؤمنين «عليه السلام» لم يكن يرى لبني إسماعيل على بني إسحاق فضلا. (ولهذا البحث مجال آخر).
٦ ـ ثم إن أهل المدينة قد ذاقوا مرارة الانحراف كأشد ما يكون ، وقد أنهكتهم الحروب وأكلتهم ، ويعيشون في رعب دائم وخوف مستمر ، حتى إنهم ما كانوا يضعون السلاح لا في الليل ولا بالنهار (6).
وتقدم : أن الخزرج ذهبوا إلى مكة يطلبون الحلف من القرشيين فلم تلب قريش طلبهم.
وكانوا يتمنون من كل قلوبهم : أن يجدوا مخرجا من المأزق الذي يرون أنفسهم فيه ، حتى إن أسعد بن زرارة لا يخفي لهفته على هذا الأمر ؛ حيث قال للنبي «صلى الله عليه وآله» حينما دعاه إلى الإسلام : «إنا من أهل يثرب من الخزرج ، وبيننا وبين إخوتنا من الأوس حبال مقطوعة ، فإن وصلها الله بك ، ولا أحد أعز منك الخ ..» (7).
ثم وبعد أن دخل الإسلام إلى المدينة ، فقد كان لا بد أيضا من الحفاظ على المسلمين فيها ، وشد أزرهم ، حتى يمكن لهم الاستمرار في نصرة هذا الدين ، وإعلاء كلمة الله.
٧ ـ لقد كانت بشائر اليهود بقرب ظهور نبي في المنطقة قد جعلت الكل مستعدين لقبول هذا الدين.
ولكنهم يحتاجون إلى مناسبات دافعة ، إلى ظروف مشجعة ؛ فلماذا يهملهم الرسول «صلى الله عليه وآله» ، ولا يهيئ لهم الفرصة لذلك؟!.
٨ ـ هذا كله ، عدا عن أن أهل المدينة أنفسهم قد طلبوا ذلك من النبي الأكرم «صلى الله عليه وآله» وبايعوه بيعة العقبة ، ووعدوه النصر ، والنبي «صلى الله عليه وآله» إنما يتصرف وفق الإرادة الإلهية التي لا تغيب عنها تلك المصالح وسواها.
فالله هو الذي يرعاه ويسدده ، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين ، هذا ما رأينا الإشارة إليه في هذا الصدد.
__________________
(١) الآية ٢٨ من سورة سبأ.
(2) وحتى هؤلاء فإنهم لم يسلموا من الاضطهاد النفسي والمقت الاجتماعي المر ، ولربما يكون ذلك بالنسبة لبعضهم أشد من التعذيب الجسدي ، تبعا لنسبة الوعي والشعور المرهف الذي كان يمتاز به بعضهم على غيره.
(3) الآية ١٤٤ من سورة آل عمران.
(4) راجع : وثيقة المدينة الآتية في الجزء التالي من هذا الكتاب ؛ آخر فصل : أعمال تأسيسية في مطلع الهجرة. فقد جاء فيها ما يلي : «وأنه لا يجير مشرك مالا لقريش ، ولا نفسا ، ولا يحول دونه على مؤمن». وراجع : نشأة الدولة الإسلامية : ص ٢٨٩ ـ ٢٩٥.
(5) مجمع الزوائد ج ٦ ص ٦٨ ، وقال : «رواه عبد الله بن أحمد ، وأبوه ، ولم يسق المتن ، والطبراني ورجالهما رجال الصحيح ، وروى أبو داود بعضه» انتهى.
(6) البحار : ج ١٩ ص ٨ و ٩ و ١٠ ، وأعلام الورى : ص ٥٥.
(7) البحار : ج ١٩ ، وإعلام الورى : ص ٥٧.
 الاكثر قراءة في سيرة النبي (صلى الله عليه وآله) بعد الاسلام
الاكثر قراءة في سيرة النبي (صلى الله عليه وآله) بعد الاسلام
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية












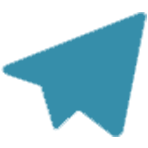
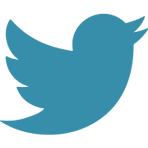

 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)