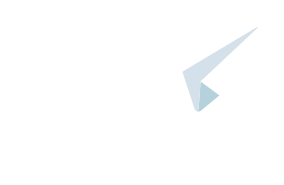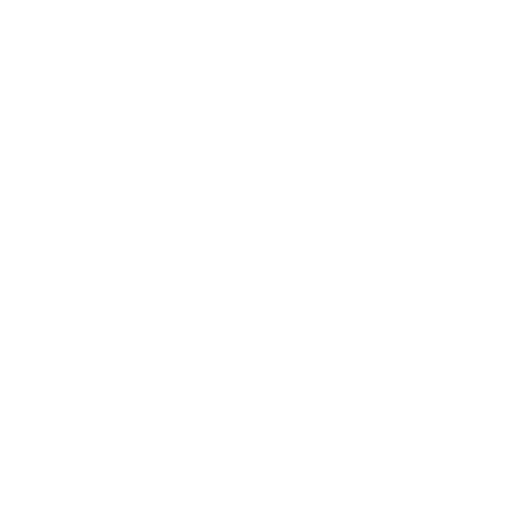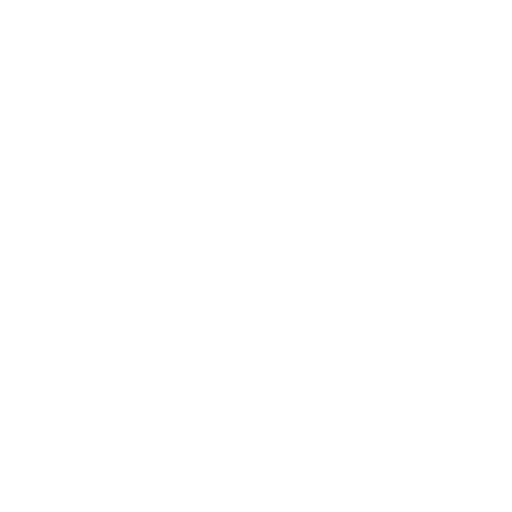تأملات قرآنية

مصطلحات قرآنية

هل تعلم


علوم القرآن

أسباب النزول


التفسير والمفسرون


التفسير

مفهوم التفسير

التفسير الموضوعي

التأويل


مناهج التفسير

منهج تفسير القرآن بالقرآن

منهج التفسير الفقهي

منهج التفسير الأثري أو الروائي

منهج التفسير الإجتهادي

منهج التفسير الأدبي

منهج التفسير اللغوي

منهج التفسير العرفاني

منهج التفسير بالرأي

منهج التفسير العلمي

مواضيع عامة في المناهج


التفاسير وتراجم مفسريها

التفاسير

تراجم المفسرين


القراء والقراءات

القرآء

رأي المفسرين في القراءات

تحليل النص القرآني

أحكام التلاوة


تاريخ القرآن

جمع وتدوين القرآن

التحريف ونفيه عن القرآن

نزول القرآن

الناسخ والمنسوخ

المحكم والمتشابه

المكي والمدني

الأمثال في القرآن

فضائل السور

مواضيع عامة في علوم القرآن

فضائل اهل البيت القرآنية

الشفاء في القرآن

رسم وحركات القرآن

القسم في القرآن

اشباه ونظائر

آداب قراءة القرآن


الإعجاز القرآني

الوحي القرآني

الصرفة وموضوعاتها

الإعجاز الغيبي

الإعجاز العلمي والطبيعي

الإعجاز البلاغي والبياني

الإعجاز العددي

مواضيع إعجازية عامة


قصص قرآنية


قصص الأنبياء

قصة النبي ابراهيم وقومه

قصة النبي إدريس وقومه

قصة النبي اسماعيل

قصة النبي ذو الكفل

قصة النبي لوط وقومه

قصة النبي موسى وهارون وقومهم

قصة النبي داوود وقومه

قصة النبي زكريا وابنه يحيى

قصة النبي شعيب وقومه

قصة النبي سليمان وقومه

قصة النبي صالح وقومه

قصة النبي نوح وقومه

قصة النبي هود وقومه

قصة النبي إسحاق ويعقوب ويوسف

قصة النبي يونس وقومه

قصة النبي إلياس واليسع

قصة ذي القرنين وقصص أخرى

قصة نبي الله آدم

قصة نبي الله عيسى وقومه

قصة النبي أيوب وقومه

قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله


سيرة النبي والائمة

سيرة الإمام المهدي ـ عليه السلام

سيرة الامام علي ـ عليه السلام

سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله

مواضيع عامة في سيرة النبي والأئمة


حضارات

مقالات عامة من التاريخ الإسلامي

العصر الجاهلي قبل الإسلام

اليهود

مواضيع عامة في القصص القرآنية


العقائد في القرآن


أصول

التوحيد

النبوة

العدل

الامامة

المعاد

سؤال وجواب

شبهات وردود

فرق واديان ومذاهب

الشفاعة والتوسل

مقالات عقائدية عامة

قضايا أخلاقية في القرآن الكريم

قضايا إجتماعية في القرآن الكريم

مقالات قرآنية


التفسير الجامع


حرف الألف

سورة آل عمران

سورة الأنعام

سورة الأعراف

سورة الأنفال

سورة إبراهيم

سورة الإسراء

سورة الأنبياء

سورة الأحزاب

سورة الأحقاف

سورة الإنسان

سورة الانفطار

سورة الإنشقاق

سورة الأعلى

سورة الإخلاص


حرف الباء

سورة البقرة

سورة البروج

سورة البلد

سورة البينة


حرف التاء

سورة التوبة

سورة التغابن

سورة التحريم

سورة التكوير

سورة التين

سورة التكاثر


حرف الجيم

سورة الجاثية

سورة الجمعة

سورة الجن


حرف الحاء

سورة الحجر

سورة الحج

سورة الحديد

سورة الحشر

سورة الحاقة

الحجرات


حرف الدال

سورة الدخان


حرف الذال

سورة الذاريات


حرف الراء

سورة الرعد

سورة الروم

سورة الرحمن


حرف الزاي

سورة الزمر

سورة الزخرف

سورة الزلزلة


حرف السين

سورة السجدة

سورة سبأ


حرف الشين

سورة الشعراء

سورة الشورى

سورة الشمس

سورة الشرح


حرف الصاد

سورة الصافات

سورة ص

سورة الصف


حرف الضاد

سورة الضحى


حرف الطاء

سورة طه

سورة الطور

سورة الطلاق

سورة الطارق


حرف العين

سورة العنكبوت

سورة عبس

سورة العلق

سورة العاديات

سورة العصر


حرف الغين

سورة غافر

سورة الغاشية


حرف الفاء

سورة الفاتحة

سورة الفرقان

سورة فاطر

سورة فصلت

سورة الفتح

سورة الفجر

سورة الفيل

سورة الفلق


حرف القاف

سورة القصص

سورة ق

سورة القمر

سورة القلم

سورة القيامة

سورة القدر

سورة القارعة

سورة قريش


حرف الكاف

سورة الكهف

سورة الكوثر

سورة الكافرون


حرف اللام

سورة لقمان

سورة الليل


حرف الميم

سورة المائدة

سورة مريم

سورة المؤمنين

سورة محمد

سورة المجادلة

سورة الممتحنة

سورة المنافقين

سورة المُلك

سورة المعارج

سورة المزمل

سورة المدثر

سورة المرسلات

سورة المطففين

سورة الماعون

سورة المسد


حرف النون

سورة النساء

سورة النحل

سورة النور

سورة النمل

سورة النجم

سورة نوح

سورة النبأ

سورة النازعات

سورة النصر

سورة الناس


حرف الهاء

سورة هود

سورة الهمزة


حرف الواو

سورة الواقعة


حرف الياء

سورة يونس

سورة يوسف

سورة يس


آيات الأحكام

العبادات

المعاملات
تفسير الآية (1-12) من سورة يس
المؤلف:
إعداد : المرجع الإلكتروني للمعلوماتية
المصدر:
تفاسير الشيعة
الجزء والصفحة:
.....
8-10-2020
37866
قال تعالى : {يس (1) وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ (2) إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (3) عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (4) تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (5) لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ (6) لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (7) إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ (8) وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (9) وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (10) إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ (11) إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ} [يس : 1 - 12]
تفسير مجمع البيان
- ذكر الطبرسي في تفسير هذه الآيات (1) :
{يس} قد مضى الكلام في الحروف المعجمة عند مفتتح السور في أول البقرة واختلاف الأقوال فيها وقيل أيضا {يس} معناه يا إنسان عن ابن عباس وأكثر المفسرين وقيل معناه يا رجل عن الحسن وأبي العالية وقيل معناه يا محمد عن سعيد بن جبير ومحمد بن الحنفية وقيل معناه يا سيد الأولين والآخرين وقيل هو اسم النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) عن علي ابن أبي طالب وأبي جعفر (عليه السلام) وقد ذكرنا الرواية فيه قبل {والقرآن الحكيم} أقسم سبحانه بالقرآن المحكم من الباطل وقيل سماه حكيما لما فيه من الحكمة فكأنه المظهر للحكمة الناطق بها {إنك لمن المرسلين} أي ممن أرسله الله تعالى بالنبوة والرسالة {على صراط مستقيم} يؤدي بسالكه إلى الحق أو إلى الجنة وقيل معناه على شريعة واضحة وحجة لائحة .
{تنزيل العزيز} أي هذا القرآن تنزيل العزيز في ملكه {الرحيم} بخلقه ولذلك أرسله ثم بين سبحانه الغرض في بعثته فقال {لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم} أي لتخوف به من معاصي الله قوما لم ينذر آباؤهم قبلهم لأنهم كانوا في زمان الفترة بين عيسى ومحمد (صلى الله عليه وآله وسلّم) عن قتادة وقيل لم يأتهم نذير من أنفسهم وقومهم وإن جاءهم من غيرهم عن الحسن وقيل معناه لم يأتهم من أنذرهم بالكتاب حسب ما آتيت وهذا على قول من قال كان في العرب قبل نبينا (صلى الله عليه وآله وسلّم) من هو نبي كخالد بن سنان وقس بن ساعدة وغيرهما وقيل معناه لتنذر قوما كما أنذر آباؤهم عن عكرمة .
{فهم غافلون} عما تضمنه القرآن وعما أنذر الله به من نزول العذاب والغفلة مثل السهو وهو ذهاب المعنى عن النفس ثم أقسم سبحانه مرة أخرى فقال {لقد حق القول على أكثرهم} أي وجب الوعيد واستحقاق العقاب عليهم {فهم لا يؤمنون} ويموتون على كفرهم وقد سبق ذلك في علم الله تعالى وقيل تقديره لقد سبق القول على أكثرهم أنهم لا يؤمنون فهم لا يؤمنون وذلك أنه سبحانه أخبر ملائكته أنهم لا يؤمنون فحق قوله عليهم .
{إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان} يعني أيديهم كنى عنها وإن لم يذكرها لأن الأعناق والأغلال تدلان عليها وذلك أن الغل إنما يجمع اليد إلى الذقن والعنق ولا يجمع الغل العنق إلى الذقن وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنهما قرءا إنا جعلنا في أيمانهم أغلالا وقرأ بعضهم في أيديهم والمعنى الجميع واحد لأن الغل لا يكون في العنق دون اليد ولا في اليد دون العنق ومثل هذا قول الشاعر :
وما أدري إذا يممت أرضا *** أريد الخير أيهما يليني
أ الخير الذي أنا أبتغيه *** أم الشر الذي لا يأتليني
ذكر الخير وحده ثم قال أيهما يليني لأنه قد علم أن الخير والشر معرضان للإنسان فلم يدر أ يلقاه هذا أم ذلك ومثله في التنزيل وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر ولم يقل البرد لأن ما يقي من الحر يقي من البرد .
واختلف في معنى الآية على وجوه ( أحدها ) أنه سبحانه إنما ذكره ضربا للمثل وتقديره مثل هؤلاء المشركين في إعراضهم عما تدعوهم إليه كمثل رجل غلت يداه إلى عنقه لا يمكنه أن يبسطهما إلى خير ورجل طامح برأسه لا يبصر موطىء قدميه عن الحسن والجبائي قال ونظيره قول الأفوه الأودي :
كيف الرشاد وقد صرنا إلى أمم *** لهم عن الرشد أغلال وأقياد
ونحوه كثير في كلام العرب ( وثانيها ) أن المعنى كان هذا القرآن أغلال في أعناقهم يمنعهم عن الخضوع لاستماعه وتدبره لثقله عليهم وذلك أنهم لما استكبروا عنه وأنفوا من اتباعه وكان المستكبر رافعا رأسه لاويا عنقه شامخا بأنفه لا ينظر إلى الأرض صاروا كأنما غلت أيديهم إلى أعناقهم وإنما أضاف ذلك إلى نفسه لأن عند تلاوته القرآن عليهم ودعوته إياهم صاروا بهذه الصفة فهو مثل قوله حتى أنسوكم ذكري عن أبي مسلم ( وثالثها ) أن المعنى بذلك ناس من قريش هموا بقتل النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) فجعلت أيديهم إلى أعناقهم فلم يستطيعوا أن يبسطوا إليه يدا عن ابن عباس والسدي ( رابعها) أن المراد به وصف حالهم يوم القيامة فهو مثل قوله إذ الأغلال في أعناقهم وإنما ذكره بلفظ الماضي للتحقيق .
وقوله {فهم مقمحون} أراد أن أيديهم لما غلت إلى أعناقهم ورفعت الأغلال أذقانهم ورءوسهم صعدا فهم مرفوعو الرأس برفع الأغلال إياها عن الأزهري ويدل على هذا المعنى قول قتادة مقمحون مغلولون {وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون} هذا على أحد الوجهين تشبيه لهم بمن هذه صفته في إعراضهم عن الإيمان وقبول الحق وذلك عبارة عن خذلان الله إياهم لما كفروا فكأنه قال وتركناهم مخذولين فصار ذلك من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وإذا قلنا إنه وصف حالهم في الآخرة فالكلام على حقيقته ويكون عبارة عن ضيق المكان في النار بحيث لا يجدون متقدما ولا متأخرا إذ سد عليهم جوانبهم وإذا حملناه على صفة القوم الذين هموا بقتل النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) فالمراد جعلنا بين أيدي أولئك الكفار منعا ومن خلفهم منعا حتى لم يبصروا النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) .
وقوله {فأغشيناهم فهم لا يبصرون} أي أغشينا أبصارهم فهم لا يبصرون النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) فقد روي أن أبا جهل هم بقتله (صلى الله عليه وآله وسلّم) فكان إذا خرج بالليل لا يراه ويحول الله بينه وبينه وقيل فأغشيناهم فأعميناهم فهم لا يبصرون الهدى وقيل فأغشيناهم العذاب فهم لا يبصرون النار وقيل معناه إنهم لما انصرفوا عن الإيمان والقرآن لزمهم ذلك حتى لم يكادوا يتخلصون منه بوجه كالمغلول والمسدود عليه طرقه {وسواء عليهم أ أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون} هذا مفسر في سورة البقرة .
ولما أخبر سبحانه عن أولئك الكفار أنهم لا يؤمنون وأنهم سواء عليهم الإنذار وترك الإنذار عقبه بذكر حال من ينتفع بالإنذار فقال {إنما تنذر من اتبع الذكر} والمعنى إنما ينتفع بإنذارك وتخويفك من اتبع القرآن لأن نفس الإنذار قد حصل للجميع {وخشي الرحمن بالغيب} أي في حال غيبته عن الناس بخلاف المنافق وقيل معناه وخشي الرحمن فيما غاب عنه من أمر الآخرة {فبشره} أي فبشر يا محمد من هذه صفته {بمغفرة} من الله لذنوبه {وأجر كريم} أي ثواب خالص من الشوائب .
ثم أخبر سبحانه عن نفسه فقال {إنا نحن نحيي الموتى} في القيامة للجزاء {ونكتب ما قدموا} من طاعتهم ومعاصيهم في دار الدنيا عن مجاهد وقتادة وقيل نكتب ما قدموه من عمل ليس أثر {وآثارهم} أي ما يكون له أثر عن الجبائي وقيل يعني ب آثارهم أعمالهم التي صارت سنة بعدهم يقتدى فيها بهم حسنة كانت أم قبيحة وقيل معناه ونكتب خطاهم إلى المسجد وسبب ذلك ما رواه أبوسعيد الخدري أن بني سلمة كانوا في ناحية المدينة فشكوا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) بعد منازلهم من المسجد والصلاة معه فنزلت الآية وفي الحديث عن أبي موسى قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) : ( (إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم)) رواه البخاري ومسلم في الصحيح .
{وكل شيء أحصيناه في إمام مبين} أي وأحصينا وعددنا كل شيء من الحوادث في كتاب ظاهر وهو اللوح المحفوظ والوجه في إحصاء ذلك فيه اعتبار الملائكة به إذ قابلوا به ما يحدث من الأمور ويكون فيه دلالة على معلومات الله سبحانه على التفصيل وقيل أراد به صحائف الأعمال وسمي ذلك مبينا لأنه لا يدرس أثره عن الحسن .
__________________
1- مجمع البيان ، الطبرسي ، ج8 ، ص259-263 .
تفسير الكاشف
- ذكر محمد جواد مغنية في تفسير هذه الآيات (1) :
{ يس} أكثر المفسرين على أن هذه الكلمة مثل (ألم) وتقدم الكلام عنها في أول سورة البقرة ، أما قوله تعالى : سَلامٌ عَلى آل ياسِينَ إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُؤْمِنِينَ فإن المراد بيس هنا الياس {والْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ} . أقسم سبحانه بالقرآن الحكيم ان محمدا (صلى الله عليه واله وسلم) على الدين القويم ، وقسم اللَّه بالقرآن مع وصفه بالحكمة يومئ إلى شرف القرآن وعظمته ، وانه من أقوى الأدلة على صدق محمد (صلى الله عليه واله وسلم) في دعوته ، أما وصفه سبحانه لنفسه بالعزة والرحمة في قوله : {تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ} فهو إشارة إلى أن اللَّه يأخذ العصاة المتمردين أخذ عزيز مقتدر ، ويرحم المؤمنين والمنيبين ، قال الإمام علي (عليه السلام) : لا يشغله غضب عن رحمة ، ولا تلهه رحمة عن عقاب .
الموسيقى الباطنية في القرآن :
في سنة 1959 ألَّف الأديب المصري المعروف مصطفى محمود كتاب (اللَّه والإنسان) ، وأنكر فيه وجود الخالق ، وألفت في الرد عليه كتاب (اللَّه والعقل) ، ثم تتبعته في مقالاته ومؤلفاته . . فقرأت له في مجلة (روز اليوسف) تاريخ 10 - 4 - 1967 مقالا أقر فيه بالبعث والحياة بعد الموت ، وأشرت إلى ذلك في بعض حواشي المجلد الأول من هذا التفسير ص 77 .
ومصطفى محمود أديب بطبعه ، غني بذكائه الفطري الذي يكشف الدقيق الغامض من أسرار اللغة ، وخير شاهد على هذه الحقيقة ما كتبه عن القرآن الكريم بمجلة (صباح الخير) تاريخ 1 - 1 - 1970 بعنوان (المعمار القرآني) نقتطف منه ما يلي :
(اني أحار في وصف الشعور الذي تلقيت به أول عبارة من القرآن . . فكانت كلماته تسعى إلى نفسي وكأنها مخلوق حي مستقل له حياته الخاصة . . وقد اكتشفت دون أن أدري حكاية الموسيقى الداخلية الباطنية في العبارة القرآنية ، وهذا سر من أعمق الأسرار في التركيب القرآني . . انه ليس بالشعر ولا بالنثر ولا بالكلام المسجوع ، وإنما هو بيان خاص من الألفاظ صيغت بطريقة تكشف عن الموسيقى الباطنية فيها . .
ان الموسيقى المألوفة تأتي من الخارج ، وتصل إلى الاذن من خارج العبارة ، وليس من داخلها ، بل من البحر والوزن والقافية ، أما موسيقى القرآن فتخلو من القافية والوزن والتشطير ومع ذلك فهي تقطر من كل حرف . . من أين ؟
وكيف ؟ هذا سر من أسرار القرآن لا يشاركه فيه أي تركيب أدبي . . انه محير لا ندري كيف يتم . . انه نسيج وحده بين كل ما كتب باللغة العربية سابقا ولاحقا . وتقليده محال " .
أجل ، ان تقليده محال . . وهنا يكمن سر الاعجاز . . وبعد أن قدم الكاتب العديد من الشواهد على هذه الحقيقة من كلمات اللَّه وآياته قال : {وليست الموسيقى الباطنية هي كل ما انفردت به العبارة القرآنية ، بل إن مع هذه الموسيقى صفة أخرى تشعرك بأنها من صنع الخالق لا من صنع المخلوق . .
اسمع القرآن يصف العلاقة الجنسية بين رجل وامرأة بكلمة رقيقة مهذبة لا تجد لها مثيلا ولا بديلا في أية لغة : {فَلَمَّا تَغَشَّاها حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفاً} [الأعراف - 189] .
هذه الكلمة تغشاها . . تغشاها . . يمتزج الذكر والأنثى كما يمتزج ظلان ، وكما تذوب الألوان بعضها في بعض . . هذا اللفظ العجيب يعبر به القرآن عن التداخل الكامل بين اثنين هو ذروة في التعبير . . لقد انفرد القرآن بخاصة عجيبة تحدث الخشوع في النفس ، وتؤثر في الوجدان والقلب بمجرد أن تلامس كلماته الأذن ، وقبل أن يبدأ العقل في العمل ، فإذا بدأ يحلل ويتأمل اكتشف أشياء جديدة تزيده خشوعا ، ولكنها مرحلة ثانية قد تحدث وقد لا تحدث ، قد تكشف الآية عن سرها وقد لا تكشف ، قد تؤتي البصيرة وقد لا تؤتي ، ولكن الخشوع ثابت ومستقر) .
وهذه أيضا إحدى ظواهر الإعجاز في القرآن . . وختم الكاتب صاحب كتاب (اللَّه والإنسان) مقاله الطويل بقوله : {ان القرآن لفظا ومعنى من اللَّه الذي أحاط بكل شيء علما} .
{لِتُنْذِرَ قَوْماً ما أُنْذِرَ آباؤُهُمْ فَهُمْ غافِلُونَ} . بعد أن ذكر سبحانه ان محمدا (صلى الله عليه واله وسلم) هو رسول اللَّه حقا ، وان القرآن تنزيل من العزيز الرحيم - بيّن مهمة القرآن وانه يهتف بالزواجر عن محارم اللَّه في إسماع العرب الغافلين عن اللَّه والحق دون ان ينذرهم منذر قبل رسول اللَّه (صلى الله عليه واله وسلم) . وعند تفسير قوله تعالى :
{وإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلا فِيها نَذِيرٌ} [فاطر - 24 ] قلنا : ان المراد بالنذير في هذه الآية كل ما تقوم به الحجة من العقل والنقل ، وان المراد بالنذير في الآية التي نحن بصددها هو النبي بالخصوص .
{لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ} . المراد بالقول هنا الوعيد بالعذاب ، وضمير أكثرهم يعود إلى الآباء في قوله تعالى : {ما أُنْذِرَ آباؤُهُمْ} أي آباء العرب الذين كانوا في عهد رسول اللَّه (صلى الله عليه واله وسلم) حيث مات أكثرهم على الشرك ، والقليل القليل منهم كانوا على دين التوحيد . أنظر تفسير الآية 107 من سورة الإسراء ، فقرة (الحنفاء) ج 5 ص 96 .
{إِنَّا جَعَلْنا فِي أَعْناقِهِمْ أَغْلالًا فَهِيَ إِلَى الأَذْقانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ} . الأغلال جمع غل وهو الطوق من الحديد ، والأذقان جمع ذقن وهو مجتمع اللَّحيين . .
وإذا شدت الأيدي بالأغلال إلى الأعناق ارتفع الرأس إلى فوق ، واستحال على المغلول ان يلتفت يمنة ويسرة أو ينظر إلى الأمام فهو أبدا ينظر إلى السماء ، وهذا هو المقمح {وجَعَلْنا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا ومِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْناهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ} . يجعلهم اللَّه يوم القيامة بين سدّين من نار : واحد من أمامهم وآخر من خلفهم لا يجدون متقدّما عنهما ولا متأخرا ولا يبصرون سماء ولا غيرها لأن السدين قد أعميا أبصارهم . . وغير بعيد أن يكون هذا كناية عن أليم العذاب وشدته ، ومهما يكن فإن هذا العذاب وما إليه لا يختص بالمشركين ، بل يعم كل مجرم وظالم ، قال الإمام علي (عليه السلام) : (أما أهل معصيته فأنزلهم شر دار ، وغل الأيدي إلى الأذقان ، وقرن النواصي بالأقدام ، وألبسهم سرابيل القطران ، ومقطعات النيران ، وباب قد أطبق على أهله في نار لها كلب ولجب) . وتقدم مثله في الآية 5 من سورة الرعد و33 من سورة سبأ .
{وسَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ} . سيان عندهم يا محمد وعظت أم لم تعظ فإنهم لا يتحركون إلا بوحي من أهوائهم ومصالحهم . وتقدم مثله في الآية 7 من سورة البقرة {إِنَّما تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وخَشِيَ الرَّحْمنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وأَجْرٍ كَرِيمٍ} . انما يستمع إليك ويقبل منك من طلب الحق لوجه الحق ، ويمضي عليه مهما تكن النتائج . وتقدم مثله في الآية 18 من سورة فاطر .
{إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتى ونَكْتُبُ ما قَدَّمُوا وآثارَهُمْ وكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْناهُ فِي إِمامٍ مُبِينٍ} . الإمام المبين كناية عن علمه تعالى ، والمعنى ان اللَّه يبعث الناس غدا من قبورهم ، وقد أحصى عليهم ما فعلوا من خير وشر ، وما تركوا من آثار نافعة أو ضارة ، وانه يجزي كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون .
_________________
1- الكاشف ، محمد جواد مغنية ، ج6 ، ص300-303 .
تفسير الميزان
- ذكر الطباطبائي في تفسير هذه الآيات (1) :
غرض السورة بيان الأصول الثلاثة للدين فهي تبتدىء بالنبوة وتصف حال الناس في قبول الدعوة وردها وأن غاية الدعوة الحقة إحياء قوم بركوبهم صراط السعادة وتحقيق القول على آخرين وبعبارة أخرى تكميل الناس في طريقي السعادة والشقاء .
ثم تنتقل السورة إلى التوحيد فتعد جملة من آيات الوحدانية ثم تنتقل إلى ذكر المعاد فتذكر بعث الناس للجزاء وامتياز المجرمين يومئذ من المتقين وتصف ما تئول إليه حال كل من الفريقين .
ثم ترجع إلى ما بدأت فتلخص القول في الأصول الثلاثة وتستدل عليها وعند ذلك تختتم السورة .
ومن غرر الآيات فيها قوله تعالى : {إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون} فالسورة عظيمة الشأن تجمع أصول الحقائق وأعراقها وقد ورد من طرق العامة والخاصة : أن لكل شيء قلبا وقلب القرآن يس .
والسورة مكية بشهادة سياق آياتها .
قوله تعالى : {يس والقرآن الحكيم - إلى قوله - فهم غافلون} إقسام منه تعالى بالقرآن الحكيم على كون النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من المرسلين ، وقد وصف القرآن بالحكيم لكونه مستقرا فيه الحكمة وهي حقائق المعارف وما يتفرع عليها من الشرائع والعبر والمواعظ .
وقوله : {إنك لمن المرسلين} مقسم عليه كما تقدم .
وقوله : {على صراط مستقيم} خبر بعد خبر لقوله : {إنك} ، وتنكير الصراط - كما قيل - للدلالة على التفخيم وتوصيفه بالمستقيم للتوضيح فإن الصراط هو الطريق الواضح المستقيم ، والمراد به الطريق الذي يوصل عابريه إلى الله تعالى أي إلى السعادة الإنسانية التي فيها كمال العبودية لله والقرب ، وقد تقدم في تفسير الفاتحة بعض ما ينفع في هذا المقام من الكلام .
وقوله : {تنزيل العزيز الرحيم} وصف للقرآن مقطوع عن الوصفية منصوب على المدح ، والمصدر بمعنى المفعول ومحصل المعنى أعني بالقرآن ذاك المنزل الذي أنزله الله العزيز الرحيم الذي استقر فيه العزة والرحمة .
والتذييل بالوصفين للإشارة إلى أنه قاهر غير مقهور وغالب غير مغلوب فلا يعجزه إعراض المعرضين عن عبوديته ولا يستذله جحود الجاحدين وتكذيب المكذبين ، وأنه ذو رحمة واسعة لمن يتبع الذكر ويخشاه بالغيب لا لينتفع بإيمانهم بل ليهديهم إلى ما فيه سعادتهم وكمالهم فهو بعزته ورحمته أرسل الرسول وأنزل عليه القرآن الحكيم لينذر الناس فيحق كلمة العذاب على بعضهم ويشمل الرحمة منهم آخرين .
وقوله : {لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون} تعليل للإرسال والتنزيل و{ما} نافية والجملة صفة لقوله : {قوما} والمعنى إنما أرسلك وأنزل عليك القرآن لتنذر وتخوف قوما لم ينذر آباؤهم فهم غافلون .
والمراد بالقوم إن كان هو قريش ومن يلحق بهم فالمراد بآبائهم آباؤهم الأدنون فإن الأبعدين من آبائهم كان فيهم النبي إسماعيل ذبيح الله ، وقد أرسل إلى العرب رسل آخرون كهود وصالح وشعيب (عليهما السلام) ، وإن كان المراد جميع الناس المعاصرين نظرا إلى عموم الرسالة فكذلك أيضا فآخر رسول معروف بالرسالة قبله (صلى الله عليه وآله وسلم) هو عيسى (عليه السلام) وبينهما زمان الفترة .
واعلم أن ما ذكرناه في تركيب الآيات هو الذي يسبق منها إلى الفهم وقد أوردوا في ذلك وجوها أخر بعيدة عن الفهم تركناها من أرادها فليراجع المطولات .
قوله تعالى : {لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون} اللام للقسم أي أقسم لقد ثبت ووجب القول على أكثرهم ، والمراد بثبوت القول عليهم صيرورتهم مصاديق يصدق عليهم القول .
والمراد بالقول الذي حق عليهم كلمة العذاب التي تكلم بها الله سبحانه في بدء الخلقة مخاطبا بها إبليس : {قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ (84) لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ} [ص : 84 ، 85] والمراد بتبعية إبليس طاعته فيما يأمر به بالوسوسة والتسويل بحيث تثبت الغواية وترسخ في النفس كما يشير إليه قوله تعالى خطابا لإبليس : {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ (42) وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ} [الحجر : 42 ، 43] .
ولازمه الطغيان والاستكبار على الحق كما يشير إليه ما يحكيه الله من تساؤل المتبوعين والتابعين في النار : {بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ (30) فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ (31) فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ } [الصافات : 30 - 32] ، وقوله : {وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ (71) قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ} [الزمر : 71 ، 72] .
ولازمه الانكباب على الدنيا والإعراض عن الآخرة بالمرة ورسوخ ذلك في نفوسهم قال تعالى : {وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (106) ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (107) أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ } [النحل : 106 - 108] .
وبما تقدم ظهر أن الفاء في قوله : {فهم لا يؤمنون} للتفريع لا للتعليل كما احتمله بعضهم .
قوله تعالى : {إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون} الأعناق جمع عنق بضمتين وهو الجيد ، والأغلال جمع غل بالكسر وهي على ما قيل ما تشد به اليد إلى العنق للتعذيب والتشديد ، ومقمحون اسم مفعول من الإقماح وهو رفع الرأس كأنهم قد ملأت الأغلال ما بين صدورهم إلى أذقانهم فبقيت رءوسهم مرفوعة إلى السماء لا يتأتى لهم أن ينكسوها فينظروا إلى ما بين أيديهم من الطريق فيعرفوها ويميزوها من غيرها .
وتنكير قوله : {أغلالا} للتفخيم والتهويل .
والآية في مقام التعليل لقوله السابق : {فهم لا يؤمنون} .
قوله تعالى : {وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون} السد الحاجز بين الشيئين ، وقوله : {من بين أيديهم ومن خلفهم} كناية عن جميع الجهات ، والغشي والغشيان التغطية يقال : غشيه كذا أي غطاه وأغشى الأمر فلانا أي جعل الأمر يغطيه ، والآية متممة للتعليل السابق وقوله : {جعلنا} معطوف على {جعلنا} المتقدم .
وعن الرازي في تفسيره في معنى التشبيه في الآيتين أن المانع عن النظر في الآيات قسمان : قسم يمنع عن النظر في الأنفس فشبه ذلك بالغل الذي يجعل صاحبه مقمحا لا يرى نفسه ولا يقع بصره على بدنه ، وقسم يمنع عن النظر في الآفاق فشبه ذلك بالسد المحيط فإن المحاط بالسد لا يقع نظره على الآفاق فلا يظهر له ما فيها من الآيات فمن ابتلي بهما حرم عن النظر بالكلية .
ومعنى الآيتين أنهم لا يؤمنون لأنا جعلنا في أعناقهم أغلالا نشد بها أيديهم على أعناقهم فهي إلى الأذقان فهم مرفوعة رءوسهم باقون على تلك الحال وجعلنا من جميع جهاتهم سدا فجعلناه يغطيهم فهم لا يبصرون فلا يهتدون .
ففي الآيتين تمثيل لحالهم في حرمانهم من الاهتداء إلى الإيمان وتحريمه تعالى عليهم ذلك جزاء لكفرهم وغوايتهم وطغيانهم في ذلك .
وقد تقدم في قوله تعالى : { إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا} [البقرة : 26] في الجزء الأول من الكتاب أن ما وقع في القرآن من هذه الأوصاف ونظائرها التي وصف بها المؤمنون والكفار يكشف عن حياة أخرى للإنسان في باطن هذه الحياة الدنيوية مستورة عن الحس المادي ستظهر له إذا انكشفت الحقائق بالموت أو البعث ، وعليه فالكلام في أمثال هذه الآيات جار في مجرى الحقيقة دون المجاز كما عليه القوم .
قوله تعالى : {وسواء عليهم ء أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون} عطف تفسير وتقرير لما تتضمنه الآيات الثلاث المتقدمة وتلخيص للمراد وتمهيد لما يتلوه من قوله : {إنما تنذر من اتبع الذكر} الآية .
واحتمل أن يكون عطفا على قوله : {لا يبصرون} والمعنى فهم لا يبصرون ويستوي عليهم إنذارك وعدم إنذارك لا يؤمنون والوجه الأول أقرب إلى الفهم .
قوله تعالى : {إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم} القصر للإفراد ، والمراد بالإنذار الإنذار النافع الذي له أثر ، وبالذكر القرآن الكريم ، وباتباعه تصديقه والميل إليه إذا تليت آياته ، والتعبير بالماضي للإشارة إلى تحقق الوقوع ، والمراد بخشية الرحمن بالغيب خشيته تعالى من وراء الحجاب وقبل انكشاف الحقيقة بالموت أو البعث ، وقيل : أي حال غيبته من الناس بخلاف المنافق وهو بعيد .
وقد علقت الخشية على اسم الرحمن الدال على صفة الرحمة الجالبة للرجاء للإشعار بأن خشيتهم خوف مشوب برجاء وهو الذي يقر العبد في مقام العبودية فلا يأمن ولا يقنط .
وتنكير {مغفرة} و{أجر كريم} للتفخيم أي فبشره بمغفرة عظيمة من الله وأجر كريم لا يقدر قدره وهو الجنة ، والدليل على جميع ما تقدم هو السياق .
والمعنى : إنما تنذر الإنذار النافع الذي له أثر ، من اتبع القرآن إذا تليت عليه آياته ومال إليه وخشي الرحمن خشية مشوبة بالرجاء فبشره بمغفرة عظيمة وأجر كريم لا يقدر قدره .
قوله تعالى : {إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين} المراد بإحياء الموتى إحياؤهم للجزاء .
والمراد بما قدموا الأعمال التي عملوها قبل الوفاة فقدموها على موتهم ، والمراد بآثارهم ما تركوها لما بعد موتهم من خير يعمل به كتعليم علم ينتفع به أو بناء مسجد يصلى فيه أو ميضاة يتوضأ فيها ، أوشر يعمل به كوضع سنة مبتدعة يستن بها أو بناء مفسقة يعصى الله فيها .
وربما قيل : إن المراد بما قدموا النيات وبآثارهم الأعمال المترتبة المتفرعة عليها وهو بعيد من السياق .
والمراد بكتابة ما قدموا وآثارهم ثبتها في صحائف أعمالهم وضبطها فيها بواسطة كتبة الأعمال من الملائكة وهذه الكتابة غير كتابة الأعمال وإحصائها في الإمام المبين الذي هو اللوح المحفوظ وإن توهم بعضهم أن المراد بكتابة ما قدموا وآثارهم هو إحصاؤها في الكتاب المبين وذلك أنه تعالى يثبت في كلامه كتابا يحصي كل شيء ثم لكل أمة كتابا يحصي أعمالهم ثم لكل إنسان كتابا يحصي أعماله كما قال : { وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ } [الأنعام : 59] ، وقال : {كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا } [الجاثية : 28] ، وقال : {وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا } [الإسراء : 13] ، وظاهر الآية أيضا يقضي بنوع من البينونة بين كتاب الأعمال والإمام المبين حيث فرق بينهما بالخصوص والعموم واختلاف التعبير بالكتابة والإحصاء .
وقوله : {وكل شيء أحصيناه في إمام مبين} هو اللوح المحفوظ من التغيير الذي يشتمل على تفصيل قضائه سبحانه في خلقه فيحصي كل شيء وقد ذكر في كلامه تعالى بأسماء مختلفة كاللوح المحفوظ وأم الكتاب والكتاب المبين والإمام المبين كل منها بعناية خاصة .
ولعل العناية في تسميته إماما مبينا أنه لاشتماله على القضاء المحتوم متبوع للخلق مقتدى لهم وكتب الأعمال كما سيأتي في تفسير سورة الجاثية مستنسخة منه قال تعالى : {هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ } [الجاثية : 29] .
وقيل : المراد بالإمام المبين صحف الأعمال وليس بشيء ، وقيل : علمه تعالى وهو كسابقه نعم لو أريد به العلم الفعلي كان له وجه .
ومن عجيب القول في هذا المقام ما ذكره بعضهم أن الذي كتب في اللوح المحفوظ هوما كان وما يكون إلى يوم القيامة لا حوادث العالم إلى أبد الآبدين وذلك أن اللوح عند المسلمين جسم وكل جسم متناهي الأبعاد كما يشهد به الأدلة وبيان كل شيء فيه على الوجه المعروف عندنا دفعة مقتض لكون المتناهي ظرفا لغير المتناهي وهو محال بالبديهة فالوجه تخصيص عموم كل شيء والقول بأن المراد به الحوادث إلى يوم القيامة هذا .
وهو تحكم وسنتعرض له تفصيلا .
والآية في معنى التعليل بالنسبة إلى ما تقدمها كأنه تعالى يقول : ما أخبرنا به ووصفناه من حال أولئك الذين حق عليهم القول وهؤلاء الذين يتبعون الذكر ويخشون ربهم بالغيب هو كذلك لأن أمر حياة الكل إلينا وأعمالهم وآثارهم محفوظة عندنا فنحن على علم وخبرة بما تئول إليه حال كل من الفريقين .
_______________
1- الميزان ، الطباطبائي ، ج17 ، ص52-57 .
تفسير الامثل
- ذكر الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في تفسير هذه الآيات (1) :
هذه السورة تبدأ ـ كما هو الحال في ثمان وعشرين سورة اُخرى ـ بحروف مقطّعة وهي (ياء) و (سين) .
وقد فصّلنا الحديث فيما يخصّ الحروف المقطّعة في بداية سورة (البقرة) و (آل عمران) و (الأعراف) ، ولكن فيما يخصّ سورة (يس) فتوجد تفسيرات اُخرى أيضاً لهذه الحروف المقطّعة .
من جملتها أنّ هذه الكلمة (يس) تتكوّن من «ياء» حرف نداء و«سين» أي شخص الرّسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وعليه فيكون المعنى أنّه خطاب للرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)لتوضيح قضايا لاحقة .
وقد ورد في بعض الأحاديث أنّ هذه الكلمة تمثّل أحد أسماء الرّسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) (2) .
ومنها أنّ المخاطب هنا هو الإنسان و«سين» إشارة له ، ولكن هذا الإحتمال لا يحقّق الإنسجام بين هذه الآية والآيات اللاحقة ، لأنّ هذه الآيات تتحدّث إلى الرّسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وحده .
لذا نقرأ في رواية عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنّه قال : «يس اسم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)والدليل على ذلك قوله تعالى : {إنّك لمن المرسلين على صراط مستقيم} . (3)
بعد هذه الحروف المقطّعة ـ وكما هو الحال في أغلب السور التي تبتدى بالحروف المقطّعة ـ يأتي الحديث عن القرآن المجيد ، فيورد هنا قَسَماً بالقرآن ، إذ يقول : (والقرآن الحكيم) . الملفت للنظر أنّه وصف «القرآن» هنا بـ «الحكيم» ، في حين أنّ الحكمة عادةً صفة للعاقل ، كأنّه سبحانه يريد طرح القرآن على أنّه موجود حي وعاقل ومرشد ، يستطيع فتح أبواب الحكمة أمام البشر ، ويؤدّي إلى الصراط المستقيم الذي تشير إليه الآيات التالية .
بديهي أنّ الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة لأنّ يقسم ، ولكن الأقسام القرآنية تتضمّن ـ دائماً ـ فائدتين أساسيتين : الاُولى التأكيد على الموضوع اللاحق للقسم ، والثانية بيان عظمة الشيء الذي يقسم به الله تعالى ، إذ أنّ القسم لا يكون عادةً بأشياء ليست ذات قيمة .
الآية التي بعدها توضّح الأمر الذي من أجله أقسم الله تعالى في مقدّمة السورة الكريمة : {إنّك لمن المرسلين على صراط مستقيم} (4) .
بعد ذلك تضيف الآية {تنزيل العزيز الرحيم} (5) .
التأكيد على «العزيز» كصفة لله سبحانه وتعالى ، لأجل بيان قدرته سبحانه وتعالى في قبال كتاب كبير كهذا ، كتاب يقف معجزة شامخة على مرّ العصور والقرون ، ولن تستطيع أيّة قدرة مهما كانت أن تمحو أثره العظيم من صفحة القلوب .
والتأكيد على «رحيميته» لأجل بيان هذه الحقيقة وهي أنّ رحمته أوجبت أن تقيّض للبشر نعمة عظيمة كهذه .
بعض المفسّرين قالوا بأنّ هاتين الصفتين ذكرتا للإشارة إلى نوعين من ردود الفعل المحتملة من قبل الناس إزاء نزول ذلك الكتاب السماوي وإرسال النّبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فلو أنكروا وكذّبوا ، فإنّ الله سبحانه وتعالى يهدّدهم بعزّته ، ولو دخلوا من باب التسليم والقبول ، فإنّ الله يبشّرهم برحمته الخاصّة .
وعليه فإنّ عزّته ورحمته إحداهما مظهر للإنذار والاُخرى للبشارة ، وبإقترانهما جعل هذا الكتاب السماوي العظيم في متناول البشرية .
هنا يطرح سؤال : هل يمكن إثبات حقّانية الرّسول أو الكتاب السماوي ، بواسطة قَسَم أو تأكيد ؟
الجواب تستبطنه الآيات المذكورة ، لأنّها من جانب تصف القرآن بالحكيم ، مشيرة إلى أنّ حكمته ليست مخفية عن أحد ، وذلك دليل على حقّانيته .
ومن جانب آخر فإنّ وصف الرّسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) بأنّه (على صراط مستقيم) ، بمعنى أنّ محتوى دعوته يتّضح من سبيله القويم ، وماضيه أيضاً دليل على أنّه لم يسلك في حياته سوى الطريق المستقيم .
وقد أشرنا في البحوث التي أوردناها حول أدلّة حقّانية الرسل ، إلى أنّ أحد أهمّ الطرق لإدراك حقّانية الرسل ، هو التحقّق والإطلاع على محتوى دعواتهم بشكل دقيق ، الأمر الذي يؤكّد دائماً أنّها متوافقة ومنسجمة مع الفطرة والعقل والوجدان ، وقابلة للإدراك والتعقّل البشري ، إضافةً إلى أنّ تأريخ حياة الرّسول (صلى الله عليه وآله وسلم) يدلّل على أنّه رجل أمانة وصدق ، وليس رجل كذب وتزوير . . هذه الاُمور قرائن حيّة على كونه رسول الله ، والآيات أعلاه في الحقيقة تشير إلى كلا المطلبين ، وعليه فإنّ القسم والدعوى أعلاه لم يكونا بلا سبب أبداً .
ناهيك عن أنّه من حيث أدب المناظرة ، فإنّه لأجل النفوذ في قلوب المنكرين والمعاندين يجب أن تكون العبارات في طرحها أكثر إحكاماً وحسماً ومصحوبة بتأكيد أقوى ، كيما تستطيع التأثير في هؤلاء .
يبقى سؤال : وهو لماذا كان المخاطب في هذه الجملة شخص الرّسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) وليس المشركين أو عموم الناس ؟
الجواب هو التأكيد على أنّك يا أيّها النّبي على الحقّ وعلى الصراط المستقيم ، سواء إستجاب هؤلاء أولم يستجيبوا ، لذا فإنّ عليك الإجتهاد في تبليغ رسالتك العظيمة ، ولا تُعِر المخالفين أدنى إهتمام .
الآية التالية تشرح الهدف الأصلي لنزول القرآن كما يلي {ولتنذر قوماً ما اُنذر آباؤهم فهم غافلون} (6) أي إنّه لم يأت نذير لآبائهم .
من المسلّم أنّ المقصود بهؤلاء القوم هم المشركون في مكّة ، وإذا قيل أنّه لم تخلُ اُمّة من منذر ، وأنّ الأرض لا تخلو من حجّة لله ، علاوةً على أنّه تعالى يقول في الآية (24) من سورة فاطر {وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ } [فاطر : 24] ؟
فنقول : إنّ المقصود من الآية ـ مورد البحث ـ هو المنذر الظاهر والنّبي العظيم الذي ملأ صيته الآفاق ، وإلاّ فإنّ الأرض لم تخلُ يوماً من حجّة لله على عباده ، وإذا نظرنا إلى الفترة من عصر المسيح (عليه السلام) إلى قيام الرّسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) نجدها لم تخل من الحجّة الإلهية ، بل إنّها فترة من قيام اُولي العزم ، يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بهذا الخصوص «إنّ الله بعث محمّداً (صلى الله عليه وآله وسلم) وليس أحد من العرب يقرأ كتاباً ولا يدّعي نبوّة !» . (7)
وعلى كلّ حال فإنّ الهدف من نزول القرآن الكريم كان تنبيه الناس الغافلين ، وإيقاظ النائمين ، وتذكيرهم بالمخاطر المحيطة بهم ، والذنوب والمعاصي التي ارتكبوها ، والشرك وأنواع المفاسد التي تلوّثوا بها ، نعم فالقرآن أساس العلم واليقظة ، وكتاب تطهير القلب والروح .
ثمّ يتنبّأ القرآن الكريم بما يؤول إليه مصير الكفّار والمشركين فيقول تعالى : {لقد حقّ القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون} .
إحتمل المفسّرون هنا العديد من الإحتمالات في المراد من «القول» هنا .
الظاهر أنّه ذلك الوعيد الإلهي لكل أتباع الشيطان بالعذاب في جهنّم ، فمثله ما ورد في الآية (13) من سورة السجدة {وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ} [السجدة : 13]
. كذلك في الآية (71) من سورة الزمر نقرأ { وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ} [الزمر : 71] .
على كلّ حال فإنّ ذلك يخصّ اُولئك الذين قطعوا كلّ إرتباط لهم بالله سبحانه وتعالى ، وأغلقوا عليهم منافذ الهداية بأجمعها ، وأوصلوا عنادهم وتكبّرهم وحماقتهم إلى الحدّ الأعلى ، نعم فهم لن يؤمنوا أبداً ، وليس لديهم أي طريق للعودة ، لأنّهم قد دمّروا كلّ الجسور خلفهم .
في الحقيقة فإنّ الإنسان القابل للإصلاح والهداية هو ذلك الذي لم يلوّث فطرته التوحيدية تماماً بأعماله القبيحة وأخلاقه المنحرفة ، وإلاّ فإنّ الظلمة المطلقة ستتغلّب على قلبه وتغلق عليه كلّ منافذ الأمل .
فاتّضح أنّ المقصود هم تلك الأكثرية من الرؤوس المشركة الكافرة التي لم تؤمن أبداً ، وكذلك كان ، فقد قتلوا في حروبهم ضدّ الإسلام وهم على حال الشرك وعبادة الأوثان ، وما تبقى منهم ظلّ على ضلاله إلى آخر الأمر .
وإلاّ فإنّ أكثر مشركي العرب أسلموا بعد فتح مكّة بمفاد قوله تعالى : {يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا} [النصر : 2] .
ويشهد بذلك ما ورد في الآيات التالية التي تتحدّث عن وجود سدٍّ أمام وخلف هؤلاء وكونهم لا يبصرون . وأنّه لا ينفع معهم الإنذار أو عدمه (8) .
الآية التي بعدها تواصل وصف تلك الفئة المعاندة ، فتقول : (إنّا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون) أي مرفوعي الرأس لوجود الغلّ حول الأعناق .
«أغلال» جمع «غل» : من مادّة «غلل» ويعني تدرع الشيء وتوسطه ، ومنه الغلل (على وزن عمل) للماء الجاري بين الشجر . و«الغل» الحلقة حول العنق أو اليدين وتربط بعد ذلك بسلسلة ، وبما أنّ العنق أو اليدين تقع في ما بينها فقد إستعملت هذه المفردة في هذا المورد ، وحيناً تكون الأغلال في العنق مربوطة بسلسلة مستقلّة عمّا تربط به أغلال الأيدي ، وحيناً تكون جميعها مربوطة بسلسلة واحدة فيكون الشخص بذلك تحت ضغط شديد وفي محدودية وعذاب شديدين .
وإذا قيل لحالة العطش الشديد أو الحسرة والغضب «غُلة» فإنّ ذلك لنفوذ تلك الحالة في داخل قلب وجسم الإنسان ، وأساساً فإنّ مادّة «غَل» ـ على وزن جدّ ـ بمعنى الدخول أو الإدخال ، لذا قيل عن حاصل الكسب أو الزراعة وأمثالها «غَلة» (9) .
وقد تكون حلقة «الغل» حول الرقبة عريضة أحياناً بحيث تضغط على الذقن وترفع الرأس إلى الأعلى ، من هنا فإنّ المقيّد يتحمّل عذاباً فوق العذاب الذي يتحمّله من ذلك القيد بأنّه لا يستطيع مشاهدة أطرافه .
ويا له من تمثيل رائع حيث شبّه القرآن الكريم حال عبدة الأوثان المشركين بحال هذا الإنسان ، فقد طوّقوا أنفسهم بطوق «التقليد الأعمى» ، وربطوا ذلك بسلسلة «العادات والتقاليد الخرافية» فكانت تلك الأغلال من العرض والإتّساع أنّها أبقت رؤوسهم تنظر إلى الأعلى وحرمتهم بذلك من رؤية الحقائق ، وبذلك فإنّهم أسرى لا يملكون القدرة والفعّالية والحركة ، ولا قدرة الإبصار (10) .
على أيّة حال فإنّ الآية أعلاه ، تعتبر شرحاً لحال تلك الفئة الكافرة في الدنيا وحالهم في عالم الآخرة الذي هو تجسيد لمسائل هذا العالم ، وليس من الغريب إستخدام صيغة الماضي في تصوير حال الآخرة هنا ، فإنّ الكثير من الآيات القرآنية الكريمة تتكلّم بصيغة الماضي حينما تتعرّض إلى الحوادث المسلّم بها في المستقبل للدلالة على مضارع متحقّق الوقوع ، وبذلك يمكن أن تكون إشارة إلى كلا المعنيين حالهم في الدنيا وحالهم في الآخرة .
جمع من المفسّرين ذكروا في أسباب نزول هذه الآية والآية التالية لها أنّهما نزلتا في (أبي جهل) أو (رجل من مخزوم) أو قريش ، الذين صمّموا مراراً على قتل الرّسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ولكن الله سبحانه وتعالى منعهم من ذلك بطريقة إعجازية فكلّما أرادوا إنزال ضربة بالنّبي عميت عيونهم عن الإبصار أو أنّهم سلبوا القدرة على التحرّك تماماً (11) .
ولكن سبب النّزول ذلك لا يمنع من عمومية مفهوم الآية وسعة معناها ، بحيث يشمل جميع أئمّة الكفر والمعاندين ، وفي الضمن فهي تعتبر تأييداً لما قلناه في تفسير {فهم لا يؤمنون} في أنّ المقصود بهم هم أئمّة الكفر والنفاق وليس أكثرية المشركين .
الآية التالية تتناول وصفاً آخر لحالة تلك المجموعة ، وتمثيلا ناطقاً عن عوامل وأسباب عدم تقبّلهم الحقائق فتقول : {وجعلنا من بين أيديهم سدّاً ومن خلفهم سدّاً} وحوصروا بين هذين السدّين وأمسوا لا يملكون طريقاً لا إلى الأمام ولا إلى الوراء ، آنئذ {فأغشيناهم فهم لا يبصرون} .
ويا له من تشبيه رائع ! ! فهم من جهة كالأسرى في الأغلال والسلاسل ، ومن جهة اُخرى فإنّ حلقة الغلّ عريضة بحيث أنّها ترفع رؤوسهم إلى السماء ، وتمنعهم من أن يبصروا شيئاً ممّا حولهم ، ومن جهة ثالثة فهم محاصرون بين سدود من أمامهم وخلفهم وممنوعون من سلوك طريقهم إلى الأمام أو إلى الخلف . ومن جهة رابعة {فهم لا يبصرون} إذ فقدت عيونهم كلّ قدرة على الإبصار .
تأمّلوا مليّاً ماذا ينتظر ممّن هو على تلك الحال ؟ ما هو مقدار إدراكه للحقائق ؟
ماذا يمكنه أن يبصر ؟ وكيف يمكنه أن ينقل خطاه ؟ فكذلك حال المستكبرين المعاندين العمي الصمّ في قبال الحقائق ! !
لهذا فإنّه تعالى يقول في آخر آية من هذه المجموعة {وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون} . فمهما كان حديثك نافذاً في القلوب ومهما كان أثر الوحي السماوي ، فإنّه لن يؤثّر ما لم يجد الأرضية المناسبة ، فلو سطعت الشمس آلاف السنين على أرض سبخة ، ونزلت عليها مياه الأمطار المباركة ، وهبّت عليها نسائم الربيع على الدوام ، فليس لها أن تنبت سوى الشوك والتبن ، لأنّ قابلية القابل شرط مع فاعلية الفاعل .
وقوله تعالى : {إنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِىَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَة وَأَجْر كَرِيم (11) إِنَّا نَحْنُ نُحْىِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَءَاثَرَهُمْ وَكُلَّ شَيْء أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَام مُّبِين}
من هم الذين يتقبّلون إنذارك ؟
كان الحديث في الآيات السابقة عن مجموعة لا تملك أي إستعداد لتقبّل الإنذارات الإلهيّة ويتساوى عندهم الإنذار وعدمه ، أمّا هذه الآيات فتتحدّث عن فئة اُخرى هي على النقيض من تلك الفئة ، وذلك لكي يتّضح المطلب بالمقارنة بين الفئتين كما هو اُسلوب القرآن .
تقول الآية الاُولى من هذه المجموعة {إنّما تنذر من اتّبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشّره بمغفرة وأجر كريم} .
هنا ينبغي الإلتفات إلى اُمور :
1 ـ ذكرت في هذه الآية صفتان لمن تؤثّر فيهم مواعظ وإنذارات النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : وهي «أتباع الذكر» و «الخشية من الله في الغيب» . لا شكّ أنّ المقصود من هاتين الصفتين هو ذلك الإستعداد الذاتي وما هو موجود فيهم «بالقوّة» . أي أنّ الإنذار يؤثّر فقط في اُولئك الذين لهم أسماع واعية وقلوب مهيّأة ، فالإنذار يترك فيهم أثرين : الأوّل إتّباع الذكر والقرآن الكريم ، والآخر الإحساس بالخوف بين يدي الله والمسؤولية .
وبتعبير آخر فإنّ هاتين الحالتين موجودتان فيهم بالقوّة ، وإنّها تظهر فيهم بالفعل بعد الإنذار ، وذلك على خلاف الكفّار عمي القلوب الغافلين الذين لا يملكون اُذناً صاغية وليسوا أهلا للخشية من الله أبداً .
هذه الآية كالآية من سورة البقرة حيث يقول تعالى : {ذلك الكتاب لا ريب فيه هدىً للمتّقين} .
2 ـ بإعتقاد الكثير من المفسّرين أنّ المقصود من «الذكر» هو «القرآن المجيد» . لأنّ هذه الكلمة جاءت بهذه الصورة مراراً في القرآن الكريم لتعبّر عن هذا المعنى (12) ، ولكن لا مانع من أن يكون المقصود من هذه الكلمة أيضاً المعنى اللغوي لها بمعنى مطلق التذكير ، بحيث يشمل كلّ الآيات القرآنية وسائر الإنذارات الصادرة عن الأنبياء والقادة الإلهيين .
3 ـ «الخشية» كما قلنا سابقاً ، بمعنى الخوف الممزوج بالإحساس بعظمة الله تعالى ، والتعبير بـ «الرحمن» هنا والذي يشير إلى مظهر رحمة الله العامّة يثير معنى جميلا ، وهو أنّه في عين الوقت الذي يُستشعر فيه الخوف من عظمة الله ، يجب أن يكون هنالك أمل برحمته ، لموازنة كفّتي الخوف والرجاء ، اللذين هما عاملا الحركة التكاملية المستمرة .
الملفت للنظر أنّه ذكرت كلمة «الله» في بعض من الآيات القرآنية في مورد «الرجاء» والتي تمثّل مظهر الهيبة والعظمة {لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ} [الأحزاب : 21] إشارة إلى أنّه يجب أن يكون الرجاء ممزوجاً بالخوف ، والخوف ممزوجاً بالرجاء على حد سواء (تأمّل !!) .
4 ـ التعبير بـ «الغيب» هنا إشارة إلى معرفة الله عن طريق الإستدلال والبرهان ، إذ أنّ ذات الله سبحانه وتعالى غيب بالنسبة إلى حواس الإنسان ، ويمكن فقط مشاهدة جماله وجلاله سبحانه ببصيرة القلب ومن خلال آثاره تعالى .
كذلك يحتمل أيضاً أنّ «الغيب» هنا بمعنى «الغياب عن عيون الناس» بمعنى أنّ مقام الخشية والخوف يجب أن لا يتّخذ طابعاً ريائياً ، بل إنّ الخشية والخوف يجب أن تكون في السرّ والخفية .
بعضهم فسّر «الغيب» أيضاً بـ «القيامة» لأنّها من المصاديق الواضحة للاُمور المغيبة عن حسّنا ، ولكن يبدو أنّ التّفسير الأوّل هو الأنسب .
5 ـ جملة «فبشّره» في الحقيقة تكميل للإنذار ، إذ أنّ الرّسول (صلى الله عليه وآله وسلم) في البدء ينذر ، وحين يتحقّق للإنسان اتّباع الذكر والخشية وتظهر آثارها على قوله وفعله ، هنا يبشّره الباري عزّوجلّ .
بماذا يبشّر ؟ أوّلا يبشّره بشيء قد شغل فكره أكثر من أي موضوع آخر ، وهو تلك الزلاّت التي إرتكبها ، يبشّره بأنّ الله العظيم سيغفر له تلك الزلاّت جميعها ، ويبشّره بعدئذ بأجر كريم وثواب جزيل لا يعلم مقداره ونوعه إلاّ الله سبحانه .
الملفت للنظر هو تنكير «المغفرة» و «الأجر الكريم» ونعلم بأنّ إستخدام النكرة في مثل هذه المواضع إنّما هو للتدليل على الوفرة والعِظم .
6 ـ يرى بعض المفسّرين أنّ (الفاء) في جملة «فبشّره» للتفريع والتفصيل ، إشارة إلى أنّ (اتّباع التذكر والخشية) نتيجتها «المغفرة» و «الأجر الكريم» بحيث أنّ الاُولى وهي المغفرة تترتّب على الأوّل ، والثانية على الثاني .
بعد ذلك وبما يتناسب مع البحث الذي كان في الآية السابقة حول الأجر والثواب العظيم للمؤمنين والمصدّقين بالإنذارات الإلهية التي جاء بها الأنبياء ، تنتقل الآية التالية إلى الإشارة إلى مسألة المعاد والبعث والكتاب والحساب والمجازاة ، تقول الآية الكريمة : {إنّا نحن نحيي الموتى} .
الإستناد إلى لفظة «نحن» إشارة إلى القدرة العظيمة التي تعرفونها فينا ! وكذلك قطع الطريق أمام البحث والتساؤل في كيف يحيي العظام وهي رميم ، ويبعث الروح في الأبدان من جديد ؟ وليس نحيي الموتى فقط ، بل (ونكتب ما قدّموا وآثارهم) وعليه فإنّ صحيفة الأعمال لن تغادر صغيرة ولا كبيرة إلاّ وتحفظها إلى يوم الحساب .
جملة «ما قدّموا» إشارة إلى الأعمال التي قاموا بها ولم يبق لها أثر ، أمّا التعبير «وآثارهم» فإشارة إلى الأعمال التي تبقى بعد الإنسان وتنعكس آثارها على المحيط الخارجي ، من أمثال الصدقات الجارية (المباني والأوقاف والمراكز التي تبقى بعد الإنسان وينتفع منها الناس) .
كذلك يحتمل أيضاً أن يكون المعنى هو أنّ «ما قدّموا» إشارة إلى الأعمال ذات الجنبة الشخصية ، و «آثارهم» إشارة إلى الأعمال التي تصبح سنناً وتوجب الخير والبركات بعد موت الإنسان ، أو تؤدّي إلى الشرّ والمعاصي والذنوب . ومفهوم الآية واسع يمكن أن يشمل التّفسيرين .
ثمّ تضيف الآية لزيادة التأكيد {وكلّ شيء أحصيناه في إمام مبين} .
أغلب المفسّرين اعتبروا أنّ معنى «إمام مبين» هنا هو «اللوح المحفوظ» ذلك الكتاب الذي أثبتت فيه وحفظت كلّ الأعمال والموجودات والحوادث التي في هذا العالم .
والتعبير بـ «إمام» ربّما كان بلحاظ أنّ هذا الكتاب يكون في يوم القيامة قائداً وإماماً لجميع المأمورين بتحقيق الثواب والعقاب ، أو لكونه معياراً لتقييم الأعمال الإنسانية ومقدار ثوابها وعقوبتها .
الجدير بالملاحظة أنّ تعبير (إمام) ورد في بعض آيات القرآن الكريم للتعبير عن «التوراة» حيث يقول سبحانه وتعالى : (أفمن كان على بيّنة من ربّه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة) .
وإطلاق كلمة «إمام» في هذه الآية على «التوراة» يشير إلى المعارف والأحكام والأوامر الواردة في التوراة ، وكذلك للدلائل والإشارات المذكورة بحقّ نبي الإسلام (صلى الله عليه وآله وسلم) ، ففي كلّ هذه الاُمور يمكن للتوراة أن تكون قائداً وإماماً للخلق ، وبناءً على ذلك فإنّ الكلمة المزبورة لها معنى متناسب مع مفهومها الأصلي في كلّ مورد إستعمال .
________________
1- الامثل ، ناصر مكارم الشيرازي ، ج11 ، ص104-116 .
2 ـ نور الثقلين ، مجلّد 4 ، صفحة 374 و375 .
3 ـ نور الثقلين ، ج4 ، ص375 .
4 ـ اختلف المفسّرون في تركيب جملة (على صراط مستقيم) بعضهم قال «إنّها جار ومجرور» متعلّقان بـ «المرسلين» ، بحيث يكون المعنى «رسالتك على صراط مستقيم» وبعضهم قال : «إنّها خبر بعد خبر» والمعنى «إنّك مستقر على صراط مستقيم» ، والبعض الآخر اعتبروها (حال) منصوبة والمعنى «إنّك من المرسلين وحالك على صراط مستقيم» (من الطبيعي أن ليس هناك تفاوت كثير في المعنى) .
5 ـ «تنزيل» مفعول منصوب لفعل مقدّر والتقدير «نزل تنزيل العزيز الرحيم» ، كذلك فقد وردت إحتمالات اُخرى لإعراب هذه الجملة .
6 ـ أعطى المفسّرون إحتمالات مختلفة حول كون «ما» نافية أوغير ذلك ، أغلبهم قالوا بأنّها «نافية» ، وقد إعتمدنا ذلك نحن في تفسيرنا ، أوّلا : لأنّ جملة «فهم غافلون» دليل على ذلك المعنى ، فعدم وجود المنذر سبب للغفلة .
الآية الثالثة من سورة السجدة ـ أيضاً ـ شاهد على ذلك ، حيث يقول سبحانه وتعالى : (لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك لعلّهم يهتدون) .
وقال بعضهم بأنّ «ما» هنا موصولة ، بحيث يكون معنى الجملة «لتنذر قوماً بالذي اُنذر آباؤهم» .
وبعض احتملوا أنّ «ما» مصدرية ، وعليه يكون معنى الجملة «لتنذر قوماً بنفس الإنذار الذي كان لآبائهم» ، ولكن يبدو أنّ كلا الإحتمالين ضعيف .
7 ـ نهج البلاغة ، خ33 و104 .
8 ـ بناءً على ما عرضناه يتّضح بأنّ الضمير في «أكثرهم» يعود على قادة القوم وليس على القوم ، وشاهد ذلك الآيات التالية لتلك الآية .
9 ـ مفردات الراغب ، وقطر المحيط ، ومجمع البحرين ، مادّة غل .
10 ـ على ما أوردناه أصبح واضحاً أنّ الضمير «هي» في جملة (فهي إلى الأذقان) يعود على «الأغلال» بحيث أنّها رفعت أذقانهم إلى الأعلى ، وجملة «فهم مقمحون» تفريع على ذلك . وما احتمله البعض من أنّ «هي» تعود على «الأيدي» التي لم يرد ذكرها في الآية ، يبدو بعيداً جدّاً .
11 ـ تفسير الآلوسي ، المجلّد 22 ، صفحة 199 .
12 ـ اُنظر النحل : 44 وفصّلت : 41 ، والزخرف : 44 والقمر : 25 ، وفي نفس الوقت فإنّ لفظة «ذكر» تكرّرت في القرآن كثيراً بمعنى «التذكير المطلق» .
 الاكثر قراءة في سورة يس
الاكثر قراءة في سورة يس
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية












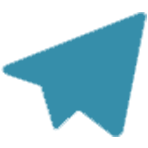
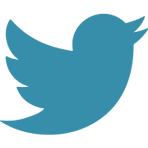

 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)