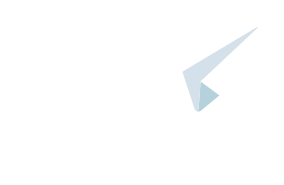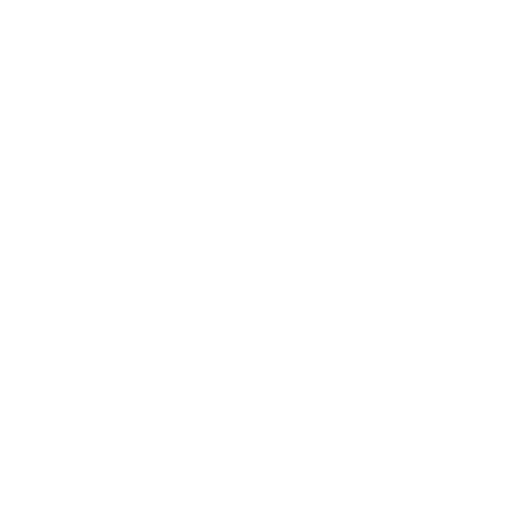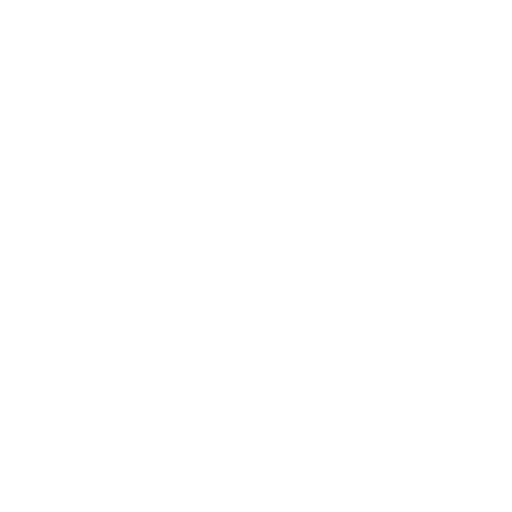تأملات قرآنية

مصطلحات قرآنية

هل تعلم


علوم القرآن

أسباب النزول


التفسير والمفسرون


التفسير

مفهوم التفسير

التفسير الموضوعي

التأويل


مناهج التفسير

منهج تفسير القرآن بالقرآن

منهج التفسير الفقهي

منهج التفسير الأثري أو الروائي

منهج التفسير الإجتهادي

منهج التفسير الأدبي

منهج التفسير اللغوي

منهج التفسير العرفاني

منهج التفسير بالرأي

منهج التفسير العلمي

مواضيع عامة في المناهج


التفاسير وتراجم مفسريها

التفاسير

تراجم المفسرين


القراء والقراءات

القرآء

رأي المفسرين في القراءات

تحليل النص القرآني

أحكام التلاوة


تاريخ القرآن

جمع وتدوين القرآن

التحريف ونفيه عن القرآن

نزول القرآن

الناسخ والمنسوخ

المحكم والمتشابه

المكي والمدني

الأمثال في القرآن

فضائل السور

مواضيع عامة في علوم القرآن

فضائل اهل البيت القرآنية

الشفاء في القرآن

رسم وحركات القرآن

القسم في القرآن

اشباه ونظائر

آداب قراءة القرآن


الإعجاز القرآني

الوحي القرآني

الصرفة وموضوعاتها

الإعجاز الغيبي

الإعجاز العلمي والطبيعي

الإعجاز البلاغي والبياني

الإعجاز العددي

مواضيع إعجازية عامة


قصص قرآنية


قصص الأنبياء

قصة النبي ابراهيم وقومه

قصة النبي إدريس وقومه

قصة النبي اسماعيل

قصة النبي ذو الكفل

قصة النبي لوط وقومه

قصة النبي موسى وهارون وقومهم

قصة النبي داوود وقومه

قصة النبي زكريا وابنه يحيى

قصة النبي شعيب وقومه

قصة النبي سليمان وقومه

قصة النبي صالح وقومه

قصة النبي نوح وقومه

قصة النبي هود وقومه

قصة النبي إسحاق ويعقوب ويوسف

قصة النبي يونس وقومه

قصة النبي إلياس واليسع

قصة ذي القرنين وقصص أخرى

قصة نبي الله آدم

قصة نبي الله عيسى وقومه

قصة النبي أيوب وقومه

قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله


سيرة النبي والائمة

سيرة الإمام المهدي ـ عليه السلام

سيرة الامام علي ـ عليه السلام

سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله

مواضيع عامة في سيرة النبي والأئمة


حضارات

مقالات عامة من التاريخ الإسلامي

العصر الجاهلي قبل الإسلام

اليهود

مواضيع عامة في القصص القرآنية


العقائد في القرآن


أصول

التوحيد

النبوة

العدل

الامامة

المعاد

سؤال وجواب

شبهات وردود

فرق واديان ومذاهب

الشفاعة والتوسل

مقالات عقائدية عامة

قضايا أخلاقية في القرآن الكريم

قضايا إجتماعية في القرآن الكريم

مقالات قرآنية


التفسير الجامع


حرف الألف

سورة آل عمران

سورة الأنعام

سورة الأعراف

سورة الأنفال

سورة إبراهيم

سورة الإسراء

سورة الأنبياء

سورة الأحزاب

سورة الأحقاف

سورة الإنسان

سورة الانفطار

سورة الإنشقاق

سورة الأعلى

سورة الإخلاص


حرف الباء

سورة البقرة

سورة البروج

سورة البلد

سورة البينة


حرف التاء

سورة التوبة

سورة التغابن

سورة التحريم

سورة التكوير

سورة التين

سورة التكاثر


حرف الجيم

سورة الجاثية

سورة الجمعة

سورة الجن


حرف الحاء

سورة الحجر

سورة الحج

سورة الحديد

سورة الحشر

سورة الحاقة

الحجرات


حرف الدال

سورة الدخان


حرف الذال

سورة الذاريات


حرف الراء

سورة الرعد

سورة الروم

سورة الرحمن


حرف الزاي

سورة الزمر

سورة الزخرف

سورة الزلزلة


حرف السين

سورة السجدة

سورة سبأ


حرف الشين

سورة الشعراء

سورة الشورى

سورة الشمس

سورة الشرح


حرف الصاد

سورة الصافات

سورة ص

سورة الصف


حرف الضاد

سورة الضحى


حرف الطاء

سورة طه

سورة الطور

سورة الطلاق

سورة الطارق


حرف العين

سورة العنكبوت

سورة عبس

سورة العلق

سورة العاديات

سورة العصر


حرف الغين

سورة غافر

سورة الغاشية


حرف الفاء

سورة الفاتحة

سورة الفرقان

سورة فاطر

سورة فصلت

سورة الفتح

سورة الفجر

سورة الفيل

سورة الفلق


حرف القاف

سورة القصص

سورة ق

سورة القمر

سورة القلم

سورة القيامة

سورة القدر

سورة القارعة

سورة قريش


حرف الكاف

سورة الكهف

سورة الكوثر

سورة الكافرون


حرف اللام

سورة لقمان

سورة الليل


حرف الميم

سورة المائدة

سورة مريم

سورة المؤمنين

سورة محمد

سورة المجادلة

سورة الممتحنة

سورة المنافقين

سورة المُلك

سورة المعارج

سورة المزمل

سورة المدثر

سورة المرسلات

سورة المطففين

سورة الماعون

سورة المسد


حرف النون

سورة النساء

سورة النحل

سورة النور

سورة النمل

سورة النجم

سورة نوح

سورة النبأ

سورة النازعات

سورة النصر

سورة الناس


حرف الهاء

سورة هود

سورة الهمزة


حرف الواو

سورة الواقعة


حرف الياء

سورة يونس

سورة يوسف

سورة يس


آيات الأحكام

العبادات

المعاملات
القرآن والصوت اللغوي
المؤلف:
محمد حسين الصغير
المصدر:
الصوت اللغوي في القران
الجزء والصفحة:
ص73-80.
23-04-2015
3752
اتخذت المباحث الصوتية عند العرب القرآن أساسا لتطلعاتها ، وآياته مضمارا لاستلهام نتائجها ، وهي حينما تمازج بين الأصوات واللغة ، وتقارب بين اللغة والفكر ، فإنما تتجه بطبيعتها التفكيرية لرصد تلك الأبعاد مسخرة لخدمة القرآن الكريم ، فالقرآن كتاب هداية وتشريع لا شك في هذا ، ولكنه من جانب لغوي كتاب العربية الخالد ، يحرس لسانها ، ويقوّم أود بيانها ، فهي محفوظة به ، وهو محفوظ باللّه تعالى : {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ } [الحجر : 9]. لهذا بقيت العربية في ذروة عطائها الذي لا ينضب ، وظلت إضاءتها في قمة ألقها الذي لا يخبو ، فكم من لغة قد تدهورت وتعرضت لعوامل الانحطاط ، وانحسرت أصالتها برطانة الدخيل المتحكم من اللغى الأخرى ، فذابت وخمد شعاعها الهادي ، إلا العربية فلها مدد من القرآن ، ورافد من بحره المتدفق بالحياة ، تحسه وكأنك تلمسه ، وتعقله وكأنك تبصره ، فهو حقيقة مستطيلة لا تجحد ، مسك القرآن باللسان العربي عن الانزلاق ، وأفعم التزود اللغوي عن الارتياد في لغات متماثلة ، حتى عاد اللسان متمرسا على الإبداع ، والتزود سبيلا للثقافات الفياضة ، لا يحتاج إلى لغة ما ، بل تحتاجه كل لغة.
ورصد أية ظاهرة لغوية يعني العناية باللغة ذاتها ، ويتوجه إلى ترصين دعائمها من الأصل ، لأن الأصوات بانضمام بعضها إلى بعض تشكل مفردات تلك اللغة ، والمفردات وحدها تمثل معجمها ، وبتأليفها تمثل الكلام في تلك اللغة ، والقدرة على تناسق هذا الكلام وتآلفه ، من مهمة الأصوات في تناسقها وتآلفها ، وتنافر الكلمات وتهافتها قد يعود على الأصوات في قرب مخارجها أو تباعدها ، أو في طبيعة تركيبها وتماسها ، أو من تداخل مقاطعها وتضامها ، ذلك أن اللغة أصوات. «و مصدر الصوت الإنساني في معظم الأحيان هو الحنجرة ، أو بعبارة أدق : الوتران الصوتيان فيها ، فاهتزازات هذين الوترين هي التي تنطلق من الفم أو الأنف ثم تنتقل خلال الهواء الخارجي» (1).
ولغتنا العربية كبقية لغات العالم ، عبارة عن أصوات متآلفة تنطلق من الوتر بين الصوتيين لتأخذ طريقها إلى الخارج.
بيد أن العربية سميت باسم صوت متميز بين الأصوات فعاد معلما لها ، ومؤشرا عليها ، فقيل : لغة الضاد.
ومع أن ابن فارس (ت : 395 هـ) يقول :
«و مما اختصت به لغة العرب الحاء والظاء» (2). إلا أن الضاد يبقى صوتا صارخا في العربية لا مشابه له في اللغات العالمية ، بل وحتى في اللغات السامية القريبة الأصر من اللغة العربية ، وكان لهذا الصوت نصيبه من الالتباس بصوت «الظاء» فكانت الإشارة منا في عمل مستقل إلى الاختلاف فيما بين الضاد والظاء حتى عند العرب أنفسهم ، وأن الالتباس بالضاد كان ناجما عن مقاربتها للظاء في الأداء ، وعدم تمييز هذين الصوتين حتى لدى العرب المتأخرين عن عصر القرآن (3).
ومن عجائب القرآن الأدائية ، وضعه هذين الصوتين في سياق واحد ، وبعرض مختلف ، في مواضع عديدة من القرآن ، ذلك من أجل الدربة الدقيقة على التلفظ بهما ، والمران على استعمالهما منفصلين ، بتفخيم الضاد وترقيق الظاء ، قال تعالى : {وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ (50) وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ} [فصلت : 50 ، 51]. فالظاء في (غليظ) والضاد في (أعرض) وفي (عريض) مما تواضع الأوائل على قراءته بكل دقة وتمحيص ، وميزوا بذائقتهم الفطرية فيما بين الصوتين.
والحاء بالعربية تنطق «هاء» في بعض اللغات السامية ، وكذلك صوتها في اللغات الأوروبية ، فهما من مخرج واحد «و لو لا هتة في الهاء لأشبهت الحاء لقرب مخرج إلهاء من الحاء» (4).
ولعمق التوجه الصوتي في القرآن لدى التمييز بين المقاربات نجده يضعهما في سياق واحد في كثير من الآيات ، من أجل السليقة العربية الخالصة ، قال تعالى :
{فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ (2) وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ} [التوبة : 2 ، 3] فالحاء من «فسيحوا» والهاء من «أشهر» في الآية الأولى إلى جنب الهاء من {اللَّهِ ورَسُولِهِ} والحاء من «الحج» في الآية الثانية ، جاءت جميعها بسياق قرآني متناسق في هدف مشترك للتمييز بين الصوتين حينا ، وللحفاظ على خصائص العربية حينا آخر ، ولبيان اختلاطهما عند غير العربي المحض ، فلا يستطيع أداء «الحاء» تأديته «الهاء» إذ قد يلتبسان عليه ، وهو جانب فني حرص القرآن على كشفه بعيدا عن الغرض الديني إلا في وجوب أداء القرآن قراءة كما نزل عربيا مبينا.
لهذا نرى أن القرآن هو القاعدة الصلبة للنطق العربي الصحيح لجملة أصوات اللغة ، ولا سيما الضاد والظاء أو الحاء والهاء ، في التمرس عليهما والتفريق الدقيق بينهما.
ولقد كان سليما جدا ما توصل إليه صديقنا المفضل الدكتور أحمد مطلوب عضو المجمع العلمي العراقي بقوله :
«إن من أهم خصائص العربية ثبات أصوات الحروف فيها ، لأن جوهر الصوت العربي بقي واضحا ، وهو ما يتمثل في قراءة القرآن الكريم وإخراج الحروف الصامتة إخراجا يكاد يكون واحدا» (5). لأن اللغة العربية تستمد أصولها من القرآن ، بل تبقى أصولها ثابتة في القرآن ، وأولويات هذه الأصول هي الأصوات لأن الأصوات أصل اللغات.
ولا غرابة بعد هذا أن يكون استقراء ملامح الظاهرة الصوتية في التراث العربي الإسلامي يوصلنا إلى أن القرآن الكريم هو المنطلق الأساس فيها ، وأنه قد نبه بتأكيد بالغ على مهمة الصوت اللغوي في إثارة الإحساس الوجداني عند العرب ، وإيقاظ الضمائر الإنسانية للتوجه نحوه لدى استعماله الحروف الهجائية المقطعة في جمهرة من فواتح السور القرآنية ، وفي أسرار فواصل الآيات ، وفي قيم الأداء القرآني ، وفي الدلالة الصوتية للألفاظ في القرآن ، وهو ما خصصت له هذه الرسالة فصولا مستقلة ، شكلت المادة الأولية للبنات الموضوع ، ونهضت بمفصّل حيثيات الصوت اللغوي في القرآن.
ولا بد من الإشارة هنا إلى أن البداية في اعتماد الصوت اللغوي في القرآن ضمن الدراسات العربية قد جاء ضمن مجموعتين دراستين هما :
الدراسات القرآنية والدراسات البلاغية ، ولا بد من الإشارة قبل ذلك إلى تردد جهود بعض الفلاسفة الموسوعيين لمجمل حياة الأصوات تمهيدا لخوضها في القرآن.
فهذا ابن سينا (ت : 428 هـ) يضع رسالة متخصصة نادرة في الأصوات أسماها (أسباب حدوث الحروف) (6). وقد كان متمرسا فيها للإشارات الصوتية وتمييزها في الأسماع ، وتحدث عن مخارج الأصوات وغضاريف الحنجرة ، وعرض للفم واللسان تشريحيا وطبيا وتركيبيا ، وعني عناية خاصة بترتيب مخارج الصوت العربي مقارنا باللغات الأخرى بحسب تركيب أجهزة الصوت الإنساني ، وبحث مميزات الحرف العربي صوتيا ، وحكم جهازه السمعي في معرفة الأصوات وأثر تذبذبها. وأما الدراسات القرآنية ، فقد انطلقت إلى دراسة الأصوات من خلال الفصول القادمة في الرسالة ضمن موضوعاتها الدقيقة المتخصصة ، وكانت على نوعين كتب إعجاز القرآن وكتب القراءات. أما كتب إعجاز القرآن ، فقد كان المجلي فيها بالنسبة للصوت اللغوي علي بن عيسى الرماني (ت : 386 هـ) فهو أبرز الدراسين صوتيا ، وأقدمهم سبقا إلى الموضوع ، وأولهم تمرسا فيه ، إلا أنه بالضرورة قد مزج بين دراسة الأصوات وعلم المعاني مطبقا تجاربه في باب التلاؤم تارة ومتخصصا لدراسة فواصل الآيات بلاغيا كما سيأتي في موضعه.
أما التلاؤم الصوتي عند الرماني فهو نقيض التنافر ، والتلاؤم تعديل الحروف في التأليف ، لأن تأليف الكلام على ثلاثة أوجه : متنافر ، ومتلائم في الطبقة الوسطى ، ومتلائم في الطبقة العليا (7).
ويعود الرماني بالتلاؤم إلى تجانس الأصوات ، ولما كانت أصوات القرآن متجانسة تماما ، فإن القرآن كله متلائم في الطبقة العليا ، وذلك بين لمن تأمله ، والفرق بين القرآن وبين غيره من الكلام في تلاؤم الحروف على نحو الفرق بين المتنافر والمتلائم في الطبقة الوسطى ، وبعض الناس أشد إحساسا بذلك وفطنة له من بعض (8).
ويبحث الرماني التلاؤم في أصوات القرآن من وجوه :
1- السبب في التلاؤم ويعود به إلى تعديل الحروف في التأليف ، فكلما كان أعدل كان أشد تلاؤما.
2- والفائدة في التلاؤم ، ويعود بها إلى حسن الكلام في السمع ، وسهولته في اللفظ ، وتقبل المعنى له في النفس لما يرد عليها من حسن الصورة وطريق الدلالة.
3- وظاهرة التلاؤم ، ويعود بها إلى مخارج الحروف في اختلافها ، فمنها ما هو من أقصى الحلق ، ومنها ما هو من أدنى الفم ، ومنها ما هو في الوسط بين ذلك.
«و التلاؤم في التعديل من غير بعد شديد أو قرب شديد. وذلك يظهر بسهولته على اللسان ، وحسنه في الأسماع ، وتقبله في الطباع ، فإذا انضاف إلى ذلك حسن البيان في صحة البرهان في أعلى الطبقات ، ظهر الإعجاز للجيد الطباع البصير بجواهر الكلام» (9).
وأما كتب القراءات ، فقد انتهى كثير منها بإعطاء مصطلحات صوتية اقترنت بالنحو تارة وباللغة تارة أخرى ، وتمحضت للصوت القرآني بينهما ، وكان ذلك في بحوث متميزة برز منها : الإدغام ، الإبدال ، الإعلال ، الإخفاء ، الإظهار ، الإشمام ، الإمالة ، الإشباع ، المد ، التفخيم ، الترقيق مما اصطنعه علماء الأداء الصوتي للقرآن كما سيأتي بحثه في حينه.
الحق أن الصوت اللغوي في القرآن قد بحث متناثرا هنا وهناك في مفردات حية ، تتابع عليها جملة من الأعلام المبرزين الذين اتسمت جهودهم بالموضوعية والتجرد وبيان الحقيقة ، كان منهم : علي بن عيسى الزماني (ت : 386 هـ) وأبو بكر الباقلاني (ت : 403 هـ) وأبو عمر الداني (ت : 444 هـ) ومحمد بن الحسن الطوسي (ت : 548 هـ) وجار اللّه الزمخشري (ت : 538 هـ) وأبو علي الطبرسي(ت 548 هـ) وعبد اللّه بن محمد النكزاوي (ت : 683 هـ) وإبراهيم بن عمر الجعبري (ت : 732 هـ) وبدر الدين الزركشي (ت : 794 هـ) وجلال الدين السيوطي (ت : 911 هـ) .
وأما الدراسات البلاغية التي اشتملت على خصائص الأصوات فقد بحثت على أيدي علماء متمرسين كالشريف الرضي (ت : 406 هـ) وعبد القاهر الجرجاني (ت : 471 هـ) وابن سنان الخفاجي (ت : 466 هـ) وأبي يعقوب السكاكي (ت : 626 هـ) وأضرابهم : و كانت مباحثهم طبقا لتوجه علم المعاني : وتزاحم الأصوات في قبول ذائقتها النطقية أو السّمعية ورفضها ، من خلال : تنافر الحروف ، تلاؤم الأصوات ، التعقيد اللفظي ، التعقيد المعنوي ، فصاحة اللفظ المفرد ، مما هو معلوم في مثل هذه المباحث مما يتعلق بالصوت منها ، وخلصت إلى القول بخلو القرآن العظيم من التنافر في الكلمات ، أو التشادق في الألفاظ ، أو العسر في النطق ، أو المجانبة للأسماع ، وكونه في الطبقة العليا من الكلام في تناسقه وتركيبه وتلاؤمه.
أما ما يتعلق بالأصوات من مخارجها في موضوع التنافر فلهم بذلك رأيان :
الأول : أن التنافر يحصل بين البعد الشديد أو القرن الشديد وقد نسب الرماني هذا الرأي إلى الخليل «و ذلك أنه إذا بعد الشديد كان بمنزلة الطفر ، وإذا قرب القرب الشديد كان بمنزلة مشي المقيد ، لأنه بمنزلة رفع اللسان ورده إلى مكانه ، وكلاهما صعب على اللسان ، والسهولة من ذلك في الاعتدال ، ولذلك وقع في الكلام الإدغام والإبدال» (10).
الثاني : أن التنافر يحصل في قرب المخارج فقط وهو ما يذهب إليه ابن سنان الخفاجي (ت : 466 هـ) بقوله : «و لا رأى التنافر في بعد ما بين مخارج الحروف وإنما هو في القرب. ويدل على صحة ذلك الاعتبار ، فإن هذه الكلمة «الم» غير متنافرة ، وهي مع ذلك مبنية من حروف متباعدة المخارج- لأن الهمزة من أقصى الحلق ، والميم من الشفتين ، واللام متوسطة بينهما. فأما الإدغام والإبدال فشاهدان على أن التنافر في قرب الحروف دون بعدها ، لأنهما لا يكادان يردان في الكلام إلا فرارا من تقارب الحروف ، وهذا الذي يجب عندي اعتماده لأن التتبع والتأمل قاضيان بصحته» (11).
وقد يتبعه بالرد على هذا الرأي ابن الأثير (ت : 637 هـ) فقال : «أما تباعد المخارج فإن معظم اللغة العربية دائر عليه ... ولهذا أسقط الواضع حروفا كثيرة في تأليف بعضها مع بعض استثقالا واستكراها ، فلم يؤلف بين حروف الحلق كالحاء والخاء والعين ، وكذلك لم يؤلف بين الجيم والقاف ، ولا بين اللام والراء ، ولا بين الزاي والسين ، وكل هذا دليل على عنايته بتأليف المتباعد المخارج ، دون المتقارب» (12).
و بعيدا عن هذا وذاك ، فان الطبيعة التركيبة في اللغة العربية قد تمرست في تعادل الأصوات وتوازنها ، مما جعل لغة القرآن في الذروة من طلاوة الكلمة ، والرقة في تجانس الأصوات ، لذلك فقد استبعد العرب جملة من الألفاظ لا تنسجم صوتيا في تداخل حروفها ، وتنافر مخارجها ، سواء أ كانت قريبة أم بعيدة «فإن الجيم لا تقارن الفاء ولا القاف ولا الطاء ولا الغين بتقديم ولا بتأخير.
والزاي لا تقارن الظاء ولا السين ولا الضاد ولا الذال بتقديم ولا تأخير» (13).
وفي هذا دلالة على «امتياز اللغة العربية في مجموع أصوات حروفها بسعة مدرجها الصوتي سعة تقابل أصوات الطبيعة في تنوعها وسعتها ، وتمتاز من جهة أخرى بتوزعها في هذا المدرج توزعا عادلا يؤدي إلى التوازن والانسجام بين الأصوات» (14).
وكان التنافر في أصوات الكلمة موضع عناية عند السكاكي (ت : 626) ومن بعده القزويني (ت : 739 هـ) عند مباحث فصاحة المفرد ، وهي خلوصه من تنافر الحروف والغرابة ، ومخالفة القياس اللغوي ، وعند فصاحة الكلام ، وهي خلوصه من ضعف التأليف ، وتنافر الكلمات ، والتعقيد بشقيه اللفظي والمعنوي ، وهي موضوعات جرى على إدراجها في الموضوع علماء المعاني والبيان بعد السكاكي والقزويني إدراجا تقليديا للقول بسلامة القرآن من التنافر (15).
ولا حاجة بنا إلى تأكيد هذا القول فهو أمر مفروغ عنه في القرآن ، وبقيت مفردات الصوت اللغوي فيه موضع عناية البحث.
(2) ابن فارس ، الصاحبي في فقه اللغة : 100.
(3) المؤلف ، منهج البحث الصوتي عند العرب : بحث.
(3) الخليل ، كتاب العين : 1/ 57.
(5) أحمد مطلوب ، بحوث لغوية : 27.
(6) طبعت في القاهرة ، 1332 ه- 1352 ه.
(7) الزماني ، النكت في إعجاز القرآن : 94.
(8) المصدر نفسه : 95.
(9) الرماني : النكت في إعجاز القرآن : 96.
(10) الرماني ، النكت في إعجاز القرآن : 96.
(11) ابن سنان الخفاجي ، سر الفصاحة : 91.
(12) ابن الأثير ، المثل السائر : 152.
(13) الجاحظ ، البيان والتبيين : 1/ 69.
(14) أحمد مطلوب ، بحوث لغوية : 28.
(15) ظ : القزويني ، الإيضاح في علوم البلاغة : 72- 79.
 الاكثر قراءة في أحكام التلاوة
الاكثر قراءة في أحكام التلاوة
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية












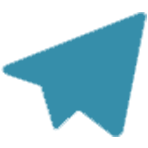
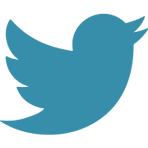

 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)