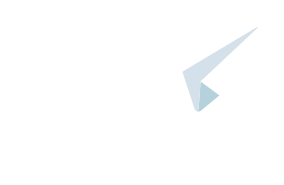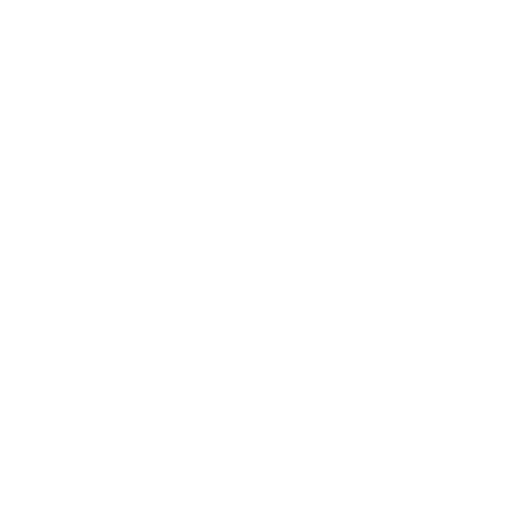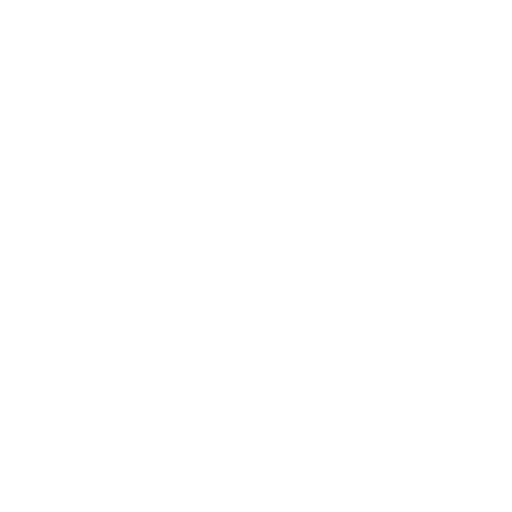تاريخ الفيزياء

علماء الفيزياء


الفيزياء الكلاسيكية

الميكانيك

الديناميكا الحرارية


الكهربائية والمغناطيسية

الكهربائية

المغناطيسية

الكهرومغناطيسية


علم البصريات

تاريخ علم البصريات

الضوء

مواضيع عامة في علم البصريات

الصوت


الفيزياء الحديثة


النظرية النسبية

النظرية النسبية الخاصة

النظرية النسبية العامة

مواضيع عامة في النظرية النسبية

ميكانيكا الكم

الفيزياء الذرية

الفيزياء الجزيئية


الفيزياء النووية

مواضيع عامة في الفيزياء النووية

النشاط الاشعاعي


فيزياء الحالة الصلبة

الموصلات

أشباه الموصلات

العوازل

مواضيع عامة في الفيزياء الصلبة

فيزياء الجوامد


الليزر

أنواع الليزر

بعض تطبيقات الليزر

مواضيع عامة في الليزر


علم الفلك

تاريخ وعلماء علم الفلك

الثقوب السوداء


المجموعة الشمسية

الشمس

كوكب عطارد

كوكب الزهرة

كوكب الأرض

كوكب المريخ

كوكب المشتري

كوكب زحل

كوكب أورانوس

كوكب نبتون

كوكب بلوتو

القمر

كواكب ومواضيع اخرى

مواضيع عامة في علم الفلك

النجوم

البلازما

الألكترونيات

خواص المادة


الطاقة البديلة

الطاقة الشمسية

مواضيع عامة في الطاقة البديلة

المد والجزر

فيزياء الجسيمات


الفيزياء والعلوم الأخرى

الفيزياء الكيميائية

الفيزياء الرياضية

الفيزياء الحيوية

الفيزياء العامة


مواضيع عامة في الفيزياء

تجارب فيزيائية

مصطلحات وتعاريف فيزيائية

وحدات القياس الفيزيائية

طرائف الفيزياء

مواضيع اخرى
التحليق عاليا المناطيد.. وكواشف الأشعة السينية.. وعملية الإطلاق
المؤلف:
والتر لوين ووارن جولدستين
المصدر:
في حب الفيزياء
الجزء والصفحة:
ص225–233
2024-01-18
2061
لكي يتمكن عالم الفيزياء من القيام بأي شيء، فلا بد له من الحصول على المال اللازم لبناء المعدات ودفع رواتب الطلاب والسفر بعيدًا في بعض الأحيان (إلا إذا كنت عالم فيزياء نظرية، فكل ما تحتاج إليه ورقة وشاشة حاسوب). فالجانب الأعظم مما يقوم به العلماء هو التقدم بمقترحات مشاريع قوية لبرامج شديدة التنافسية لأجل الحصول على الدعم اللازم لإجراء الأبحاث. أعلم أن ذلك يخلو من كل مظاهر الجاذبية والإثارة، لكن صدق أو لا تصدق لا شيء يمكن أن يحدث دون فعل ذلك.
قد تختمر في عقلك فكرة عبقرية لتجربة أو رحلة رصدية، فإذا لم تعرف كيف تحولها إلى مقترح مقنع، فإنها لن تؤدي إلى شيء. لقد كنا دوما في تنافس شرس مع أفضل الفرق في العالم، لذا كان ذلك جهدًا قاسيا، وما زال كذلك إلى الآن، لأي عالم في أي مجال. فأينما تنظر إلى عالم تجريبي ناجح – سواء كان عالم أحياء، أو كيمياء، أو فيزياء، أو علوم الحاسب أو الاقتصاد، أو علم الفلك، لا يهم – فاعلم أنك ترى أمامك شخصا أدرك كيف ينتصر على منافسيه مرةً بعد أخرى. وهذا لا يمكن أن يصنع شخصيات رقيقة مرتبكة في الأغلب؛ وهذا ما جعل زوجتي، سوزان، التي عملت في معهد ماساتشوستس لعشر سنوات، مولعةً بقول: «ليس في معهد ماساتشوستس أشخاص يعرفون نكران الذات».
والآن بافتراض أننا حصلنا على التمويل، وهو ما كان يحدث عادةً (فقد حصلت على دعم كبير من المؤسسة الوطنية للعلوم ومن ناسا) فعملية إطلاق منطاد لارتفاع يبلغ 30 ميلا تقريبا، حاملًا على متنه تلسكوب أشعة سينية يزن 2000 رطل [حوالي 907 كيلوجرامات تقريبا] (مربوطا في مظلة)، وينبغي أن تستعيده سليمًا بلا خدش، كانت عملية بالغة التعقيد فكان ينبغي أن يكون الطقس وقت الإطلاق هادئا تماما، وتلك المناطيد حساسة جدا، حتى إن أي هبة ريح خفيفة يمكن أن تؤدي إلى إفشال المهمة برمتها. كذلك، كنتَ تحتاج إلى بنية تحتية كمواقع للإطلاق، ومركبات للإطلاق، وما إلى ذلك – لمساعدتك على إطلاق المنطاد عاليا في الغلاف الجوي وتعقبه. ولأنني كنت أريد إجراء عملية الرصد باتجاه مركز مجرة درب التبانة، الذي يُطلق عليه المركز المجري، حيث تقع مصادر كثيرة للأشعة السينية، فكان علي أن أجري مهمة الرصد من النصف الجنوبي للكرة الأرضية. فقررت إطلاق المنطاد من ميلدورا وأليس سبرينجز في أستراليا. كنتُ أبتعد جدا عن موطني وعائلتي – وكان لدي أربعة أبناء في ذلك الوقت – لبضعة أشهر في كل مرة عادةً.
كانت عملية الإطلاق باهظة التكاليف من كل النواحي فالمناطيد نفسها كانت ضخمة؛ وكان أكبر منطاد أطلقته (وكان وقتها أكبر منطاد يُطلق على الإطلاق، وربما يظل كذلك إلى الأبد) بحجم 52 مليون قدم مكعب؛ وعند نفخه بالكامل وإطلاقه إلى ارتفاع 145٫000 قدم، بلغ قطره 235 قدمًا. كانت المناطيد تصنع من متعدد الإثيلين (بولي إثيلين) خفيف الوزن – بسمك نصف من واحد من ألف من البوصة، أي أرفع سمكا من أكياس التغليف البلاستيكية وورق السجائر. ومن ثم إذا لمست الأرض خلال عملية الإطلاق فإنها تتمزق. وكانت تلك المناطيد العملاقة تزن حوالي 700 رطل. وعادةً ما كنا نسافر بمناطيد احتياطية وكانت تكلفة كل منها تبلغ 100,000 دولار – وذلك قبل أربعين عاما، حينما كان ذلك المبلغ مهولا.
بالإضافة إلى ذلك، كان لا بد من تصنيع تلك المناطيد في مصانع ضخمة، فكانت ألواح المنطاد، تلك الأجزاء التي تشبه فصوص القشرة الداخلية لثمرة اليوسفي، تُصنع منفصلة ثم تلحم معا بلحام حراري. ولم يكن المصنع يثق إلا بالنساء لأداء مهمة اللحام؛ حيث كانوا يقولون: إن الرجال كانوا نافدي الصبر أكثر من اللازم ويرتكبون أخطاء كثيرة. بعد ذلك كان علينا شحن الهيليوم اللازم لنفخ المناطيد إلى أستراليا؛ وكانت تكلفة الهيليوم وحده تبلغ 80,000 دولار للمنطاد الواحد. وقياسًا بقيمة الدولارات اليوم، فإن تلك التكلفة لكل منطاد بما يلزمه من غاز الهيليوم تضاهي 700,000 دولار، وذلك دون أخذ المنطاد الاحتياطي، وتكاليف انتقالاتنا، وسكننا، وطعامنا. هنا حقًّا، لقد كنا نحاول كشف أسرار الفضاء العميق، نقيم في منتصف الصحراء الأسترالية معتمدين على الطقس تمام الاعتماد ولكني لم أحكي لك عن جاك بعد، سوف أتحدث عنه عما قريب.
إلا أن تكلفة المناطيد كانت منخفضة مقارنة بالتلسكوب؛ تلك الآلة بالغة التعقيد التي يبلغ وزنها طنا، كان صنعها يستغرق عامين بتكلفة مليون دولار – أي ما يضاهي أربعة ملايين دولار بالقيمة الحالية للدولار. لم يتوفر لدينا قط المال الكافي للحصول على تلسكوبين في المرة الواحدة ومن ثم إن فقدنا التلسكوب الذي لدينا – وهو ما تعرضنا له مرتين – فإن الحظ يجانبنا لمدة عامين كاملين على الأقل؛ إذ لم يكن بإمكاننا تصنيع تلسكوب جديد حتى نحصل على التمويل. ولذا كان فقدان التلسكوب بمثابة الكارثة.
ولم تكن عاقبة ذلك تطالني بمفردي، بل كانت تسبب تعطيلا طويلا لطلاب الدراسات العليا المشاركين في بناء التلسكوب والذين كانت أطروحاتهم لنيل درجة الدكتوراه تقوم على أدوات عمليات الرصد ونتائجها. لقد كانت شهاداتهم تحلق عاليا مع المناطيد.
كذلك كنا نحتاج إلى طقس هادئ؛ فالرياح شديدة في طبقة الستراتوسفير، تهب من الشرق إلى الغرب بسرعة تبلغ 100 ميل في الساعة تقريبًا على مدار ستة أشهر من العام ومن الغرب إلى الشرق في النصف الآخر من العام. هذه الرياح تعكس اتجاهها مرتين في العام الواحد ونطلق على ذلك تحول الاتجاه. وبينما كانت الرياح تغير اتجاهها تنخفض سرعة الرياح البالغة 125,000 قدم إلى أقل درجة، مما كان يتيح لنا إجراء عمليات الرصد لساعات طويلة ومن ثم كان يتعين علينا الوجود في مكان يمكننا منه قياس سرعة تلك الرياح، وإطلاق المناطيد خلال الوقت الذي تعكس فيه اتجاهها. فكنا نتحقق من سرعة الرياح كل يوم تقريبًا بالاستعانة بمناطيد الطقس التي كنا نتعقبها بالرادار. وفي أغلب الأحيان، كانت تلك المناطيد تصل إلى ارتفاع 125,000 قدم، حوالي 24 ميلا، قبل أن تنفجر. وتوقع الطقس لا يشبه دفع محامل الكرات عبر مسار في عرض عملي في المعمل. فالطقس أكثر تعقيدًا، لا يمكن توقعه بسهولة، ومع ذلك، كان كل ما نقوم به يعتمد على دقة توقعاتنا.
لم يكن الأمر يقتصر على ذلك. فبين ارتفاعي 30,000 قدم و60,000 من الغلاف الجوي، يوجد ما يُعرف بمنطقة التروبوبوز، التي يكون الجو فيها قارص البرودة، سالب 50 درجة سيلزيوس (–58 درجة فهرنهايت) هنالك كانت المناطيد تصير بالغة الهشاشة. أيضًا، كانت هناك تيارات رياح نفاثة تصطدم بالمناطيد، مما كان من الممكن أن يتسبب في انفجارها. كثير من التفاصيل كان من الممكن ألا تسير على ما يرام. فذات مرة انفجر منطادي ثم غرق في البحر، وكانت تلك نهاية التلسكوب؛ ثم وجدتُ حمولته بعد تسعة أشهر على أحد شواطئ نيوزيلندا. وبمعجزة ما استطعنا بمساعدة شركة كوداك استرجاع البيانات التي كانت مسجلة على فيلم مثبت على متن المنطاد.
وبرغم من تكرار تجهيزاتنا لعمليات الإطلاق تلك، كنتُ دائما ما أقول بالرغم من استعداداتنا الكاملة، فإننا لا نزال في حاجة إلى قليل من الحظ، وكثير منه أحيانا. كنا نجلب معداتنا إلى تلك المحطة النائية، ثم نجري اختبارات للتلسكوب، ونضبط المعدات، ونتأكد من أن كل شيء يعمل بدقة. بعد ذلك، كنا نشرع في تجهيزات ربط التلسكوب في المظلة التي ستُربَط أخيرًا في المنطاد. كنا نستغرق حوالي ثلاثة أسابيع للقيام بجميع الاختبارات في موقع إطلاق المنطاد والتجهز تماما لعملية الإطلاق، وعندئذٍ ربما لا يكون الطقس مناسبًا للإطلاق حينها، لم يكن بأيدينا سوى الانتظار ونحن على أهبة الاستعداد ومن حسن الحظ أن مدينة أليس سبرينجز، تلك البلدة الصحراوية الرائعة الواقعة في قلب أستراليا، كانت خلابة كنا نشعر وكأننا في منتصف اللامكان، إلا أن السماء كانت صافية، وتلك الساعات الأولى من الصباح حين كنا نحاول الإطلاق كانت مذهلة، حيث تكون سماء الليل قد تحولت إلى ذلك اللون الأزرق الداكن الذي يسبق الفجر، ومع شروق الشمس تصطبغ السماء والصحراء بالكامل بألوان وردية وبرتقالية زاهية.
وبمجرد أن نكون على أهبة الاستعداد للإطلاق، لا بد ألا تتعدى سرعة الرياح ثلاثة أميال في الساعة في اتجاه ثابت على مدار ثلاث أو أربع ساعات، وهي الفترة الزمنية اللازمة لإقلاع المنطاد (إذ كان نفخ المنطاد وحده يستغرق ساعتين). لذلك كنا غالبًا ما نطلق المناطيد في وقت الفجر، حيث تكون الرياح عند أدنى حد لها. لكن كان احتمال خطأ توقعاتنا قائمًا، وقتها لم يكن أمامنا سوى الانتظار لساعات وساعات إلى أن يصبح الطقس مؤاتيا للإطلاق.
ذات مرة كنا في خضم عملية الإطلاق في ميلدورا – ولم نكن قد بدأنا نفخ المنطاد بعد – حين هبت الرياح، على عكس توقعات الأرصاد الجوية. فتمزق المنطاد، لكن التلسكوب لم يصبه سوء لحسن الحظ. وهكذا، كل التجهيزات التي أجريناها، بالإضافة إلى 200,000 دولار ضاعت هباءً في بضع ثوانٍ. لقد كان وقع ذلك مؤلما إلى أقصى درجة. لكن كل ما أمكننا القيام به هو انتظار تحسن الطقس، ثم إعادة الكرة بالاستعانة بالمنطاد الاحتياطي. سيلازمك الإخفاق دائما. ففي آخر حملة استكشافية لي في آليس سبرينجز، فقدنا منطادين على التوالي خلال عملية الإطلاق بسبب ارتكاب فريق الإطلاق بعض الأخطاء الجسيمة. وقد باءت الحملة برمتها بالفشل إلا أن التلسكوب لم يصب بسوء، على الأقل فهو لم يغادر الأرض على الإطلاق. وفي آخر حملة استكشافية لي على الإطلاق في عام 1980 في ولاية تكساس، نجحت رحلة المنطاد التي استغرقت ثماني ساعات، لكن عند إنهائنا بأمر عبر اللاسلكي، فقدنا التلسكوب لأن المظلة لم تنفتح.
وحتى اليوم، نجاح إطلاق المناطيد ليس مضمونا ففي محاولة أجرتها وكالة ناسا لإطلاق منطاد من آليس سبرينجز في أبريل من عام 2010، وقع خطأ ما أدى إلى سقوط المنطاد أثناء الإقلاع، مؤديًا بدوره إلى هلاك معدات بملايين الدولارات وإصابة المراقبين تقريبًا.
على مر السنوات، أطلقتُ حوالي عشرين منطادًا؛ خمسة فقط. من تلك المناطيد أخفقت خلال عملية الإطلاق أو لم ترتفع (ربما كان الهيليوم يتسرب منها). وكان ذلك يعتبر معدل نجاح معقول (75 في المائة). قبل شهور من التوجه إلى موقع الإطلاق، كنا نجري اختبارًا للحمولة في شركة في ويلمنجتون في ماساتشوستس وضعنا التلسكوب في حجرة فراغية ثم قللنا الضغط إلى نفس الدرجة التي سيكون عليها عاليا في الغلاف الجوي، ما يضاهي ثلاثة أجزاء من ألف من الهواء. ثم عرضناه لهواء بارد يصل إلى سالب 50 درجة على مقياس سيلزيوس (–58 درجة فهرنهايت)، ومن ثم أدرناه – بتشغيل جميع كواشف الأشعة السينية، ثم مراقبة الأشعة السينية المنبعثة من مصدر مشع لعشر ثواني كل عشرين دقيقة، وذلك على مدار أربع وعشرين ساعة متصلة. وكانت تلسكوبات بعض من منافسينا – فقد كنا نشعر أن كل الفرق الأخرى التي تقوم بنفس عملنا فرق منافسة لنا – تخفق في هذا الاختبار أحيانًا؛ نظرًا لأن بطارياتها تفقد الطاقة في درجات الحرارة المنخفضة، أو تتوقف عن العمل تمامًا. لكن هذا لم يحدث معنا قط؛ لأننا كنا نختبر بطارياتنا بدقة. فكنا إذا رأينا خلال فترة الاختبار أن البطاريات ستفقد الطاقة، نعرف كيف نسخنها إذا اقتضى الأمر لحفظ طاقة البطارية.
أو خذ على سبيل المثال مشكلة التفريغ الهالي – التي تنشأ في خطوط الجهد العالي؛ حيث تعمل بعض من معداتنا بأسلاك الجهد العالي، والهواء الرقيق يُشكل بيئة مثالية لتطاير الشرر من الأسلاك إلى الهواء الطلق. هل تذكر صوت الأزيز المحيط بخطوط نقل التيار الكهربائي؟ هذه ظاهرة التفريغ الهالي. وأي عالم فيزياء تجريبي يعتمد في عمله على خطوط الجهد العالي يعلم أنه قد يتعرض لمشكلة التفريغ الهالي. في محاضراتي أعرض على الطلاب أمثلة لظاهرة التفريغ الهالي؛ فهناك تكون هذه الظاهرة ممتعة؛ أما على ارتفاع 145,000 قدم، فإنها كارثة.
فبعبارة بسيطة، ستبدأ المعدات في إصدار أصوات فرقعة، مما يتسبب في ضوضاء إلكترونات رهيبة ستحول دون التقاط فوتونات الأشعة السينية. يا لها من كارثة كبرى! ومن ثم، مجمل القول: لن تحصل على أي بيانات مفيدة على الإطلاق من الرحلة. فكان حل هذه الإشكالية هو تغطية كل سلوك الجهد العالي لمعداتنا بمطاط السيليكون. وقد قام آخرون بالإجراء ذاته، ومع ذلك تعرضت معداتهم لمشكلة التفريغ الهالي. لقد كانت اختباراتنا واستعداداتنا تؤتي ثمارها؛ إذ لم نتعرض أبدا لمشكلة التفريغ الهالي. وتلك مشكلة من عشرات المشاكل الهندسية الدقيقة التي ينطوي عليها بناء تلك التلسكوبات المعقدة – ولذلك يستغرق بناؤها وقتا طويلًا، ويستلزم تكاليف باهظة.
إذن، كيف نرصد الأشعة السينية ما إن يحلق التلسكوب عاليا في الغلاف الجوي؟ إجابة هذا السؤال ليست بالبسيطة، لذا أرجو منك أن تتحمل معي. بدايةً، كنا نستعين بنوع خاص من الكواشف (بلورات يوديد الصوديوم)، وليس العدادات التناسبية (المملوءة بالغاز) التي تُستخدم في حالة الصواريخ، وإنما كواشف قادرة على رصد الأشعة السينية التي تربو طاقة فوتوناتها على 15 ألف إلكترون فولت فعند اختراق فوتون الأشعة السينية أحد تلك البلورات فإنه قد يُخرج أحد الإلكترونات عن مداره، ناقلا له طاقة الأشعة السينية (وهذا ما يُطلق عليه الامتصاص الكهروفوتوني). فينتج هذا الإلكترون بدوره خطا من الأيونات في البلورة قبل أن يتوقف. وعند تحييد تلك الأيونات، تطلق طاقة في شكل ضوء مرئي، ومن ثم تنتج ومضة من الضوء – لقد تحولت طاقة فوتون الأشعة السينية إلى ومضة ضوء. وكلما زادت طاقة الأشعة السينية، كانت ومضات الضوء أشد. وكنا نستعين بمضخمات ضوئية لرصد ومضات الضوء وتحويلها إلى نبضات كهربية، وكلما زاد سطوع وميض الضوء، زاد الجهد الكهربائي للنبضة.
بعد ذلك، نضخم تلك النبضات ونرسلها إلى كاشف مُميّز، يعمل على قياس جهد النبضات الكهربية ويصنفها تبعًا لحجمها – وهو ما يدل على مستويات طاقة الأشعة السينية. وفي الأيام الأولى، سجلنا أشعة سينية على خمسة مستويات طاقة مختلفة.
وهكذا يصير لدينا سجل بالمشاهدات المرصودة بعد رحلة البالون. في البداية، كنا نسجل تلك المشاهدات على لوح بمستوى الطاقة والوقت الذي رصدت فيه. وكنا نوصل الكاشف المميّز بأسلاك لينقل تلك النبضات المصنفة إلى صمامات ثنائية باعثة للضوء، والتي كانت تُشكّل نمطا من الأضواء الوامضة على مستويات الطاقة الخمسة تلك؛ بعد ذلك، كنا نصور تلك الأضواء الوامضة بكاميرا فوتوغرافية مضبوطة على وضع التصوير التتابعي.
وفي حالة وجود إضاءة، كان ذلك سيتسبب في ظهور نمط على شريط التصوير الفوتوغرافي؛ ومن ثم، كان شريط التصوير الضوئي سيبدو كسلسلة من الاشرطة والخطوط، والخطوط والاشرطة. في ذلك الوقت في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، كنا نقرأ الفيلم بالاستعانة بقارئ خاص، صممه جورج كلارك، كان يحول الخطوط والشرطات إلى شريط مثقب؛ شريط ورقي مثقب؛ ومن ثم، كنا نقرأ الشريط المثقب باستخدام ثنائيات حساسة للضوء ونسجل البيانات على شريط مغناطيسي؛ وكنا قد كتبنا برنامج على بطاقات حاسوبية بلغة فورتران (أعلم أن ذلك يبدو من عصور ما قبل التاريخ)، فكنا نستعين به لقراءة الشريط المغناطيسي على ذاكرة الحاسب، وهو ما كان أخيرًا يعطينا حساب الأشعة السينية في صورة دالة زمنية مضروبة في مستويات الطاقة الخمسة المختلفة.
أعلم أن ذلك يشبه آلة روب جولدبيرج؛ لكن انظر لما كنا نحاول القيام به؛ لقد كنا نحاول قياس معدل العد (عدد الأشعة السينية لكل ثانية) ومستويات طاقة فوتونات الأشعة السينية، بالإضافة إلى موقع المصدر الذي تنبعث منه – الفوتونات التي تسافر لآلاف السنين الضوئية، منتشرة عبر المجرة والتي تقل باستمرار بمعدل مربع المسافة التي تسافرها وعلى عكس التلسكوبات البصرية الثابتة التي توضع على قمم الجبال، ذات أنظمة التحكم التي تجعل التلسكوب موجهًا إلى بقعة محددة لساعات طويلة، وبإمكانها العودة إلى نفس البقعة ليلة بعد أخرى؛ كان علينا أن نستغل الوقت المتاح لنا أيا كان (وكان غالبًا مرة في العام) – والتي لم تكن تقدر إلا ببضع ساعات – بينما كانت المناطيد الهشة تحمل التلسكوب الذي نستعين به والذي كان يزن طنًّا على ارتفاع 145,000 قدم فوق سطح الأرض.
أثناء تحليق البالون كنت أتتبعه بطائرة صغيرة، وعادةً ما كنت أحرص على أن يكون تحت ناظري (خلال أوقات النهار، وليس في الليل)، محلقا على ارتفاع يتراوح ما 5000 الى 10000 قدم. يمكنك تصور الحالة التي يسببها قضاء ساعات طويلة في كل مرة في هذا الوضع. ورغم أنني لست رجلًا ضعيف البنية، كان من الطبيعي جدا أن أصاب بالإعياء في تلك الطائرات الصغيرة ذات المقاعد الأربعة، محلقًا لثماني أو عشر أو اثنتي عشرة ساعة في كل مرة. أضف إلى ذلك أنني كنت أسعر بالتوتر طوال الفترة التي يكون فيها المنطاد محلقا في السماء؛ إذ لا يمكنك أن تلتقط أنفاسك مسترخيا إلا بعد حصولك على البيانات بين يديك.
كانت المناطيد هائلة الحجم لدرجة أنك تستطيع رؤيتها بوضوح وهي على 30 ميلا في السماء عند بزوغ الشمس. وكان الرادار يساعدنا على تتبعها بداية من انطلاقها من محطة الإطلاق وحتى يحول انبعاج الكرة الأرضية دون التمكن من رؤيتها. ولهذا السبب كنا نزود المنطاد بجهاز إرسال لاسلكي، وفي الليل كنا نعتمد في تتبع المنطاد على محطة إرسال لاسلكية فقط. كانت المناطيد تطير لمئات الأميال، وعندما تكون محلقة في الأعالي كنا نسمع تقارير إخبارية بكل الأشكال عن رصد أجسام طائرة مجهولة، وذلك بالرغم من الجهود التي كنا نبذلها لأجل نشر مقالات عن عملية الإطلاق في الصحف المحلية. ومع أن الأمر كان مثيرًا للضحك، إلا أنه كان معقولًا جدا. فماذا قد يعتقد الناس عدا ذلك حين يلمحون جسما غامضًا في السماء لا يمكن تحديد حجمه أو ارتفاعه بالنسبة إلى هؤلاء كان المنطاد حقًّا جسما طائرا مجهولا.
وحتى بعد كل ذلك التخطيط وتوقعات الأرصاد وحتى عند ترصد فترة انعكاس اتجاه الرياح، قد يتبين لنا أنه لا يمكننا الوثوق في سلوكيات الرياح على ارتفاع 145,000 قدم. فذات مرة ونحن في أستراليا، توقعنا أن يتجه المنطاد من آلیس سبرينجز شمالا، لكنه أقلع مباشرةً في اتجاه الجنوب فتتبعناه بنظرنا حتى غروب الشمس، ثم ظللنا على اتصال معه عبر اللاسلكي خلال ساعات الليل وببزوغ ضوء النهار، كان المنطاد قد اقترب من ملبورن، ولم يكن مسموحًا لنا دخول المجال الجوي بين سيدني وملبورن. ورغم أنه ما من أحد كان سيُسقطه، فإنه كان علينا أن نفعل شيئًا. لذلك ما إن اقترب منطادنا الجامح من الوصول إلى مجال جوي مُحرَّم أعطينا على مضض أمرًا لاسلكيا بتحرير الحمولة وكان فصل التلسكوب سيؤدي إلى تمزيق المنطاد، ذلك لأنه لم يكن ليتحمل موجة الصدمة الناتجة عن تحرير حمولته فجأة. وهكذا يبدأ التلسكوب في السقوط، ثم تنفتح المظلة المثبت بها (باستثناء ما حدث عام 1980) هابطة ببطء، معيدةً التلسكوب بأمان إلى سطح الأرض. كذلك كانت أجزاء ضخمة من المنطاد الممزق تسقط على الأرض، وعادةً ما تنتشر على مساحة فدان أو أكثر. وكان ذلك يحدث أجلا أم عاجلا في كل رحلة منطاد، ودائمًا ما تكون لحظةً مؤسفة (وإن كان لا مفر منها)، لأننا كنا ننهي المهمة بذلك، قاطعين تدفق البيانات. لقد كنا نريد أن يظل التلسكوب محلقا في الأعلى لأطول فترة ممكنة؛ فقد كنا في تلك الأيام في أشد حالات التعطش للمعلومات. تلك هي الفكرة برمتها.
 الاكثر قراءة في الكهرومغناطيسية
الاكثر قراءة في الكهرومغناطيسية
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية












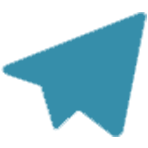
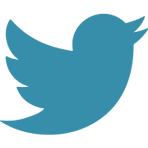

 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)