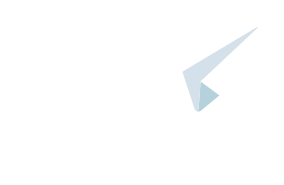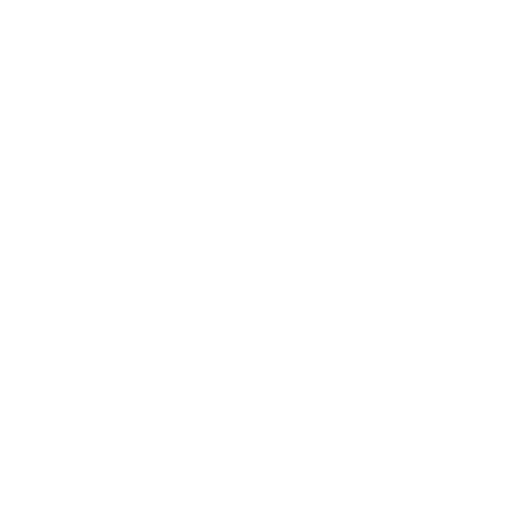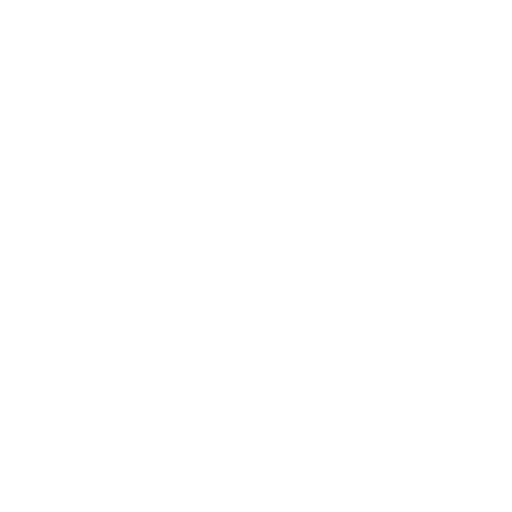النبي الأعظم محمد بن عبد الله


أسرة النبي (صلى الله عليه وآله)

آبائه

زوجاته واولاده

الولادة والنشأة

حاله قبل البعثة

حاله بعد البعثة

حاله بعد الهجرة

شهادة النبي وآخر الأيام

التراث النبوي الشريف

معجزاته

قضايا عامة


الإمام علي بن أبي طالب

الولادة والنشأة

مناقب أمير المؤمنين (عليه السّلام)


حياة الامام علي (عليه السّلام) و أحواله

حياته في زمن النبي (صلى الله عليه وآله)

حياته في عهد الخلفاء الثلاثة

بيعته و ماجرى في حكمه

أولاد الامام علي (عليه السلام) و زوجاته

شهادة أمير المؤمنين والأيام الأخيرة

التراث العلوي الشريف

قضايا عامة


السيدة فاطمة الزهراء

الولادة والنشأة

مناقبها

شهادتها والأيام الأخيرة

التراث الفاطمي الشريف

قضايا عامة


الإمام الحسن بن علي المجتبى

الولادة والنشأة

مناقب الإمام الحسن (عليه السّلام)

التراث الحسني الشريف

صلح الامام الحسن (عليه السّلام)

أولاد الامام الحسن (عليه السلام) و زوجاته

شهادة الإمام الحسن والأيام الأخيرة

قضايا عامة


الإمام الحسين بن علي الشهيد

الولادة والنشأة

مناقب الإمام الحسين (عليه السّلام)

الأحداث ما قبل عاشوراء

استشهاد الإمام الحسين (عليه السّلام) ويوم عاشوراء

الأحداث ما بعد عاشوراء

التراث الحسينيّ الشريف

قضايا عامة


الإمام علي بن الحسين السجّاد

الولادة والنشأة

مناقب الإمام السجّاد (عليه السّلام)

شهادة الإمام السجّاد (عليه السّلام)

التراث السجّاديّ الشريف

قضايا عامة


الإمام محمد بن علي الباقر

الولادة والنشأة

مناقب الإمام الباقر (عليه السلام)

شهادة الامام الباقر (عليه السلام)

التراث الباقريّ الشريف

قضايا عامة


الإمام جعفر بن محمد الصادق

الولادة والنشأة

مناقب الإمام الصادق (عليه السلام)

شهادة الإمام الصادق (عليه السلام)

التراث الصادقيّ الشريف

قضايا عامة


الإمام موسى بن جعفر الكاظم

الولادة والنشأة

مناقب الإمام الكاظم (عليه السلام)

شهادة الإمام الكاظم (عليه السلام)

التراث الكاظميّ الشريف

قضايا عامة


الإمام علي بن موسى الرّضا

الولادة والنشأة

مناقب الإمام الرضا (عليه السّلام)

موقفه السياسي وولاية العهد

شهادة الإمام الرضا والأيام الأخيرة

التراث الرضوي الشريف

قضايا عامة


الإمام محمد بن علي الجواد

الولادة والنشأة

مناقب الإمام محمد الجواد (عليه السّلام)

شهادة الإمام محمد الجواد (عليه السّلام)

التراث الجواديّ الشريف

قضايا عامة


الإمام علي بن محمد الهادي

الولادة والنشأة

مناقب الإمام علي الهادي (عليه السّلام)

شهادة الإمام علي الهادي (عليه السّلام)

التراث الهاديّ الشريف

قضايا عامة


الإمام الحسن بن علي العسكري

الولادة والنشأة

مناقب الإمام الحسن العسكري (عليه السّلام)

شهادة الإمام الحسن العسكري (عليه السّلام)

التراث العسكري الشريف

قضايا عامة


الإمام محمد بن الحسن المهدي

الولادة والنشأة

خصائصه ومناقبه


الغيبة الصغرى

السفراء الاربعة


الغيبة الكبرى

علامات الظهور

تكاليف المؤمنين في الغيبة الكبرى

مشاهدة الإمام المهدي (ع)

الدولة المهدوية

قضايا عامة
الضحّاك بن عبد الله المشرقيّ، دراسة وتحليل لموقفه في كربلاء
المؤلف:
معهد سيد الشهداء عليه السلام للمنبر الحسيني
المصدر:
نهضة عاشوراء
الجزء والصفحة:
ج1، ص201-221
16-8-2022
4215
الدراسة[1]:
﴿وَعَلَى الثّلاَثَةِ الّذِينَ خُلّفُوا حتّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنّوا أَن لاَ مَلْجَأَ مِنَ اللّهِ إلّا إِلَيْهِ ثمّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنّ اللّهَ هُوَ التّوّابُ الرّحِيمُ ﴾[2].
الصراع في مرحلتَي التنزيل والتأويل:
مرَّت هذه الدعوة- خلال مسيرتها- بمرحلتَين من الصراع: مرحلة التنزيل، ومرحلة التأويل.
الأُولى: في حياة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.
والثانية: تبدأ بخلافة أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام.
في المرحلة الأُولى كان الصراع يدور حول محوَر (التنزيل)، وكانت الجاهليّة المُتمثّلة, يوم ذاك في مشركي قريش وحُلفائها، واليهود وحُلفائهم، يتصدّون لنفي (التنزيل) وإنكار علاقة هذا الدِّين بالله تعالى، ونزول القرآن من لَدُنِ الله تعالى.
واستمرَّ هذا الصراع قائماً في حياة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كلّها، وانجلى هذا الصراع عن هزيمة قريش واليهود أمام الدعوة، وانتصارها.
ويبدو, لأوّل وَهلة, أنّ الجاهليّة انسحبت عن مواقعها الهجوميّة أمام حركة الدعوة، واستسلمت وانقادت، إلّا أنّنا عندما نُمعِن النظر في تاريخ الإسلام، نجد أنّ الجاهليّة بدأت تُخطِّط- بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم - للالتفاف على هذه الدعوة، وتحريفها والدَسّ فيها، وتشويه مفاهيمها.
وأحسَّ وَرَثة الثورة بهذه المؤامرة الجديدة، وعرفوا قادة المؤامرة، وبدأت المرحلة الثانية من الصراع حول محوَر (التأويل)، وأبرز المعارك في هذه المرحلة من الصراع: (صِفِّين) و (الطَفّ( والذي يُنعِم النظر في التأريخ الإسلامي، يجد أنّ (صفّين) و (الطفّ) امتداد لـ (بدر) و (أُحد)، وأنّ الذين حاربوا عليّاً والحسن والحسين عليهم السلام ، في صفّين والطفّ، هم الّذين قاتلوا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من قبل، في بدر وأُحد.
ورحم الله عمّار بن ياسر، فقد كان يقول في صفّين، لبعض مَن أنكر عليه محاربة معاوية وعمرو بن العاص: هل تعرف صاحب الراية السوداء المقابلة لي؟! فإنّها راية عمرو بن العاص، قاتلتُها مع رسول الله ثلاث مرّات، وهذه الرابعة، ما هي بخيرِهنّ ولا أبرَّهنّ، بل هي شَرّهنّ وأفجرهُنَّ.
وقال لمَن تردَّد يومئذٍ في قتال معاوية مع الإمام عليّ عليه السلام: أشهدتَ بدراً وأُحداً وحُنيناً، أو شهدها لك أب فيُخبرَك عنها؟ قال: لا. قال: فإنّ مراكزنا على مراكز رايات رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ، يوم بدر ويوم أُحد ويوم حُنَين، وإنّ هؤلاء على مراكز رايات المشركين من الأحزاب.
هل ترى هذا المعسكر ومَن فيه؟! فوالله لوَددتُ أنّ جميع مَن أقبل مع معاوية, ممَّن يرى قتالنا مُفارقاً للّذي نحن عليه، كانوا خَلقاً واحداً فقطّعتُه وذبحتُه، والله لَدماؤهم جميعاً أحلّ من دم عصفور، أفترى دم عصفور حراماً؟![3]
شريحة المُتخلِّفين عن الصراع
وفي كلّ صراع ثلاثة أطراف: الطرفان المتصارعان، والطرف المُتفرِّج المُتخلِّف، والطرف الثالث أكثر تعقيداً من الطرفين الآخَرَين المُتقاتلَين في ساحة الصرْع والقتال, وفَهْم هذا الطرف (المُتفرّج) على الساحة أشقّ من فَهمِ الطرفين الآخرَين.
وقد أعطى القرآن الكريم اهتماماً كبيراً بتحليل هذا الطرف بالذات، والآية المباركة الّتي صَدَّرنا بها الحديث- من سورة التوبة المباركة- واحدة من الآيات القرآنيّة، في استعراض وتحليل هذه الشريحة المُتخلّفة من المجتمع الإسلامي, يوم ذاك.
ونحن, في هذه الدراسة, نحاول أن نستعرض نموذجاً من المُتخلّفين عن ثورة الحسين عليه السلام, (و) ندرس ونُحلِّل مواقفهم.
ولا يكاد يختلف المتخلّفون عن معركة (الطفّ) عن المتخلّفين عن معركة (حُنين) في عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ، إلّا أنّ حُنين تدور حول محور (التنزيل) والطفّ تدور حول محور (التأويل).
والصراع هو الصراع، ليس على أرض ولا على مال، وإنّما هو صراع حضاري حول الإسلام والجاهليّة.
وتعود الجاهليّة هذه المرَّة- بعد أن انكسرت شوكتها في بدر، وأُحد، والأحزاب، وحُنين من داخل صفوف المسلمين- لتُعاود الصراع مع الإسلام، بتحريف الإسلام عن مسيره الصحيح، وتشويه مفاهيمه وأفكاره وأُصوله، والدسّ فيه.
والصراع هذه المرّة, كأيِّ صراع حضاريّ، يحمل نفس الضراوة والعُنف، ولا يقبل الهدنة ولا الصلح.
ولمّا كان الصراع في الطفّ نفس الصراع في حُنين، فإنّ المُتخلّفين هنا هم من شريحة المُتخلّفين هناك، والمواقف نفس المواقف، والقوانين والسُنَن في هؤلاء وأُولئك نفسها, ولنتأمّل في نموذج مِن هؤلاء المُتخلّفين عن الحسين عليه السلام.
خبر الضحّاك بن عبد الله المشرقيّ:
وهذا نموذج من المُتخلّفين عن الحسين عليه السلام ، وقصّته معروفة في كُتبِ السيرة.
رافق الإمام الحسين عليه السلام إلى ساحة المعركة، ودخل المعركة معه، وقاتل قِتال الأبطال وأبلى بلاءً حسناً في القتال, استحسَنَــه الإمـــام, ولكنّــه اشترط على الإمام عليه السلام - منذ أن التحق به- أن يجعله في حلٍّ منه، إذا دارت دائرة الحرب عليه ولم يعد ينفعه قتاله ودفاعه عنه.
فلمّا رأى أنّ المعركة قد دارت على الحسين عليه السلام ، ووجد أنّ الحسين وأهل بيته وأصحابه عليهم السلام لا مَحالَة مقتولون، ولم يعد ينفع الحسين قتاله ودفاعه، استأذن الحسين عليه السلام أن يترك ساحة القتال وينجو بنفسه، فأذنَ له الحسين كما وعَدَه من قبْل، فهرب الضحّاك بن عبد الله المشرقيّ بنفسه من ساحة المعركة، وترك الإمام ومَن معه من أهل بيته وأصحابه للقتْل في ساحة المعركة، ونَجا بنفسه.
فلنقرأ أوّلاً خبر الضحّاك بن عبد الله المشرقيّ, برواية الطبريّ من أبي مَخنَف, ثمّ نحاول أن نُحلِّل هذا الخبر.
روى أبو مَخنَف عن الضحّاك بن عبد الله المشرقيّ، قال: قدمتُ ومالك بن النضر الأرحبيّ على الحسين، ثمّ جلسنا إليه، فردّ علينا فرحّب بنا، وسألَنا عمّا جئنا له. فقلنا: جئنا لنُسلّم عليك، وندعو الله لك بالعافية، ونُحدِث بك عهداً، ونُخبرك خبر الناس. وإنّا نُحدِّثك أنّهم قد أجمعوا على حربك، فَرِ رأيك. فقال الحسين عليه السلام: حَسبــي الله ونِعــــم الوكيل. قال: فتَذمَّمنا, وسلَّمنا عليه، ودعونا الله له.
قال: فما يَمنعُكما من نُصرتي؟
فقال مالك بن النضر: عليّ دَين ولِي عِيال، فقلتُ له: إنّ عليّ دَيناً وإنّ ليَ لَعيالاً، ولكنّك إن جَعلتَني في حلٍّ من الانصراف إذا لم أجد مقاتلاً، قاتلتُ عنك ما كان لك نافعاً وعنك دافعاً, قال: فأنت في حلّ.[4]
قال أبو مَخنَف: حدَّثني عبد الله بن عاصم عن الضحّاك بن عبد الله المشرقيّ، قال: لمّا رأيتُ أصحاب الحسين قد أُصيبوا وقد خلُصَ إليه وإلى أهل بيته، ولم يبقَ معه غير سويد بن عمرو بن أبي المُطاع الخثعميّ، وبشير بن عمرو الحضرميّ, قلت له: يا بن رسول الله، قد علمت ما كان بيني وبينك: قلت لك: أُقاتل عنك ما رأيت مقاتلاً، فإذا لم أرَ مقاتلاً فأنا في حلٍّ من الانصراف، فقلت لي: نعم؟! فقال: صدقتَ، وكيف لك بالنجاة؟ إن قدرت على ذلك فأنت في حلّ. قال: فأقبلت إلى فرَسي، وقد كنت حيث رأيت خيل أصحابنا تُعقَر، أقبلت بها حتّى أدخلتها فسطاطاً لأصحابنا بين البيوت، وأقبلت أُقاتل معهم راجلاً، فقتلتُ يومئذٍ بين يدي الحسين رجُلَين وقطعتُ يد آخر. وقال لي الحسين يومئذٍ مراراً: لا تشلل، لا يقطع الله يدك، جزاك الله خيراً عن أهل بيت نبيّك صلى الله عليه واله وسلم. فلمّا أذن لي، استخرجت الفرَس من الفُسطاط ثمّ استوَيت على متنها ثمّ ضربتها، حتّى إذا قامت على السنابك رميتُ بها عَرض القوم، فأفرجوا لي، وأتبعني منهم خمسة عشر رجُلاً، حتّى انتهيت إلى (شفيّة)- قرية قريبة من شاطئ الفرات- فلمّا لحقوني عطفت عليهم، فعَرفني كثير بن عبد الله الشعبيّ، وأيّوب بن مشرح الخيوانيّ، وقيس بن عبد الله الصائديّ، فقالوا: هذا الضحّاك بن عبد الله المشرقيّ، هذا ابن عمّنا، ننشدكم الله لمّا كَفَفتم عنـه. فقال ثلاثة نفَر من بني تميم كانوا معهم: بلى، والله لنُجيبنّ إخواننا وأهل دعوتنا إلى ما أحبّوا من الكفّ عن صاحبهم. قال: فلمّا تابع التميميّون أصحابي، كفَّ الآخرون. قال: فنَجّاني الله.[5]
وقال السماويّ في (إبصار العين): بقيَ الضحّاك بن عبد الله المشرقيّ مع الحسين عليه السلام ، حتّى إذا أمر ابن سعد بالرُماة فرموا أصحاب الحسين، وعقروا خيولهم، أخفى فَرَسه في فُسطاط، ثمّ نظر فإذا لم يبقَ مع الحسين إلّا سويد بن عمر، وبشر بن عمرو الحضرميّ، فاستأذن الحسين، فقال له: كيف لك النجاة؟ قال: إنّ فرَسي قد أخفيتُه فلم يُصَب، فأركبُه وأنجو، فقال له: شأنك, فركب ونجا بَعْد لأيٍ.[6]
تأمّلات في خبَر الضحّاك
أقبل الضحّاك بن عبد الله المشرقيّ، ومالـــك بـــن النضــر الأرحبيّ على الحسين عليه السلام, ليُسلّما عليه وليُجدِّدا به العهد- كما في رواية أبي مَخنَف- ويظهر أنّ هذا اللقاء تمّ في موقع كربلاء (الطف)، بعدما استقرّ الحسين عليه السلام بأهله وأصحابه فيه، ولم يكن في الطريق, وقبل أن يُحاصَر الحسين عليه السلام, فقد استأذن مالك بن النضر الأرحبيّ الحسين عليه السلام في الانصراف، وانصرف من دون أن يواجه مشكلة من قِبل الجيش الأُمَويّ.
ويظهر من الرواية أنّهما كانا عارفَين بموقع الحسين عليه السلام ، وحَقّه وذمّته وحُرمته في الإسلام، وموقعه من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.
ففي رواية أبي مَخنَف: فتذمّمنا، وسلّمنا عليه، ودعونا الله له.
والتذمّم بمعنى: حفظ الذمام، وحفظ العهد والحَقّ والحُرمة، كما في المُدوَّنات اللُغويّة.
إذاً، فهما قد عظما وأكبرا ما على ذمّتهما من حقّ الحسين وحُرمته وعهده، فلمّا أرادا الانصراف، استوقفهما الحسين عليه السلام وقال لهما: فما يمنعكما من نُصرتي؟.
ويَلفِت نظرنا أنّ الإمام يسألهما عمّا يمنعهما من نُصرته، قبل أن يسألهما النصرة ويدعوهما إليها.
وكأنّ في خروج الحسين عليه السلام على يزيد- بتلك العصابة القليلة- إلى العراق ما يُغني عن الدعوة والاستنصار، فلا حاجة مع ذلك, إلى أن يستنصر أحداً أو يدعوه, ففي خروج الحسين عليه السلام إلى العراق دعوة واستنصار لكلّ المسلمين، وللحسين عليه السلام حَقّ وحُرمة على ذمّة كلّ المسلمين.
إذاً، يسأل الضحّاكَ وصاحبَه: فما يمنعكما من نُصرتي؟.
أمّا مالك بن النضر الأرحبيّ، فقد أراح نفسه وأراحنا بوضوحه وصراحته في الاعتذار عن الاستجابة للحُسين والتخلّف عنه، فقال: عليّ دَين ولِيَ عيال, فأعرَض عنه الحسين عليه السلام ، وانصرف هو لشأنه، فقد أقبلت السعادة والتوفيق عليه فأعرضَ عنهما.
وأمّا الضحّاك بن عبد الله المشرقيّ، فأجاب الحسين عليه السلام بجوابٍ مُعقَّد، شديد الالتواء والتعقيد، فلا هو رفضَ دعوة الحسين وأعرَض عنها، كما رفضَها صاحبُه وأعرضَ عنه، ولا هو استجاب للحسين عليه السلام وقبِل عنه، كما استجاب له أهل بيته وأصحابه.
ولنتأمّل في جواب الضحّاك، فإنّه يُمثِّل شريحة واسعة من النفوس والمواقف إزاء "الدعوة".
وإنّنا ندرس, من خلال الضحّاك بن عبد الله في موقع الطفّ، ومن خلال المُتخلّفين في موقع حُنين، شريحة كبيرة في التاريخ الإسلامي، وشريحة كبيرة في تأريخنا المعاصر، ونحاول أن نرسم أبعاد هذه الشريحة في حياتنا المعاصرة، ونُشخِّص نقاط الضعف في شخصيَّتها، عسى أن نقوِّم من سلوكها ما يمكن تقويمه.
وسوف نجعل جواب الضحّاك للحسين عليه السلام في موضع التأمّل والدراسة، ضمن مجموعة من النقاط:
النقطة الأُولى الاعتذار
قدّم الضحّاك أوّل ما قدّم الاعتذار للإمام عليه السلام ، بما عليه من ديون ومال، شأنه في ذلك شأن صاحبه، فقال: إنّ عليّ دَيناً، وإنّ لي لَعيالاً.
وأوّل ما يَلفِت نظرنا في هذا الجواب: أنّ الضحّاك ومالك بن النضر لم يختلفا في الجواب، فكلّ منهما اعتذر عن تلبية دعوة الحسين عليه السلام بالعيال والدَين، غير أنّ الضحّاك استجاب لدعوة الحسين، استجابةً محدودة ومُقيَّدة ومشروطة، بعد أن اعتذر أوّلاً، وأمّا صاحبه الأرحبيّ، فلم يَستجب مُطلَقاً لدعوته.
وفي هذا الاعتذار والاستجابة المشروطة، من التعقيد ما ليس في موقف صاحبه، وقد كان أحرى به أن يستجيب استجابة محدودة ثمّ يعتذر. فلماذا قدّم الاعتذار على الاستجابة؟ إنّ في الأمر لسرّاً كامناً في أعماق نفس الضحّاك، فعندما طلب الحسين عليه السلام منه النصرة، تزاحمت في نفسه حالة الشُحّ وحالة الإنفاق، فغلبت حالة الشحّ حالة الإنفاق، وسبقتها إلى البروز، ولكن لم تُصادِر الحالة الأُخرى تماماً، كما كان في موقف مالك بن النضر الأرحبيّ.
ولنتأمّل إذاً في اعتذار الضحّاك بعياله وديونه:
إنّ الابتلاء بالدَين والعيال من سُنَن الله في حياة الإنسان، وقلّما يشذّ عنه إنسان, شأنهما في ذلك شأن غيرهما من سُنَن الله تعالى في حياة الإنسان.
فلا بدّ للإنسان من عيال، ولابدّ أن يدخل مع الناس في بيع وشراء، فيكون دائناً ومَديناً، يطلب الناس ويطلبونه.
وجها الحياة الدنيا:
والدَين والعيال هما وجهان مُختلفان للدنيا، فالعيال تعبير عن تعلّق الإنسان بالدنيا، وهو أحد وجهَي الدنيا، وهو ما يُسمّيه القرآن الكريم بـ (الشهَوات)، وتجمع هذه الآية الكريمة طائفة من هذه التعلّقات:
﴿ زُيّنَ لِلنّاسِ حُبّ الشّهَوَاتِ مِنَ النّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذّهَبِ وَالْفِضّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدّنْيَا وَاللّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ﴾[7].
والدَين هو الوجه الآخر للدنيا، وهو وجه التَبعات والمسؤوليّات.
والدنيا هي عبارة عن تعلّقات وتَبعات، ومن أجل لذّة التعلّقات يتحمّل الإنسان مرارة التَبعات، ولابدّ لكلّ إنسان من هذه التعلّقات ومن هذه التبعات، ولا يشذّ عن هذه السُنّة الإلهيّة في الحياة إلّا القليل.
وهذه (التعلّقات) و (التَبعات) بمجموعها، هي العوائق في طريق الإنسان وحركته إلى الله تعالى، تُعيق الإنسان عن الله سبحانه، وقد أعاقتا- في هذه القضيّة- مالك بن النضر الأرحبيّ، إعاقة كاملة، وأعاقتا الضحّاك بن عبد الله المشرقيّ إعاقة ناقصة.
فكيف نتعامل نحن, في الدنيا, مع هذه العوائق؟ وما هو موقف الإسلام منها؟
إنّ الحلّ الذي يُعطيه الإسلام للتعامل مع هذه العوائق (التعلّقات والتَبعات) دقيق في غاية الدقّة، وأكثر الّذين شَطّوا في فهْمِ الحلّ الإسلامي لمسألة الدنيا بوجهيها، كانوا ضحيّة عدم الدقّة في تناول هذا الحلّ بأبعاده الكاملة.
فليس في الإسلام أن يتخلّى الإنسان عن عيال أو دَين، أو حتّى أن يتخفّف عنهما، والتخلّي أو التخفّف من العيال والمال من الرهبانيّة الّتي يرفضها الإسلام.
وقد كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يعيش مع الناس، ويتزوّج ويتعامل مع الدنيا, كما يتعامل غيره. وكان له عيال وعليه ديون وتبِعات, كما كان لغيره، وكان له بيت يضمّ عياله، وكان يدخل السوق في حاجاته وشؤونه, كما كان الآخرون يعملون.
وقِوام الحلّ الإسلامي هو: أن يتحرَّر الإنسان من أسرِ العيال والمال، وليس أن يتخلّى أو يتخفّف منهما، وبين الأمرين بَوْن بعيد؛ فليس من الإسلام أن يتخلّى الإنسان أو يتخفّف من عياله وماله، ولكن من صلبِ الإسلام وتعليماته وتوجيهاته أن يتحرَّر الإنسان من سلطان عياله وماله.
فلا يرفض الإسلام البيت أو السوق في حياة الإنسان، ولا يأمره أن يعتزل هذا أو ذاك، ولكن يرفض أن يتحوَّل البيت أو السوق إلى سجن في حياة الإنسان، يقيِّدان حركته ويمنعانه عن الانطلاق، ويحجزانه ويُعيقانه عن الله تعالى.
وبشكل أوضح وتعبير أدقّ، إنّ الإسلام يرفض أن يتحولّ العيال والمال في حياة الإنسان إلى عوائق، تعيق حركة الإنسان، كما أعاقت حركة مالك بن النضر الأرحبيّ، والضحّاك بن عبد الله المشرقيّ.
كيف تتحوّل العوائق إلى مُنطلَقات؟:
ومن عجَبٍ أنّ الطريقة الإسلاميّة الصحيحة للتعامل مع وجهي الحياة الدنيا، تحوُّل هذين الوجهين من الدنيا (التبِعات والتعلّقات) من عوائق إلى مُنطلَقات، فتكون الدنيا للإنسان مُنطلَقاً إلى الله سبحانه وليست عائقاً، ويكون ماله وعياله مادّة لحركته إلى الله تعالى، ومُنطلَقاً لعروجه إليه عزّ وجلّ.
وإلى هذه الحقيقة يُشير الإمام عليّ أمير المؤمنين عليه السلام في كلمته، وقد سمع رجلاً يذمّ الدنيا، فقال له في ما قال:
(إنّ الدنيا دار صدقٍ لِمَن صَدَقها، ودار عافية لمَن فَهِمَ عنها، ودار غِنى لمَن تزوَّد منها، ودار موعظة لمَن اتّعظَ بها، مسجد أحبّاء الله، ومُصلّى ملائكة الله، ومَهبط وحي الله، ومَتجر أولياء الله، اكتسبوا فيها الرحمة، وربحوا فيها الجنّة، فمَن ذا يذمُّها، وقد آذنت بِبَينِها [8]، ونادت بفِراقها، ونعَتْ نفسها وأهلها، فمثَّلت لهم ببلائها البلاء، وشوَّقتهم بسرورها إلى السرور، راحت بعافية، وابتَكَرَت[9] بفجيعةٍ ترغيباً وترهيباً، وتخويفاً وتحذيراً، فذمَّها رجال غَدَاةَ الندامة، وحمدها آخرون يوم القيامة، ذكَّرتهُم الدنيا فتذكّروا، وحدَّثتهم فصدَّقوا، ووَعظتهُم فاتّعظوا[10].
ويقول عليه السلام في كلمة أُخرى: الدنيا دار مَمَرٍّ، لا دار مَقرٍّ، والناس فيها رَجُلان، رجلٌ باع نفسه فأوبَقَها، ورجلٌ ابتاعَ نفسه فأعتَقَها[11].
مقارنة بين زُهير بن القَين رحمه الله والضحّاك
ولقد كان زهير بن القين, رحمه الله, يملك من المال والعيال ما كان يملكه الضحّاك ابن عبد الله، وكان يعيش في دنياه كما كان يعيش الضحّاك في دنياه، بل قد يكون حظّ زهير من الدنيا أعظم من حظِّ الضحّاك, فقد كان زهير بن القين, رحمه الله, زعيماً في قومه، وجيهاً في بَلَدِه، ولم يحفل المؤرِّخون بأمر الضحّاك وصاحبه في شأنٍ من شؤون الدنيا، وكان الضحّاك أقرب إلى الحسين عليه السلام ، وأكثر مَيلاً إليه من زهير، فقد كان زهير, رحمه الله, عُثمانيّ الهوى، كما يذكر أصحاب السِيَر، وكان يحرص ألّا يلتقي الحسين عليه السلام بمنزلٍ في طريقه إلى العراق، فإذا وجد الحسين قد نزل منزلاً فيه ماء، نزل غيره. وأمّا الضحّاك وصاحبه مالك بن النضير، فقد قصدا الحسين في كربلاء، وجلسا إليه ودَعوا له, ولم يكن يحدث شيء من ذلك لو لم يكن الضحّاك ومالك بن النضر من شيعة الحسين عليه السلام ، وممَّن تميل إليه قلوبهم. ومع ذلك كلّه, فإنّ (العيال والمال) قد أعاقاهما عن الالتحاق به بشكلٍ كامل، أو بشكلٍ ناقص.
وأمّا زهير بن القَين, رحمه الله، فقد رجع من عند الحسين عليه السلام ، ولم يستغرق اجتماعه بالإمام في أغلب الظنِّ بِضْع دقائق، وقد أعدّ نفسه للوفود على الله مع الحسين، والانصراف الكامل عن الدنيا، فأقبل إلى زوجته (دَلْهم) بنت عمرو, رحمها الله, وقال لها بقوّة وعزم، وفي نفس الوقت بسهولة وراحة: (الحقي بأهلك، فانّي لا أُحبّ أن يُصيبك بسببي إلّا خيرٌ، ثمّ قال لمن معه: (مَن أحبَّ منكم نصرة ابن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ، وإلّا فهو آخر العهد)[12]، ولم يَعقه عن ذلك مال ولا عيال.
وقد كانت زوجته (دلْهم), رحمها الله, هي الّتي دفعته وشجَّعته على الاستجابة لدعوة الحسين عليه السلام ، فقد أصابه وأصاب رِفاقه ذُعر غريب عندما جاء رسول الحسين عليه السلام ، وهو على الطعام, يدعوه إلى زيارة الإمام، فصمتَ وصمتوا، وكأنّ على رؤوسهِم الطير.
فاخترقت المرأة المؤمنة الشجاعة (دلهم بنت عمرو), رحمها الله, هذا الصمت والذعر بقوّة, وقالت لزوجها- ورسول الحسين عليه السلام يسمعها ويشهد الموقف-: (سبحان الله, أيبعث إليك ابن بنت رسول الله ثمّ لا تأتيه، لو أتيته فسمعت كلامه؟!!)[13].
ومع ذلك، فلم يَتَوان زهيـــر- عنــــدما قرَّر الوفــــود علـــى الله تعـــالى مع الحسين عليه السلام - أن يقول لزوجته دلهم, هذه المرأة الشجاعة: (إلْحقي بأهلك).
إذاً، ليست المسألة مسألة المال والعيال، وإنّما المسألة في أمر آخر، في طريقة التعامل مع المال والعيال.
والفرْق بين الضحّاك وزهير, رحمه الله,لم يكن في أنّ الأوّل كان يملك من المال والعيال ما لا يملكه الثاني، وإنّما كان في طريقة تعاملهما مع المال والعيال. فقد كان الضحّاك وصاحبه الأرحبيّ أسيرَين للمال والعيال، فأعاقاهما عن الانطلاق مع الحسين، وكان زهير بن القَين مُتحرِّراً من أَسرِ المال والعيال، فلم يُعيقاه عن الحركة مع الحسين عليه السلام للوفود على الله.
النقطة الثانية: (الاستجابة المَشروطة):
والنقطة الثانيـــة في جـــواب الضـــحّاك أنّه لــم يرفض القتال إلى جانب الحسين عليه السلام, ولم يعتذر بصورة مُطلَقـة, كما اعتذر صاحبه مالك بن النضر، بل قاتل مع الحسين، وضربَ الأعداء بين يديه، ودعا له الحسين عليه السلام.
وهذه نقطة أُخرى مُشرِقة في موقف الضحّاك من الحسين، فهو ليس من الذين وصفَهم الفرزدق الشاعر بقوله: (قلوبهم معك وسيوفهم عليك)، وإنّما كان قلبه وسيفه مع الإمام الحسين، وهو صـــادق في هذا وذاك، إلّا أنّه لم يعط سيفه للحسين عليه السلام ، ولم يضع سيفه تحت أمر الحسين عليه السلام إلّا بمقدار، وحدَّد لذلك شَرطَين: (إذا لم أجد مُقاتلاً، قاتلت عنك ما كان لك نافعاً وعنك دافعاً، وهذا شرط غريب!
إنّ الضحّاك يحصر نصرته للحسين عليه السلام بين شرطَين:
1- أن يكون الحسين عليه السلام بحاجة إليه، ولا يُغني عنه غيره.
2- وأن يكون قتاله دون الحسين عليه السلام نافعاً له، فإن لم يكن هذا أو لم يكن ذلك، فإنّ الضحّاك في حلِّ من أمره.
ونحن لا يُعجبنا أنّ نشكِّك في صِدق نيّة الضحّاك في موقفه من الإمام، رَغمَ فراره من الزحف, في اللحظات الأخيرة، وتركه الإمام عليه السلام في أحرجِ اللحظات، وإيثاره للعافية، فإنّ لدينا- مع كلّ ذلك- من الشواهد ما يكفي لإثبات حُسن نيّة الضحّاك، وصِدقه في الوقوف إلى جنبِ الإمام والدفاع عنه، إلّا أنّنا نجد عنده إحساساً محدوداً بالمسؤوليّة تجاه الموقف، وتَقتِيراً شديداً في العطاء في إطارِ هذه المسؤوليّة، ومحاولة جادّة في إخضاع الإنفاق في سبيل الله لمُعادَلات دقيقة شديدة التعقيد.
فهو يُعطي من نفسه لله تعالى، ولكنّه عطاء مشروط ومحدود وبحساب، وضمن تقديرات دقيقة، وليس كما يقول الله تعالى: ﴿إِنّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنّ لَهُمُ الجنّة﴾[14].
والدقّة في المحاسبة، والمحاسبة الدقيقة أمرٌ جيّد، لا نشكّ في حُسنه وفائدته، ولكن عندما يكون طرف المحاسبة هو نفس الإنسان، وقد ورد في الحديث: (حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسَبوا), وأمّا عندما يكون طرف الحساب هو الله تعالى، فإنّ المحاسبة بهذه الدقّة, وضمن هذه الشروط والقيود, أمر قبيح مع الله سبحانه.
والضحّاك هنا يتعامل مع الله تعالى، وإن كان طرف التعامل, في ظاهر الأمر, هو الحسين عليه السلام.
ولا يطلب الحسين عليه السلام أمثال الضحّاك في حركته هذه، وإنّما يطلب لنصرته أُولئك الّذين يبذلون كلّ ما عندهم من الأنفُس والأموال لله تعالى، من دون حساب وشروط وحدود وقيود, فقد خطب عليه السلام في الناس لمّا أراد الخروج من مكّة إلى العراق وقال:(ألا ومَن كان فينا باذلاً مُهجته، موطِّناً على لقاء الله نفسه، فليرحل معنا، فإنّي راحل مصبحـاً إن شـاء الله)[15].
ولا شكّ أنّ هذا العطاء الشحيح خير من النضوب, على كلّ حال، ولكن أصحاب هذه العطاء المحدود لا يستطيعون أن يُسايروا الحسين عليه السلام في مثل هذه المرحلة.
وأعتقد أنّ عبارة (لم يوافق) في هذا الموضوع تساوي عبارة (لم يستطع), فإنّ الضحّاك (لم يوافق) أن يُقاتِل من دون الحسين بلا حدود وقيود، وبنفس الملاك (لم يستطع) أن يُساير الحسين إلى الشوط الأخير من رحلته.
العلاقة بين العمل والجزاء:
إنّ العمل والجزاء نوعان من العطاء, العمل: ما يقدّمه الإنسان لله تعالى: ﴿ فإِنَّ اللّهَ غَنِيّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾[16] ، والجزاء: عطاء الله للإنسان في مقابل عمله. العمل من الإنسان, والجزاء من الله سبحانه، وبين الجزاء والعمل صِلة وعلاقة يستعرضها القرآن الكريم بدقّة وتفصيل، ولسنا الآن بصدَدها، وإنّما نحن بصدَد اختلاف الجزاء من عند الله باختلاف العمل من جانب الإنسان, من حيث الحساب واللاحساب، وهي مسألة جديرة بالاهتمام وموضع الشاهد في حديثنا هذا، فإنّ عطاء الإنسان محدود على كلّ حال، إلّا أنّه قد يُعطى لله تعالى بحساب ومقدار، وقد يعطى من دون حساب وتقدير.
وهاتان طائفتان من الناس:
طائفة تعطي لله بحساب وتقدير، كالضحّاك بن عبد الله المشرقيّ، يعطي لله شيئاً ويحتفظ لنفسه بشيء، وإذا تواردت على شيء إرادة الله تعالى وهواه، قدّمَ هواه على إرادة الله سبحانه.
وطائفة أُخرى تعطي لله ما آتاها الله تعالى، من غير حساب ولا تقدير، وهؤلاء هم الّذين تقول عنهم الآية الكريمة: ﴿إِنّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنّ لَهُمُ الجنّة﴾[17].
هؤلاء اشترى منهم الله أنفسهم، وباعوها لله تعالى، وقطعوا علاقتهم بأنفسهم، فهي لله عزّ وجلّ، اشتراها منهم، ولا شأن لهم بها بعد، يصنع بها ما يشاء، والثمن مقبوض ﴿بأنّ لهم الجنّة﴾.
فقد تمّ البيع وتمّ الشراء، وتمّ استلام الثمن، فلا يملك المؤمن من نفسه وماله إذاً شيئاً, ليملك التقدير والحساب في عطائه وبَذلِه، فهي كلّها لله تعالى، يأخذ منها ما يشاء ويدع منها ما يشاء، والله تعالى يجزي هؤلاء وأُولئك على نحوين من الجزاء: جزاء محسوب ومحدود، وجزاء من غير حساب، وها نحن نشرح تفصيل هذا الأمر:
إنّ الأجْر الذي يعطيه الله لعباده في مقابل أعمالهم كريم وعظيم، وكبير وحسن وغير ممنون، وهذه خمسة أوصاف للأجر الذي يرزق الله عباده على حسناتِهم.
1- فهو أجْر كريم: ﴿مَن ذَا الّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾.[18]
2- وهو أجر عظيم: ﴿لِلّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾, ﴿وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾.[19]
3- وهو أجر كبير: ﴿وَالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ لَهُم مّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾[20]، ﴿فَالّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ﴾[21].
4- وهو أجر حسَن: ﴿فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللّهُ أَجْراً حَسَناً﴾[22].
5- وهو أجر غير ممنون: ﴿وَإِنّ لَكَ لأَجْراً غَيْرَ مَمْنُونٍ﴾ [23]،﴿إلّا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ فلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾[24].
وهذه الأوصاف الخمسة عامّة شاملة لكلّ أجْرٍ يرزقه الله عباده، ممَّن يعطي لله بلا حساب أو بحساب. إلّا أنّ الذين يعطون لله تعالى من دون حساب وتقدير، يُحاسبهم الله في السيّئات حساباً يسيراً: ﴿فَأَمّا مَنْ أُوتِىَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ - فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً﴾[25].
هذا في حساب السيّئات، أمّا في الحسنات، فإنّ لله تعالى نوعين من الأجر: أجراً محدوداً وبحساب، وأجراً غير محدود, ومن دون حساب.
والأوّل منهما للّذين يعطون لله تعالى بحساب وتقدير، والثاني منهما للّذين يعطون لله تعالى من أموالهم وأنفسهم بلا حساب وتقدير.
وليس معنى الحساب والتقدير, من جانب الله, المساواة بين العمل والجزاء، في الحجم والكَم، وإنّما معناه: وجود التناسب بين العمل والأجر.
وأمّا عندما يكون عطاء العبد لله من دون حساب، فإنّ جزاء الله تعالى له يكون من غير حساب وتقدير. يقول سبحانه: ﴿إِنّمَا يُوَفّى الصّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾[26].
وتستوقفنا هذه الآية المباركة من سورة النور طويلاً في شأن الجزاء، عندما يكون العمل من جانب الإنسان من غير حساب: ﴿رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَإِقَامِ الصّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ - لِيَجْزِيَهُمُ اللّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزيدَهُم مِن فَضْلِهِ وَاللّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾[27].
وهذه ثلاث خصائص للجزاء الإلهيّ:
الخاصيّة الأُولى: ﴿لِيَجْزِيَهُمُ اللّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا﴾, فالجزاء من عند الله ليس بأسوأ ما يعمل العبد، ولا بمتوسّط ما يعمل العبد، وإنّما بأحسن ما يعمله.
ولابدّ من توضيحٍ لهذه الفقرة من الآية الكريمة
فإنّ للناس في الجزاء طريقين معروفين:الجزاء بأسوَأ ما يعمل الطرف الآخر. فقد يُحسِن الإنسان إلى صاحبه عُمْراً طويلاً، ثمّ يُسيء إليه مرّة واحدة، فيجعل صاحبه هذه الإساءة ميزاناً لعلاقته به، وينسى كلّ ما سبق له من فضل وإحسان إليه، وهذا هو الجزاء بالأسوأ.
وقد يكون الجزاء في ما بين الناس بأوسط ما يفعلون. كما يُقدِّر المُدرِّسون درجات طلاّبِهم بأوسط إجاباتهم في الامتحانات، وهو الحساب بالمُعدَّلات.
والله تعالى لا يجزي عباده بأسوأ ما يعملون، ولا يجزيهم بأوسط ما يعملون، وإنّما يجزيهم بأحسن ما عملوا، وله الحمد ربّ العالمين.
والخاصيّة الثانية للجزاء, في هذه الآية المباركة هي: ﴿وَيَزيدَهُم مِن فَضْلِهِ﴾. ولا علاقة لهذا بأعمالهم إطلاقاً، فهو تعالى يزيدهم في الجزاء من فضله بما يشاء وكيفما يشاء.
والخاصيّة الثالثة: ﴿وَاللّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾. وهذا أعظم ما في هذه الآية, فإنّ رزق الله تعالى لعباده يوم القيامة, في مقابل حسناتهم, رزق من غير حساب ولا تقدير، فإنّ العبد لو كان يعطي لربِّه ممّا آتاه من غير حدود ولا حساب، فإنّ الله تعالى أولى بأن يعطي عبده, يوم القيامة, من غير حدود ولا حساب.
النقطة الثالثة: (التَحلّل من الالتزام):
بعد أن يعتذر الضحّاك إلى الحسين عليه السلام بديونه وعياله، يطلب من الإمام أن يجعله في حلٍّ من الانصراف إذا شاء، فيقول: (ولكنّك إن جعلتَني في حلٍّ من الانصراف، إذا لم أجد مقاتلاً قاتلتُ عنك). والحلّ في مقابل الالتزام، ولا يمكن أن يرتبط الإنسان بالتزامين مُتعاكسَين في وقت واحد، فإذا كان الضحّاك مُلتزِماً تجاه ديونه وعياله، فمن الطبيعي أنّه لا يستطيع أن يكون مُلتزِماً تجاه الإمام، ولابدّ من أن يتحــرَّر من أحد الالتزامَين، وقد آثر أن يتحرَّر من التزامه تِجاه الحسين عليه السلام ، دون التزامه تجاه ديونه وعياله، والالتزام تجاه الحسين هو الالتزام تجاه الدعوة والجهاد.
(التزام) و (حِلّ):
والضحّاك يكشف لنا, هنا, عن موقف غريب، في سلوكه وتعامله مع عياله وماله من طرف، ومع الله تعالى من طرفٍ آخر.
ولابدّ من أن نكشف في هذه الوقفة هذا الموقف, لتكتمل عندنا الصورة الّتي نريد أن نرسمها للضحّاك، من خلال جوابه للحسين عليه السلام. فهو يطرح أوّلاً عُذره من خلال التزامه بالنسبة إلى عياله وديونه، ثمّ يطلب ثانياً منه أن يكون في حِلٍّ من أمره عندما يريد الانصراف، إذا لم يجد قتاله من دونه نافعاً له.
ثمّ يعرض على الحسين عليه السلام استعداده للقتال والدفاع عنه، بصورة محدودة ومُقيَّدة, فهو- حسب هذا التسلسل الّذي نجده في جوابه للإمام- يُقدِّم التزامه تجاه عياله وديونه أوّلاً، ثمّ يطلب إلى الحسين عليه السلام أن يكون في حلٍّ من أمرهِ ثانياً.
وواضح أنّ هذا الالتزام الّذي يحرص عليه الضحّاك تجاه الدنيا، وهذا الحِلّ الّذي يطلبه الضحّاك من الحسين عليه السلام تجـاه الله، أمرٌ غريب في شخصيّة الضحّاك، وقد كان أحرى به وأجدر أن يكون حريصاً بهذا الالتزام تجاه الله، وبهذا الحلِّ والتحلُّل والتحرّر تجاه الدنيا.
إنّ تفكير الضحّاك بن عبد الله في هذا الموقف تفكير مُحتاط ومُتحفِّظ بصورة غريبة، فهو في الوقت الذي يستجيب فيه لدعوة الإمام، يُبقي الأبواب من خَلفِه مفتوحة، ليتمكّن من العودة إلى الدنيا, عندما يبلغ المُفترَق الّذي لا يستطيع بعده أن يجمع بين الدنيا والآخرة، ولابدّ من أن يختار إحداهما، إمّا ديونه وعياله، وإمّا الآخرة، فيُبقِي الأبواب من ورائه مفتوحة، ليتمكّن من أن يرجع إلى الدنيا في اللحظة الحَرِجة من المَسير.
ونحن إذا استثنينا أُولئك الّذين يتحرَّكون على غير صراط الله، ويَصدّون الناس عن الحركة إلى الله تعالى، نجد أنّ سائر الناس في تحرّكهم إلى الله على طائفتين:
الطائفة الأُولى: تتحرّك إلى الله سبحانه, في جدٍّ وعَزم وصدق، تهدم من ورائها جسور العودة إلى الدنيا، لا يطردون الدنيا ولا يهجرونها، ولكنّهم إذا بلغوا المُفترَق الّذي لابُدّ لهم من أن يختاروا عنده الدنيا أو الآخرة، لا يُؤثرون على الآخرة شيئاً.
وهؤلاء هم (الصادقون) في التحرّك إلى الله ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾[28]، وموقعهم من الله عزّ وجلّ في الآخرة ﴿فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ﴾[29].
وطائفة أُخرى من الناس: يتحرَّكون إلى الله في حَذرٍ واحتياط، يُحبّون الله ورسوله ولكن، ما لم يُزاحم دنياهم، وما لم يسلبهم دنياهم، فإذا بلغوا المُفترَق الذي لابُدّ فيه من الاختيار الصعب، آثروا الدنيا على الآخرة، واختاروا شقَّ الدنيا وعادوا إليها. ولكيلا ينقطع طريق العودة عليهم, في اللحظات الأخيرة، لا يهدمون من ورائهم الجسور التي تنقلهم إلى الدنيا.
فهؤلاء يتحرّكون إلى الله سبحانه، ولا نشكّ في نيِّتهم وصدقهم- في هذه الحدود-، ولكن كلّما قطعوا شوطاً من الطريق، مَدّوا من ورائهم بقدره جسراً ينقلهم إلى الدنيا.
وهكذا كان الضحّاك بن عبد الله، اشترط على الحسين عليه السلام - قبل كلّ شيء- أن يكون في حلٍّ من الانصراف إلى دَينِه وعياله، فدخل مع الحسين عليه السلام في ما دخل فيه من قتال جيش بني أُمية، وقاتل بين يدي الحسين عليه السلام ، وقتل منهم وجرح عدداً، ولكنّه قد تحوَّط لنفسه منذ أوّل ساعة، فأخفى فرسه داخل فسطاط بين البيوت، وقاتلَ راجِلاً بين يدي الحسين عليه السلام ، لتَسْلَم له فرسه وليركبها ويفرّ بها إلى خارج ساحة المعركة، ويهرب عن جند ابن زياد، في اللحظة الحَرِجة الّتي لابُدّ له فيها من أن يختار أحد الأمرين.. فلمّا جدَّ الجِدُّ، ذكَّرَ الإمام الحسين عليه السلام بإذنه له في الانصراف متى شاء، ومتى لم ينفعه دفاعه عنه وقتاله من دونه، فصدَّقه الحسين عليه السلام ، فركب فرَسه وهرب من الآخرة إلى الدنيا.
إنّ هذا الرجل دقيق في تقدير المسافة الّتي يستطيع أن يُساير الحسين عليه السلام فيها، يضبط حساباته في هذه الحركة بشكلٍ دقيق، ويَتَحوَّط للعودة إلى الدنيا, عندما يصل إلى المُفترَق الذي يُؤثر عنده الدنيا على الآخرة.
يُشخِّص المُفترَق بدقّة، ويُحدِّد المسافة الّتي يُساير فيها الحسين عليه السلام بدقّة، ويَتَحوّط للعودة من الله إلى الدنيا في اللحظة المناسبة، ويُبقِي من ورائه- وهو يتحرّك مع الحسين عليه السلام إلى الله- بابَين مفتوحين، يرجع من خلالهما إلى الدنيا عندما يريد:
أحدهما: مُوافَقة الحسين عليه السلام أن يكون في حلّ من أمره عندما يريد الانصراف إلى الدنيا.
وثانيهما: فَرسه التي احتفظ بها في فسطاط داخل البيوت، عندما حاصر جيش بني أميّة الحسين عليه السلام, ليستطيع أن يركبها في اللحظة المناسبة من الآخرة إلى الدنيا.
ومرّة أُخرى نريد أن نُقارِن- في هذه النقطة من البحث- بين الضحّاك وزُهير:
كلّ منهما أقبلَ على الله تعالى مع الحسين عليه السلام.
الضحّاك دخل معركة الطفِّ إلى جنب الإمام، وقاتل وجاهد بين يديه، وزهير, رحمه الله, أقبلَ مع الحسين عليه السلام وجاهد وقاتل. ولكنّ الفرق بين هذا وذاك، أنّ الضحّاك أقبل على الله وأبقى الأبواب مفتوحة من خلفه، بكلّ دقّة واحتياط، وأبقى الجسور قائمة من ورائه إلى الدنيا, ليعود إليها في اللحظة التي يريد. وأمّا زهير، فعندما قرّر الوفود على الله تعالى مع الحسين عليه السلام ، قطع كلّ ما كان بينه وبين الدنيا من جسور، وأغلق كلّ باب بينه وبين الدنيا، وقال لزوجته (دلهم) في عزم وقوّة ويُسر: (إلْحقي بأهلك).
وإنّنا نتابع تفكير الضحّاك، وما أخذه الضحّاك من احتياط لنفسه في مثل تلك الساعة وتلك المعركة، فنرى أنّ هذه الدقّة في التقدير والضبط في الحساب، والتحفُّظ والاحتياط الشديدَين، جديرة بالاحترام لو كان في علاقة الإنسان بنفسه ومحاسبته لها.
أمّا عندما يكون التعامل مع الله تعالى، فمثل هذا التقدير والدقّة والاحتياط للعودة إلى الدنيا، هو من الشُحِّ في العطاء، ومن التردّد في العمل وفقْدان العَزم.
الجسر الذي مدَّه الضحّاك إلى الدنيا من عُمق (الطفّ):
ولنستمع إليه مرّة أُخرى:(لمّا رأيتُ أصحاب الحسين قد أُصيبوا، وقد خلُص إليه وإلى أهل بيته، ولم يبقَ معه غير سويد بن عُمَر الحنفـي، وبشير بن عمرو الحضرمي، قلتُ له: يابن رسول الله، قد علمتَ ما كان بيني وبينك، قلت لك: (أُقاتل عنك ما رأيت مقاتلاً، فإذا لم أرَ مقاتلاً فأنا في حلٍّ من الانصراف، فقلتَ لي: (نعم)؟! فقال: (صدقت، وكيف لك النجاة؟ إن قدرتَ على ذلك فأنت في حلٍّ). قال: فأقبلتُ إلى فرَسي، وقد كنت حيث رأيت خَيل (أصحابنـا)[30] تُعقَـر، أقبلت بها حتّى أدخلتُها فسطاطاً لأصحابنا بين البيوت، وأقبلتُ أُقاتل معهم راجلاً... فلمّا أذِنَ لي، استخرجتُ الفرَسَ من الفسطاط، ثمّ استويتُ على متنِها، ثمّ ضربتُها حتّى إذا قامت على السنابك ، رميتُ بها عرض القوم، فأفرجوا لي..)[31].
إنّ أمر الضحّاك لغريب في نوعه، فهو يمدّ جسور الدنيا إلى عُمقِ معركة الطفّ، وإلى داخل خيام الحسين عليه السلام ، حيث لا يوجد فيها غير الآخرة! فهذه الفرَس التي أخفاها الضحّاك في فسطاط لأصحاب الحسين عليه السلام بين البيوت يوم عاشوراء، هي الجسر الذي مدّه الضحّاك لينقله إلى الدنيا.
وقد رأينا وسمعنا كثيراً عن امتداد الدنيا إلى أعماق النفس، في مختلف مراحل الطريق إلى الله سبحانه، ولكنَّنا لم نرَ في ما رأينا، ولم نسمع في ما سمعنا، أنّ الدنيا تنفذ وتمتدّ وتكمُن في نفس الإنسان إلى هذا الحدّ، فيدخل الإنسان معركة الطفّ مع الإمام, ويسقط أهل بيت الحسين عليه السلام وأصحابه صرعى بين يديه، ويُقاتِل بين يديه، ويدعو له الحسين عليه السلام ، وهو يرى الإمام واقفاً وحده بين يدي الأعداء، ثمّ لم يُفارقه حُبّ الدنيا ونفوذ الدنيا، وسلطانها على نفسه، في هذه المراحل جميعاً.
إنّ التصاق الدنيا بنفس الإنسان لَغريب، ومن الخطأ أن يغترَّ الإنسان بنفسه، فيتصوّر أنّه قد تحرَّر من سلطان الدنيا ونفوذها، ولم يعد بحاجة إلى معاناة وتزكية وجهاد للنفس.
إنّ في نفس الإنسان خبايا عميقة وأعماقاً مجهولة، يكمُن فيها حُبّ الدنيا، ويبقى هذا التعلّق يُطارِد الإنسان في حركته إلى الله تعالى، من حيث يعلم الإنسان أو لا يعلم، حتّى إذا بلغ الإنسان نقطة الاختيار الصعب، برزَ حُبّ الدنيا من أعماق النفس المجهولة إلى السطح البارز للنفس، وغيَّر وجْهَة الإنسان وحركته, من الله تعالى إلى الدنيا.
إنّ حُبّ الدنيا يلاحق الإنسان إلى هذه النقطة، الّتي لا يكاد أن يبلغها الإنسان إلّا بعد أن يخرج من مصفاة الابتلاء عشرات المرّات، ومع ذلك كلّه، يبقى هذا الحُبّ كامناً في نفسه.
إنّنا لا نريد أن نتَّهم الضحّاك في صدقهِ وحُبّه للحســــين عليه السلام ، وليــس مـــن سبـــبٍ يدعونا إلى أن نتّهم هذا الرجل الذي وقف هذا الموقف يوم عاشوراء من الحسين عليه السلام في نيّتِه وصدقِه، فلم يطلب الضحّاك من الدفاع عن الحسين عليه السلام ومن القتال بين يديه, دنيا. وهذا حقّ يجب أن نقول به ونعترف له به. لكنّه مع ذلك كلّه، لم يتحرَّر من حُبّ الدنيا، ومن التعلّق بالدنيا، ومن تبِعات الدنيا، حتّى عندما ساقه التوفيق والسعادة الإلهيّة إلى هذه المعركة الحاسمة بين الحقّ والباطل في التاريخ، ووضَعه الله تعالى في أشرفِ موقِع يتصوّره الإنسان، وهو موقع الدفاع عن الإسلام إلى جنْب ابن بنت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.
والآن، بعد هذا التحليل النفسي لموقف الضحّاك بن عبد الله المشرقيّ، يجب أن نوجز مرّة أُخرى العناصر التي تدخل في تكوين هذا الموقف الغريب، وأهمّ هذه العناصر هي:
1- حبّ الدنيا والتعلّق بها: وهو رأس هذه العناصر جميعاً، وهو أوّل شيء اعتذر به الضحّاك إلى الحسين عليه السلام عن مسايرته ونصرته، فلم يتخفّف ولم يتحرَّر الضحّاك من الدنيا، وهو في وسط هذه المعركة المصيريّة, كما تخفّف وتحرَّر منها (زهير) من قبل.
2- شحّة العطاء: وهي غير نضوب النفس، ففي حالة النضوب والجفاف ينقطع كلّ خير عن نفس الإنسان، أمّا في حالة (الشحّ)، فيبقى للإنسان عطاء محدود وشحيح. وقد رأينا كيف وضع الضحّاك نصرته للحسين عليه السلام ضمن مجموعة من الشروط، ولم يبذل نصرته بَذلاً, كما صنع سائر أصحاب الحسين عليه السلام ، ولم يُوطِّن نفسه لقاء الله، كما طلب الإمام الحسين عليه السلام من المسلمين في مكّة المكرَّمة.
3-التحرّر من الالتزامات التي تفرضها الدعوة والجهاد: والتحلّل من القيود والعهود التي يفرضها الولاء لله تعالـى, ولرسوله ولأئمّة المسلمين.
وهذه العناصر الثلاثة تؤدِّي إلى ظواهر سلبيّة كثيرة في شخصيّة الإنسان، من قبيل: الخوف، والجُبن, والخضوع، والانقياد للطاغوت، وانحسار سُلطان الضمير عن حياة الإنسان وسلوكه.
ولسنا نريد أن نقول: إنّ هذه العناصر كانت موجودة مجتمعة في موقِف الضحّاك بن عبد الله، ولكنَّنا نريد أن نقول: إنّ أمثال هذه المواقف يُمكن أن تنحلَّ إلى هذه المجموعة من العناصر السلبيّة.
وفي ختام هذه التأمُّلات، نعتذر إلى الضحّاك بن عبد الله المشرقيّ، إذا كنّا قد أسأنا إليه، وتناولنا موقفه من الحسين عليه السلام بالتحليل والنقْد بهذه الصورة، ولا نريد أن نبخسه حقّه، فقد نال ما حُرِمنا منه نحن، من شرفِ القتال بين يدي الحسين عليه السلام ، ومن دعاء الحسين عليه السلام له...، وإنّما كنّا نريد أن نجعل من نقاط الضَعف في موقفه, وسيلة لتقويم نقاط الضعف في مواقفنا وسلوكنا.
[1] العلّامة الشيخ محمّد مهدي الآصفيّ. وقد تصرّفنا بحذف جملة: المتخلّفون عن ثورة الإمام الحسين من العنوان, لضرورات فنيّة.
[2] التوبة: 118.
[3] وقعة صِفّين لنصر بن مزاحم، تحقيق عبد السلام محمّد هارون: ص 321 ـ322.
[4] تأريخ الطبريّ، طبعة ليدن: ج7 ص 321.
[5] تأريخ الطبريّ، الطبعة الأوربيّة: ج 7 / ص 354- 355. ونَفَس المهموم للشيخ عبّاس القمّي: ص 298ـ 300.
[6] إبصار العين: ص 101.
[7] آل عمران:14.
[8] بَينِها: بُعدها وزوالها عنهم.
[9] ابتَكَرَت: أصبحت تبتكر، أي تصيح.
[10] نهج البلاغة: باب الحِكَم/ الحكمة رقم: 126.
[11] نهج البلاغة: باب الحِكَم/ الحكمة رقم: 128.
[12] مقتل الحسين للسيّد عبد الرزاق المقرّم: ص 188.
[13] حياة الإمام الحسين للشيخ القرشيّ: ج 3 / ص 67.
[14] التوبة:111.
[15] مقتل الحسين ، للسيّد المقرّم، منشورات مؤسّسة البعثة- طهران: ص 166. واللهوف على قتلى الطفوف، للسيّد ابن طاووس: ص 33. وابن نما: ص 20.
[16] ال عمران:97
[17] التوبة:111.
[18] الحديد:11.
[19] آل عمران:172 و179.
[20] فاطر: 7.
[21] الحديد: 7.
[22] الفتح:16.
[23] القلم: 3.
[24] التين: 6.
[25] الانشقاق: 7 و 8.
[26] الزمر:10.
[27] النور:37- 38
[28] الأحزاب:23.
[29] القمر:55.
[30] يقول الضحّاك: خيل (أصحابنا)، وهو عازم على مفارقتهم والانفلات من مصيرهم! وأيّ صُحبة يا تُرى بعد أن فارقَهم وهجَرهم إلى دَينه وعياله، ولَحقَ بصاحبه مالك بن النضر الأرحبيّ؟!
[31] تاريخ الطبريّ، الطبعة الأوربيّة: ج 7/ ص354 355. ونفس المَهموم، للشيخ عبّاس القمّي: ص 298 300.
 الاكثر قراءة في قضايا عامة
الاكثر قراءة في قضايا عامة
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية












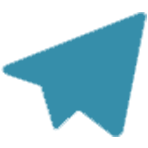
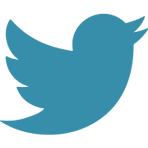

 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)