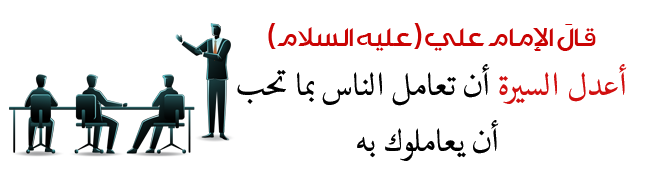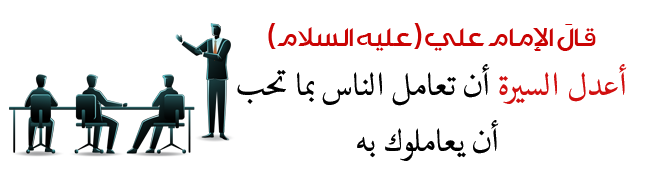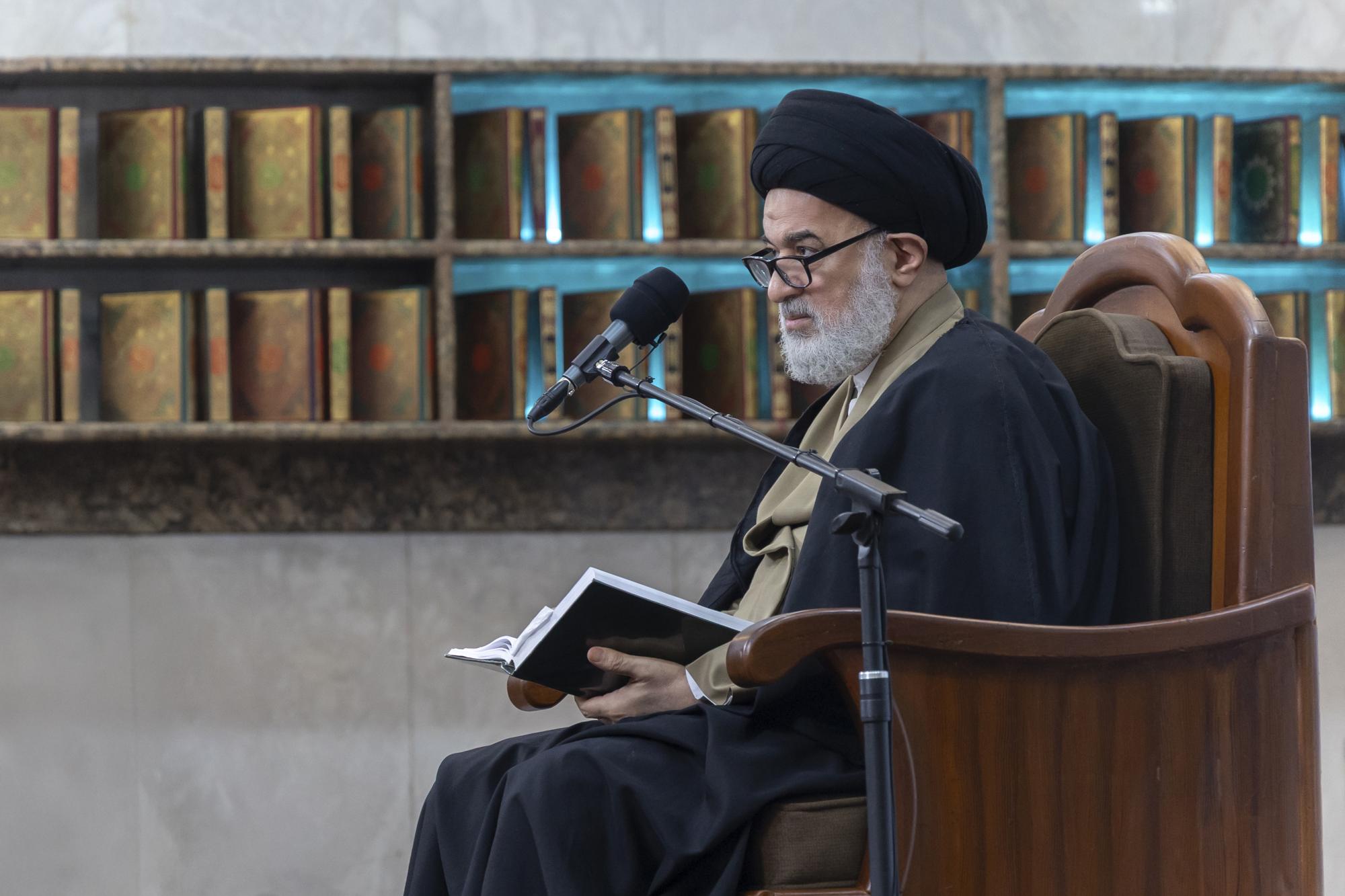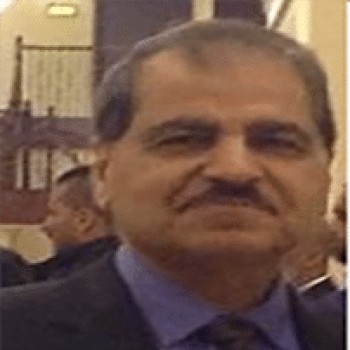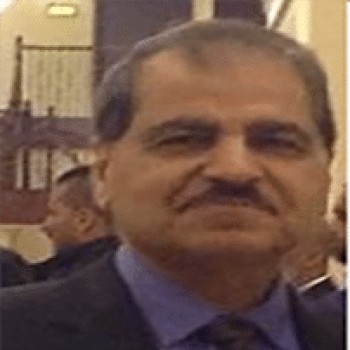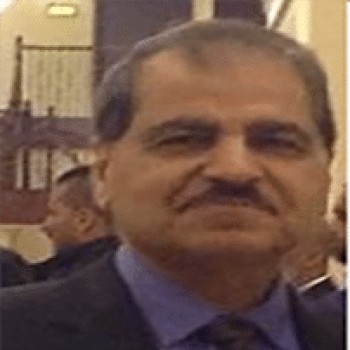ألقى أستاذ الحوزة العلميّة العلّامة السيّد أحمد الصافي، المحاضرة العلميّة الثانية لشرح دعاء أبي حمزة الثمالي في شهر رمضان المبارك 1446، بحضور مسؤولي العتبة العبّاسيّة المقدّسة وخَدَمتها وجمع من الفضلاء وطلبة العلوم الدينيّة. المحاضرة تأتي ضمن سلسلة المحاضرات التي قدّمها سماحته السنوات الماضية، في شرح دعاء أبي حمزة الثمالي عن الإمام السجّاد(عليه السلام)، وانطلقت في هذا الشهر الفضيل مجدّدًا لإتمام شرح ما يتعلّق بهذا الدعاء ومضامينه. وتطرّق سماحته في محاضرة اليوم إلى أهمّية التوجّه إلى الله تعالى بالدعاء وعدم اليأس من رحمته الواسعة، حتّى في حالات المعصية، والبقاء على باب الرحمة مهما كانت الظروف، لأنّ رحمة الله تسبق غضبه، مشدّدًا على ضرورة إدراك الإنسان أنّه مملوكٌ لله وراجع إليه، وأن هذه الحقيقة يجب أن تكون نُصب عينيه دائمًا. وجاء في نصّ المحاضرة: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله على نبيّنا محمد وعلى آله الطيّبين الطاهرين. ما تقدّم من دعاء الإمام (عليه السلام)، وهي حالة البقاء على باب الرحمة وعدم المغادرة لغيرها، حتّى وإن نهَرَه الله تعالى أو زجَرَه، والإمام (عليه السلام) بيّن النكتة العلميّة أو النفسيّة في ذلك، أنّ النكتة لِما أُلقِي في قلبه، لِما أُلهِم في قلبه، من سعة رحمة الله تعالى، وطبعاً هذه تنطبق على ما تقدّم. مثلاً إذا زجر الله عبداً معناه أنّ الله تعالى غضب عليه، وإذا نهَرَه غضب عليه، لكن لأنّ الرحمة واسعة، فيُمكن لهذه الرحمة أن تسبق هذا الغضب، فهذه العلاقة ما بين أن ينهر وما بين بقائه في حالة الدعاء مع النَهْر، بل ذكرنا حالتَي التملّق والتودّد إلى الله تبارك وتعالى، وهذه في مجموعة أدعية أهل البيت(عليهم السلام) تجدها ظاهرة، بضرورة أن يبقى الإنسان طارقاً لرحمة الله تعالى حتّى مع نَهرِه منه سبحانه، فمن لجَّ ولَجَ، كما في الحديث الشريف، وكما قلنا سابقاً وفي الأمس، الإنسان مأمورٌ بالدعاء، وعليه أن يدعو الله سبحانه، وليس عليه أن ييأس من الإجابة، بل اليأسُ من روح الله هو من الكبائر. مهما يصل الإنسان إلى حالة من المعصية -والعياذ بالله- والابتعاد عن الله، عليه أن لا ييأس من سعة رحمة الله، هكذا أمرنا سبحانه وهذه من نِعَم الله، أن يجعل اليأس من كبائر معصيته. لو افترضنا أنّ الإنسان يذنب ذنباً كالكذب، أو يغتاب أحداً أو يأكل مال اليتيم، هذه من المحرّمات، أو يطفّف الميزان، كلّ هذه من المحرّمات، واليأس من رحمة الله تعالى أيضاً من المحرّمات، بل من الكبائر، وذلك لأنّ رحمة الله تبارك وتعالى واسعةٌ جداً، واليأس منها خلاف ما عرفناه من الرحمة، وقد أمرنا الله بالاستفادة منها، فالإنسان لو قارن نفسه مع رحمة الله، يجد أنّه شيءٌ بسيط، أمام هذه السعة الهائلة لرحمة الله تبارك وتعالى. ولذلك على الداعي أن يبتعد عن اليأس، ولسان حاله يقول: إنّني لم أكفّ عن التملّق، ولم أبرح باب رحمتك، أبقى ببابك وأبقى أتملّق إليك، أتودّد إليك، إلى أن تشملني بهذه الرحمة، ثمّ يقرّر هنا قاعدةً، على النحو الأشبه بالسؤال -وهذا بحثٌ يحتاج أيضاً أن نتوجّه له-، قال (عليه السلام) فيما قال، بعد أن فرغنا من مسألة (ولا كَفَفتُ عَن تَمَلُّقِكَ لِما أُلهِمَ قَلبِي مِنَ المَعرِفَةِ بِكَرَمِكَ وسَعَةِ رَحمَتِكَ)، لاستيعاب القلب الداعي من المعرفة بكرمك وسعة رحمتك، قال: (إلَى مَن يَذهَبُ العَبدُ إلّا إلَى مَولاهُ، وَإلَى مَن يَلتَجِئُ المَخلُوقُ إلّا إلَى خَالِقِه)؟. هذا كأنّه سؤال، لكنّ السؤال هنا ليس فعلاً لطلب الفهم، الإنسان عندما يسأل يعني يستفهم، حين تقول أين الطريق؟ تستفهم، ومعنى تستفهم يعني تطلب الفهم، أنت لا تريد أن تهتدي إلى الطريق، فتسأل أين هو؟، ليقال لك الطريق مثلاً على جهة اليمين، أو تسأل أين بيت فلان؟ كي يكون السؤال حقيقيّاً. هناك سؤال لا يكون حقيقيًّا وإنّما هو تقرير، بمعنى أنّي أعرف الإجابة، لكنّي أريد أن أبيّن بطريقة السؤال اعتقادي بالجواب، السؤال كأنّه: إلى (مَنْ) يذهب العاصي، وليس إلى (أين)؟، التفتْ (إلى مَنْ)، ومَنْ تستخدم للعاقل، فكأنّه، مَنْ تلك الجهةُ العاقلة التي يذهب إليها هذا العبدُ؟، أو إلى مَنْ يَذهبُ هذا المخلوق؟، الإمام (عليه السلام) ذكرَ مطلبَينِ، ذكرَ العَبدَ، وذكَرَ المخلوق، مقابل العبدِ المَولى، ومقابل المخلوقِ الخالق. فالسؤال ليس سؤالاً حقيقيّاً، لأنّه يعلم إلى مَن يذهب، فهو سؤالٌ تقريريّ، يعني أريد أن أبيّن يا إلهي أنّه لا طريق لي إلّا إليك، وهذا السؤال التقريريّ ممدوح، أنّ الإنسان يهرب من الله إلى الله، يجعل جهةَ الهربِ اعتباراً ليس حقيقيّاً، لأنّ الله واحد، إذ يجعل اعتبار جهة الهرب غير جهة اللجوء، فهو يهرب من الله إلى الله تعالى، بمعنى أنّه يهرب من جهة عذاب الله، ومن جهة الخوف من الله، إلى جهة الرجاء والعفو ورحمة الله تعالى. والإنسان العاقل هو الذي بعد أن قيّم الأمور، لا يجد لنفسه مهرباً أصلاً من الله تعالى، لأنّه فعلاً لا يوجد، ولذلك هذه العبارة دائماً تتكرّر، خصوصاً إذا وقعت نازلة، نقول: إنّا لله وإنّا إليه راجعون، واقعاً هذه الكلمة على وجازتها جدّاً مهمّة، فهذا من الإقرار أنّنا لله، نحن مملوكون لله تبارك وتعالى، فمهما يعلو شأن الإنسان في الدنيا، بسلطانٍ أو مال، فهو لا بدّ أن يكون مملوكاً لله تعالى، وأيضاً هو راجعٌ إلى الله تعالى، مهما تطول الأيّام به والليالي، هو راجعٌ إلى الله تعالى، والعاقل هو الذي يجعل هذه المقولة نُصبَ عينَيهِ دائماً. لعلّي نقلتُ لحضراتكم، كان أحد الطلبة، بعد أن تشرّف بالدراسة الحوزوية، قد حاول أن يستفيد من بعض الأجلّاء (قدّس الله أنفسهم)، إذ قال: أوصِني أنا سوف أسلك هذا الطريق وأحتاج إلى وصيّة، كونك خبيراً في هذا الجانب، قال له افتح كتابك، اكتب هذه العبارة، قل "الله مطّلعٌ عليّ، الله معي"، أو بالعكس "الله معي الله مطّلعٌ عليّ"، ضع دائماً أمامك هذه العبارة، الله معي، ستشعر بالقوّة، لأنّ الله تعالى يمتلك كلّ الأسباب بيده، فالله معك، والله مطّلعٌ عليك، إيّاك أن تخالف مخالفةً تعتقد أنّ الله لا يراك فيها. الله لا تحجبه ظُلمة، ولا يحجبه ليل، ولا يوجد مكانٌ لا يراه الله تعالى، فعلى الإنسان دائماً أن يجعل هذه الأمور نُصب عينَيهِ، وعلى المؤمن أن يكون قلبه دائماً بين الخوف والرجاء. عندما يقول (الله معي) فهنا الإنسان يرجو، لأنّه إذا كان الله معه فلن يخشى شيئاً، وأيضاً الله مطّلعٌ عليه، فلا بُدّ أن يراقب نفسه. الله ليست له قرابة مع أحد، بل عمل الإنسان هو الشفيع، العمل هو المقرِّب، لا شيء آخر يقرّبنا إلى الله تعالى، نعم.. وجود الاستعداد النفسيّ والثقة بالله تبارك وتعالى شيءٌ مهمّ، ومرّ علينا سابقاً، أنّ الإنسان كلّما أحسن الظنّ باللّه، كان الله تعالى عند حسن ظنّ عبدِه المؤمن، وهذه الدنيا يا إخواني، الإنسان كم يُعمَّر فيها؟!، لا بُدّ أن يكون للإنسان فيها هدف. نعم.. هذا الهدف قد يميل يميناً ويساراً، لكن لا بُدّ أن يرجع يوماً إلى الجادّة الوسطى، يعرف بعض الأخوة في مجالسنا المتعلّقة بمناقشة بعض المشاريع وما يتعلّق بها، أنّنا استفدنا من زيارة سيد الشهداء(عليه السلام) كثيراً، وشبّهنا هذا التشبيه، أنّ الإنسان إذا خرج من محافظةٍ بعيدة، وكان عنده هدف وهذا الهدف هو زيارة الحسين(عليه السلام)، فيأتي ماشيًا دون اكتراث، يقطع نحو 500 كيلو، ولعلّه أكثر أو أقلّ من مختلف جهات العراق، لكنّه عيّن المبدأ، وهو أن يمشي من مكانه، والمنتهى أيضاً عنده واضح، وهو أن يصل إلى ضريح سيد الشهداء(عليه السلام). تبدو هذه مسألة مهمّة في حياتنا اليومية، إذن هو حدّد هدف مشروعه، صارت عنده الصورة واضحة، عندما تسأله: إلى أين تذهب؟، يقول لك: أذهب إلى زيارة الإمام الحسين(عليه السلام)، في أثناء مسيره، الطريق غير مفروش بالورود، بل فيه مشاكل، قد يجوع، يعطش، يجرح، تصيبه بعض الآلام، هذا وضع طبيعيّ، لكنّه لا يتراجع عن الهدف، يعني لا يترك المشي بسبب هذه العوائق، إنّما يعتقد أنّه سيمرّ بهذه الأشياء في هذا الطريق، استغرق المشي عشرين يوماً، شهرًا، أو أقلّ، إلى أن يحطّ رحله عند سيّد الشهداء(عليه السلام)، فيشعر أنّه حقّق هدف مشروعه، حقّق ما كان قد بنى عليه، لا يميل، لا يترك هذا المشروع، نحن مع الله تعالى، يفيدنا هذا التشبيه البسيط، بأن نجعل هدفنا رضاه ونحن نسير في هذه الحياة. فنحن نؤمن أنّنا سنذهب إلى الله، لا شكّ في ذلك، وجرى القلم بالموت على الأنبياء وعلى الأولياء وعلى العلماء وعلى الصالحين وعلى الطالحين، لا يُخلّد في هذه الدنيا أحد، هذا قطعًا نحن نعلمه علم اليقين، فعندما يحدّد الإنسان هدفه، لا بُدّ أن يعمل وفق هذا الهدف، لا يُمكن أن يرجو الله والآخرة، ويعمل عمل أهل النار!!، لأنّها ستكون حالةً من حالات النفاق، وحالة من حالات أنّه لديه علم لا ينفعه، يعني أنّه يعلم لكن هذا العلم لا ينفعه، لأنّه لا يعمل به خلال حياته، فيحدّد هذا الهدف، لكن بالأثناء يحاول الشيطان أن يحرفه، ولأنّ النفس ترغب إلى الدعة، فإنّ الإنسان يتكاسل عن الطاعات، مثلاً صلاة الصبح يتثاقل عنها، لكن يرجع ذلك لما ذكرناه في المحاضرة السابقة، أنّها عملية الزيغ، عمليّة الميل عن الحقّ. الإمام الصادق(عليه السلام) كان يُحذّر من الزيغ، والإنسان الموفَّق يرجع، يعني الذي يعتقد بأنّه سيسير إلى الآخرة، وبما أن أغلب الناس ليسوا معصومين، سيمرّ بحالات الزيغ، لكن لا يُمكن لهذه الحالة أن تستمرّ عنده، إذا زاغ يحاول أن يرجع وينبّه نفسه ويُكمل المسير إلى الله. مثلاً في اللحظات الأخيرة عندما يحتضر الإنسان ويصل إلى حالة التشهّد -أطال الله أعماركم في خيرٍ وعافية-، يرى نفسه أنه قد وصل إلى المرحلة النهائية من الدنيا، وسينتقل إلى مرحلة أخرى، فيستعرض هذه الأعمال وفق الهدف الذي أسّسه، ولذا كان عليه كلّما جاءه ذنب، أو كلّما وثب على معصية أن يتدارك نفسه بالتوبة. وستأتي بعض الفقرات، حين يطلب الداعي من الله أن يعينه على البكاء، فلا نستعجل المطلب، سيأتينا. المقصود، هذا السؤال الآن الذي يُسأل، ليس سؤالَ غيرِ عالمٍ بالجواب، بل هو سؤال عالمٍ إلى أين المصير؟، هذا العمل نهايته مَن سيستقبله منّي؟، أنا أعمل أعمالاً صالحة وهذه الأعمال تراكمت، من الذي سيقرأ عملي؟ من الذي سيُقدَّمُ له العمل؟! السائل يعرف، وَالإمام بيّن أنّه بين عبدٍ ومَولى، وبين مخلوقٍ وخالق، فقط أعطانا هاتَينِ الحالتَين. لاحظوا يقول إلى مَن يذهب؟، ليس إلى أين يذهب، ومَنْ تُستخدم للعاقل، فهذا السؤال إلى من يذهب، ليس سؤالَ إنسانٍ لا يعرف، بل هو يُجيب، قال: (إلى مَن يَذهبُ العبدُ، إلّا إلَى مَولاهُ)، فكأن لسان حال الداعي يا إلهي أنا لا يوجد عندي مهربٌ منك، مصيري إليك وأنا عبد. وهذا العبد عنده مَولى، وهذا المَولى مسؤولٌ عن العبد، والعبدُ لا يملك لنفسه ضرّاً ولا نفعاً، إذن مصيره إلى هذا المَولى، فهذا سؤالٌ تقريريّ، يعني أنّ السائل يعرف الجواب، وهذا نستعمله فيما بيننا. كثيرٌ من الأسئلة التي تلاحظونها، سؤال نعبّر عنه بسؤال، لكن هو واقعًا كأنّه خبر -بعض الإخوة يأنسون بهذه المصطلحات- يعني جملة إنشائية، السؤال الحقيقيّ جملة إنشائية، والجملة الخبريّة مُقابل الإنشائية، هذه غير هذه. الجملة الخبريّة توصف أنّها تحتمل الصدق والكذب، والإنشاء لا يُوصف بالصدق والكذب، فهي لسان إنشاء، إلى مَن يذهب؟، لكن واقعاً هي واقع خبر، لأنّي أعرف إلى أين المصير؟، أو أين المسير؟، فواضحٌ أنّ العبد ذهابه إلى الله تعالى. وهو في هذه اللفظة -يعني المَولى- مَولى هذا العبد، إلى مَن يذهبُ العبدُ إلّا إلى مَولاه؟، نعم.. يذهب إلى مولاه، كأنّ هذا الجواب واضحٌ للسائل. قال (وإلى مَنْ يلتَجئُ المخلوقُ إلّا إلى خالقه)؟، عادةً الالتِجاء يكون من مشكلة، مُمكن أن نعبّر عنه: يلتَجِئُ مِن مَن؟، ويلتَجِئُ إلى مَن؟، الإنسان لماذا يلتَجئُ؟ لأنّه بحاجة إلى اللّجوء، عنده مشكلة مثلاً، عنده مسألة طبّية يرى نفسه أو جسده مريضًا؟ فيستشعر حالة المرض، فيحاول أن يهرب من المرض، لمَن يلتجئ؟ لا بُدّ أن يلتجئ إلى شخص لديه القدرة على إزالة المرض، لا يلتجئ إلى مريضٍ مثله، ولا يترك اللّجوء لأنّ هناك حاجةً لا بُدّ لهذه الحاجة أن يلبّيها، الإنسان يلجأ دائماً إلى جهةٍ قادرة على أن تحميه، على أن ترفع منه حالة النقص، حالة الحاجة، حالة الفقر، ونحن فقراء إلى الله (يَا أيّها الناسُ أنتُمُ الفقراء)، هذه قاعدة (يا أيّها الناس...) كلّ مخلوقٍ فقير إلى الله تعالى، الأنبياء والأئمّة والعلماء، كلٌّ مُفتقرٌ إلى رحمة الله تبارك وتعالى، لاحظ كيف يقرّر الإمام (عليه السلام) هذه القضيّة، العبد إلى مَن يذهب، يذهبُ إلى مَولاه، وعبدٌ يضع نفسه أمام المَولى، والمَخلوق فيه شيءٌ مهمّ، مخلوقٌ يعني له زمنٌ خُلِق فيه، هو لا يكون خالداً، حين جاء وقتُه خُلِق، قبل هذا الوقت هو غير مخلوق، فله بداية في هذه الحياة، فإذن هو مخلوقٌ محتاجٌ فقير، فإلى أين يذهب هذا؟ أو إلى مَن يذهب؟! يَذهب إلى الخالِق. (الخالِق) هذه الصفة وهذا الاسم، علماء الكلام يعتبرونها من الصفات الفعليّة، يقسمون الصفات الفعليّة. يعني لو افترضنا أن الله تعالى خلق زيداً مثلاً ولم يخلق عمراً، هذا من شؤونه أيضاً، مدارات هذا العبد، الله عندما خلقه لم يتركه سدى، خلقه ثمّ رزقه ثمّ مكّنه من أن يعيش، ثمّ سلّحه بالقابليّات البدنيّة، والقابليّات الفكريّة، هذا مقتضى الخلقة، فيضمّ مجموعة أشياءٍ في هذه الخلقة، أنت الخالق فأكون أنا العبد وأنت المولى، وأنا المخلوق وأنت الخالق، كلا الصفتين عندي أنا عبدٌ وأنا مخلوق، وكلا الحالتين عند الله تعالى هو المَولَى وهو الخالِق. فإنّه أنا عبدٌ لا أملك لنفسي شيئاً، وأنا أرجع إليك قاصراً، عندي قصور، وأنا مخلوقٌ بالنتيجة كنتُ معدوماً وأنت أفضتَ عليَّ، ولا زلتُ مخلوقاً، وأنا بحاجةٍ ماسّة إليك كخالِق، مجرّد أن ترفع يدك عنّي أنا أتيه، فهذا إقرار، هذا الإقرار المشفوع بالتملّق والتودّد والرغبة لحلّ مشكلة العبد، وحلّ مشكلة المخلوق، هذه هي النكتة. لا يريد الإمام (عليه السلام) فقط أن يخبر، قلنا هي جملةٌ إنشائيّة كسؤال، لكن ليس المقصود تحصيل الجواب، إنّما يريد من وراء ذلك شيئاً، أنّه أنا كعبد لا بُدّ أن أذهب إلى الله، إلى المَولَى، وأنت كمَولى خلّصني، وأنا كمخلوق أيضاً أذهب إلى الخالق، وأنت كخالق أيضاً خلّصني، بيدك الأمور جميعاً، هذه نكتة علميّة تبرّر وجه التملّق، ونكتة تبرّر وجه عدم مغادرة باب الرحمة حتّى لو نهَرَني الله تعالى؛ لأنّه لا يوجد ملجأ غير الله تبارك وتعالى. هذه المقدّمات حقيقةً تدخل في حالة طرق الأبواب، وقلنا هذه العبارة مشفوعة، يعني ليست مقام برهان، تارةً الإنسان يبرهن أنّ الله موجود، أفي الله شكٌّ فاطر السماء والأرض، تريد أن تبرهن، يعني في قضيّة استدلاليّة عقليّة، وتارةً لا تريد أن تبرهن فقط، إنّما تريد أن تستفيد، أمس ذكرنا في المحاضرة السابقة أنّنا نستثمر هذه الحالة، حالة المَولَوِيّة إلى الله هو المَولَى، وحالة الخالقيّة إلى الله تعالى هو الخالق، فدائماً نستثمرها (إلَى مَن يَذهبُ هذا العبد؟) يذهب إلى الله، إلى المولى، (إلَى مَن يَذهبُ هذا المخلوق؟) يذهب إلى الله الذي هو الخالِق. فهذا الحال حال استثمارٍ لهذه الصفات، قلنا لسان السؤال هو ليس المراد، إنّما لسان التقرير، لاحظوا الآن أنّنا نأتي إلى التفاتةٍ أخرى في كلام الإمام (عليه السلام)، وهي تحتاج أيضاً إلى مزيدٍ من التأمّل. يقول: (إلهي...)، وهي نداء، يعني يا إلهي، يا الله، يُنادي هذا العبد في مقام الدعاء (... لو قرَنتَنِي بِالأصفادِ، ومَنَعتَنِي سَيبَكَ مِن بَينِ الأَشهادِ)، أقرأ وأعدّد هذه النقاط المهمّة، (وَدلَلتَ عَلى فَضائِحِي عُيونَ العِبادِ، وَأمَرتَ بِي إلَى النّارِ، وَحُلتَ بَينِي وبَينَ الأَبرارِ، مَا قَطعتُ رَجائِي مِنكَ، وَمَا صَرفتُ تَأمِيلِي لِلعَفوِ عَنك، ولا خَرجَ حُبّك مِن قَلبِي...)، إلى فَقرةٍ أُخرى يأتي. لَو هذه، في (إلهي لو..)، أهلُ اللغة يعتبرونها شرطيّة، لكن تحدثُ بين قضيّتَينِ، التي يعبّرون عنها بأنّها غير واقعة، أي أشبه بالامتناع، الآن أشبّه بشيء، لكن لا بُدّ من وجود علاقةٍ بين الشرط والجزاء المترتّب على وقوعه، وإن كان الأمر غيرَ واقع. أستعين لشرح ذلك بمثالٍ لتقريب هذه الفكرة، لو أن جنابك تقول "لو كنتُ غنيّاً لتصدّقت بنصف مالي"، هذه الجملة شرطية، حين تقول "لو كنت غنياً لتصدّقت بنصف مالي"، الآن هل أنت فعلاً غنيّ؟ فهذه هي الفكرة، تثير هذه النقطة عندك أملاً مستقبليّاً، أو تريد أن تخبرنا أنّك لو أصبحت غنيًّا فجزاء هذا الغنى أنّك ستتصدّق بنصف المال، لكن فعلاً الآن أنت لست غنيًّا، ولم يحصل التصدّق. العلاقة بين الغنى والتصدّق علاقة مهمّة، سألنا علاقة عقليّة، علاقة عقلائيّة، علاقة عرفيّة، نحن لسنا بصدد تحقيق معنى المصطلح فعلاً، لكن حتّى نفهم المطلب أقول لا بُدّ من وجود علاقة، أمّا إذا بدّلت التعبير بأن قلت: لو كنتُ غنيّاً لطار الطائر –مثلاً-، أو لطارت الحمامة، يقول لك أيّ علاقةٍ بين الغنى والحمامة؟، لا توجد علاقة، هذه الجملة غير صحيحة، في النحو لها إعراض، ولها موقع، لكن معنى الجملة غير صحيح، لا يوجد ربط بين الغنى والطائر! فلا بُدّ من وجود علاقة بين المقدَّم وما بعدَه التالي، الآن نأتي للدعاء، يطلب هذا المعنى أو يبيّن هذا المعنى. يذكر الإمام (عليه السلام) تقريباً خمس نقاط نتوجّه لها بشكلٍ دقيق، يعبّر عنها كلّها قبل الجزاء، وكلّها ما بعد لو، لكن لا بُدّ أن تكون هناك علاقة بينها وبين ما بعدها، قلنا بين الشرط وجوابه مثل عبارة "لو كنت غنيّاً لتصدّقت"، هناك علاقة ما بين الغنى والتصدّق، فعندنا علاقة بين أمور قد بيّنها الإمام (عليه السلام) في خمس نقاط، والإمام (عليه السلام) أجاب عنها بالشقّ الثاني يعني بالجزاء، لعلّها بثلاث نقاط، ما هي هذه الأمور الخمس التي بيّنها الإمام (عليه السلام)؟ لا ننسى العلاقة ما بين (إلّا) وما بعدها، لاحظوا نأخذ الآن النقطة الأولى التي بيّنها الإمام (عليه السلام)، قال (إلهي لو قرنتني بالأصفاد) هذا المقطع الأوّل، (ومنعتني سَيبَكَ من بين الأشهاد)، و"دَلَلتَ على ..."، ما معنى لو قَرنتَنِي بالأصفاد؟ قرَنتَنِي، يعني تستعملها في مسألة الشدّ، قلت هذا شددته. الأصفاد، التي هي حالة مَن إذا استوثقَ أمراً، هذه -قرنتني بالأصفاد- ربَطَها الإمام (عليه السلام) بالله، يعني أنت يا إلهي لو تفعل بي هكذا فرضاً، وهذا طبعاً فيه إشارة إلى بعض الآيات (وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ)، في هذه الآية إشارة إلى أنّ نتيجة التقرّن بالأصفاد أنّني استوجبتُ ذلك، دعونا نتأمّل كلام الإمام (عليه السلام)، فهو كلامٌ دقيق، الله تعالى لماذا يقرّن بالأصفاد؟ قال لي لماذا يفعل هذا الفعل؟ هذا معناه وجود مقدّمة أدّت إلى تلك النتيجة. كما تقول لشخصٍ مثلاً "أنت في السجن"، الوضع الطبيعيّ للإنسان أنّه ليس في السجن، فلا بُدّ أن يفعل فعلاً استوجبَ دخوله السجن، طويتَ هذه المقدّمة، يعني أنت سارق فحقّك أن تُسجن، أنت مُعتدٍ فحقّك أن تُسجن، أنت ظالم أنت مؤذٍ، إلى آخره. الإمام (عليه السلام) يقول (لو قرنتني بالأصفاد) اختزل الفعلَ المُستَوجِبَ إلى أن يقرن بالأصفاد، وهذه صفات المجرمين، المجرم هو الذي يقرن بالأصفاد (وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ)، الإمام (عليه السلام) اختصر الأمر بكون الداعي مستحقّاً لما حصل له، كداعٍ يقول "إلهي أنا مستحقّ وجزائي أن أقرّن بالأصفاد"، تعبير بليغ اختصرَ هذه المقدّمة، وإنّما أعطانا النتيجة، ولاحظوا كلّ النتائج هي عبارة عن مسبّبات للذنوب، هذا مبحثٌ أخلاقيّ في العقائد، وهو مهمّ كثيراً. هناك من الذنوب ما لها آثار خاصّة في الدنيا كما في الطاعات، التي لها آثارٌ خاصّة، أنّ الإنسان يحنو على يتيم فله آثار خاصّة، أن يتصدّق فله آثارٌ غير نماء المال، صدقة السرّ تطفئ غضبَ الربّ. الله تعالى يغضب على العبد، فحينما يتصدّق سرّاً يطفئُ هذا الغضب، صلة الأرحام هي أعمالُ برٍّ تُنسِئُ في الأجل، لو أنّ الإنسان بقي من أجله مثلاً 60 عاماً، حين يصل رحمَهُ فإنّ الله تعالى يمدّ في عمره، كأعمال برٍّ لها آثارٌ خاصّة، الذنوب أيضاً لها آثارٌ خاصّة، وذكرنا في دعاء كميل بعض الذنوب التي تهتك العصم، بعض الذنوب تحبس الدعاء، بعض تدع الديار بلاقع، بسبب الزنا -والعياذ بالله-، بعض الذنوب كالقضاء الفاسد يقول عنه الإمام الصادق(عليه السلام) كما في قصّة أبي ولاد الحناط "بمثل هذا القضاء تحبس السماءُ قطرها، وتمنع الأرض بركاتها"، نعم.. تقلّ الأرزاق وترتفع الأسعار وهكذا، لكلّ ذنبٍ آثاره الوضعيّة على الفرد أو المجتمع. هذا ما عدا الآثار الأخرويّة كذلك، ولتنوّع الذنوب وتعدّد درجاتها تتعدّد درجات الحساب، فكما أنّ للجنّة طبقات ومنازل كذلك للنار أيضًا طبقات ومنازل، للجنّة مقابل بعض الأعمال مراتبُها وكذلك للنار، بعض مراتب الجنّة مع الصدّيقين والأبرار ومنازل الأنبياء والشهداء، منازل جهنّم كذلك، هناك طبقات لجهنّم، أسماء النار تختلف بحسب آثارها، الجحيم شيء، والنار شيء، والدرك الأسفل شيء، وهذه كلّها بملاحظة الآثار -آثار الذنوب-. الآن هذه الأمور سنبيّنها لك، لكن لا ننسى شيئاً، قد يقول قائل، فليفرض الإنسان فرضية، لا.. فكلام الإمام (عليه السلام) مقصوده غير هذا، بل هناك علاقة كما قلت ما بين الشرط والجزاء، يريد أن يصل الإمام (عليه السلام) إلى حالةٍ معيّنة، لأنّه سبق أن ذكرنا أنّ الإنسان العاصي هو مؤمن، يعني قلبه انطوى على التوحيد، هو مؤمن بالله، ومؤمن باليوم الآخر، لكن بسبب زلّة العصيان، وتارةً إنسان يعصي لأنّه غير معتقدٍ أصلاً بالله؟. ربّما أحدهم يشرب الخمر والعياذ بالله، وهو يعلم أنّ الخمر حرام، لكن يتناوله عصياناً، هو هنا بذنبه لا يخرج عن الدين، نعم يُعزَّر أو يُحدّ لأنّه ارتكب حراماً. وتارةً أخرى لا، هو يشرب الخمر لأنّه مستحلٌّ له، أي يقول إنّ الخمر حلال!!! أي أنّه يُنكر ضرورةً من ضرورات الدين!!! مع أن الخمر حرمته أشهر من نارٍ على علم، فهنا حين يستحلّها يعني يُنكر الحرمة، هذا حسابه غير الأوّل. الآن لدينا مجموعة من الذنوب طواها الإمام (عليه السلام) وبيّن نتائجها، هذه واحدة من النتائج "لو قرنتني بالأصفاد"، لاحظ ثانياً "ومنعتني سَيبَكَ من بين الأشهاد"، السَيب يعني العطاء، أي منعتني هذا العطاء، هذه الرحمة، هذه الشفقة من بين الأشهاد، أي أنّ أناساً شهوداً كثيرين عليَّ، لأنّ الشاهد يُسمّى كذلك لأنّه يراني، يعني يشهد عليَّ، أمّا إذا هو في حالةٍ غير حاله، فلا يعبّر عنه بشاهد، شاهدٌ يتعلّق بعمله، منعتني هذا العطاء، لماذا منعك العطاء؟ لأنّ الإنسان لا يستحقّه، والله سبحانه وتعالى هو محظَرُ الخير. نقرأ دائماً عبارة "بسم الله الرحمن الرحيم"، كلمة "الرحمن" هي المبالغة من الرحمة، والبعض يقول هذه رحمةٌ عامّة تشمل حتّى الكافر، نعم "الرحيم" لعلّها مختصّة بالمؤمنين خاصّة، فالله تعالى رحمنٌ ورحيم، فكيف يمنعني من عطائه؟!، هذه ليست من صفاته، وإنّما هذه صفة تتأثّر بذنبي، يعني أنا كنتُ سبب المنع، فالله منعني وليس من صفاته منعي ابتداءً، بل أنا هو السبب. الله تعالى يُعطي مَن سألَه ومَن لم يسأله، هكذا أدّبنا الأئمّة الأطهار(عليهم السلام)، بينما هنا يمنعني، إذن لا بُدّ أنّي قد عملتُ عملاً كبيراً بحيث استحققتُ هذا المنع، فحصل "ومنعتني"، هاتان اثنتان "قرنتني بالأصفاد" و "منعتني سيبك" فيها إذلال على رؤوس الأشهاد، وبعض العقوبات ليست عذاباً فقط، إنّما عذابٌ مقرون بتوهين، بإهانةٍ وعذابٍ مهين، جزء من الإهانة أن يكون العذاب أمام الآخرين، لم تمنعني بيني وبينك بل أمام الآخرين، هذا مهمّ. الآن هنا جنبتان للمنع، قال (ودَلَلتَ على فَضائِحي عُيونَ العباد)، وما شاء الله، العباد إذا رأوا منكراً لا يكتفون بالرؤية بقدر ما يتشمّتون، يقول "دللت على فضائحي". طبعاً الفضيحة لها حالة من الشأنيّة، يعني الإنسان يفعل مع الله فعلاً شنيعاً لكن لا يعلم به أحد، فهي فضيحة شأنيّة، بحيث أن الناس لو علمت به افتُضِح، وتارةً فضيحة واقعيّة وعمل سيّئ مع الله تعالى، والناس اطّلعت عليه، نحن مع الله تعالى دائماً مفضوحون، لا يوجد ساتر بيننا وبين الله تعالى، فهذا التعبير إشارة إلى شأنيّة مع الناس، لكن مع الله لا يوجد شيء شأنيّ، الآن أنا مفتَضَحٌ أمام الله، الله تعالى لا يوجد بيني وبينه ساتر، أقول أنا عملت هذا في السرّ وفي الليلة الظلماء، الله تعالى يقول إنّي رأيتك، أنت افتُضِحت أمامي، ظهر هذا العيب أمامي فلا يكون مستوراً، نعم.. أمام الآخرين مستور، الدعاء يقول هذه الفضيحة وهذا الذنب الذي هو أمامك، أنت زدته، أريتَ الناسَ عملي القبيح، دلَلتَ على هذه الفضيحة عيون الناس، عيونَ العباد، فهي من جهتك فضيحة، لأنّي أنا خرجت عن سلك العبودية فأذنبتُ أو سرقت. والإنسان تميل به النفس إلى الهوى، ويرتكب الذنب، مرّ كلام الإمام (عليه السلام) عندنا سابقاً، قال ما مضمونه أنّه سترك المُرخى، وطبيعةُ سترك لي، تشجّعني على ارتكاب الذنب!!، ألتفت يميناً أو يساراً لا أرى أحداً، هذه الطبيعة تشجّعني أن أرتكب الذنب!!، ثم –التفتْ- أنّي لم أجعلك أهونَ الناظرين، وهذا صعب. حين يجد الإنسان طفلاً مميّزاً للذنب، فلا يُذنب أمامه، لكن وحدي، بيني وبين الله أذنب!!، لأنّي جعلت الله أهون الناظرين!!! أنا أحتشم من هذا الطفل، لكن لا أحتشم من الله تعالى، فهل جعلتُ الله أهون الناظرين؟!! قل الله يرى، قل وإن؟!!!. يقول أنا لن أجعلك أهونَ الناظرين، لأنّ من الصعب أن يجعل الإنسان الله أهونَ الناظرين!!، وإنّما سبب المعصية هي سترك المُرخى، شِقوتي التي أعانتني، لكن عليّ أن أرجع. فالإنسان يُذنب، وهذا الذنب جعله يُمنَعُ العطاء، ما هو هذا الذنب؟ الإمام (عليه السلام) لم يبيّنه، لكن أنت منعتَنِي سَيبَكَ، ودلَلتَ على فضائحي عيون العباد، فإذا أنا كنتُ جريئاً، بحيث أنّ هذا الستر المُرخى عليّ قد انفضح، كأنّما (إذا ابتُلِيتُم بالمَعاصِي فاستَتِروا). الإنسان حين يجهر بالمعاصي، كأنّه يبارز الله سبحانه وتعالى، فالله لا يعجل بعجلة العباد، هذه تسويلات النفس، يعني الإنسان يحتقر نفسه في بعض الحالات، (قُتِلَ الإِنسانُ مَا أَكفَرَه)، يعني هل يتوقّع الإنسان أنّه ينجو أو يتحدّى الله تعالى؟!. الله تعالى لا يعجل بعجلة الإنسان، وهذه القوّة التي لدينا الآن مآلها في أرذل العمر، أنّ الإنسان لا يستطيع أن يرفع يده إلى فمه، لا يستطيع أن يأكل، ويكون أثقل ما يكون على أهله الذين أفنى عمره في سبيل أن يداريهم، ويبدأ العدّ التنازلي لحياته، ثمّ يقول يا الله يا الله، محاولاً تدارك ذنوبه، وليس معلوماً أن مثل هذا الإنسان متى تدركه التوبة؟!!. بعض المعاصي ينبّه عنها الإمام الصادق(عليه السلام) بطريقةٍ ما، فهذا الذي كان يسمع الغناء يقول له الإمام: (ما أسوأ حالك لو متّ على ذلك)، غريبة هذه العبارة من الإمام (عليه السلام)، ما أسوأ حالك لو متّ على ذلك؟!. رأى رجلاً جلس أمام رجلٍ كثير المعاصي، الإمام (عليه السلام) نبّهه فقال ما مضمونه: تجلس معه إذا نزلت الصاعقة؟!، فأنت تكون معه!! لحظات. الآن المعاصي كثيرة، الإنسان في لحظةٍ معيّنة لا بُدّ أن يلتفت لنفسه. يقول الدعاء: "دللتَ على فضائِحي عيون العباد"، عن ثلاثة، قرن بالأصفاد، مجرم -كما قلنا في الآية- (وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ)، والله منع السَيبَ مع أنّه رحمنٌ رحيم، فلا بُدّ أنّي عملتُ عملاً استوجب أن يمنعني الله تعالى رحمته، ثمّ فضَحَني على عيون الناس. رابعاً.. قال (وأمَرتَ بي إلى النار)، هذه نهايةٌ سيّئة، أمرتَ بي إلى النار. لاحظوا إخواني، هذه نتيجة مقدّماتٍ كثيرة، الله تعالى عندما يأمر بالعبد إلى النار، يعني أنّ هذا العبد استوجب دخول النار، لم تنفعه رحمة الله ولا شفاعة الشافعين، لا يوجد عنده عمل يتقرّب به إلى الله ليظهره أمام الله في تلك اللحظات، وأنّ الله أمر به إلى النار، النار إلى مَن أُعِدّت؟ ما أُعِدّت للمتّقين! النار أُعِدّت للكافرين، وأُعِدّت للمجرمين، فمعنى ذلك أنّ الإنسان كلّ ما عنده قد استنفده دون أن يُنقذ نفسه، فاستوجب أن يذهب إلى النار، عبارة مختصرة لكنّها مطويّةٌ على مقدّماتٍ كثيرة. (إنّي لأعجبُ ممّن هلكَ كيفَ هلك؟) مضمون قول الإمام السجّاد(عليه السلام) جواباً إلى الحسن البصري، وذلك لأنّ رحمة الله موجودة، شفاعة النبيّ(صلّى الله عليه وآله) موجودة، الحسنة بعشر أمثالها والحسنات موجودة، شفاعة جميع من عنده من المؤمنين، مصادقة ناس مؤمنين يشفعون له، وغيرها من أعمال البرّ، يبدو أنّ كلّ ذلك قد استنفده واستوجَبَ دخول النار!!. أمرٌ صعب أن يؤمرَ بالإنسان إلى النار، الله تعالى يحاول أن يُنجينا يومَ القيامة، والحساب هناك دقيق وليس حساباً سهلاً، رحمة الله موجودة وكلّ الخلائق والملائكة والنبيّ(صلّى الله عليه وآله) كلّها عناصر نجاةٍ موجودة، وهذا المذنب المسكين ليس لديه شيءٌ لينجو!!! وحين تقطّعت الأسباب، أمرَ الله تعالى به إلى النار، هذه النقطة الرابعة. خامساً، قال (وحُلتَ بَينِي وبَينَ الأبرار)، حُلتَ يعني جَعلتَ هناك حائلاً لا أرى الأبرار، فلماذا؟ لأنّ الأبرار ليس مسكنهم النار، الأبرار مسكنهم الجنّة، فالآن أنت قرنتني بالأصفاد، وهذه كلّها لا بُدّ أن العبد مستحقٌّ لها، ومنعتَ عطاءك على رؤوس الأشهاد، يعني أيضاً فضيحة، وبيني وبينك أعمالٌ وذنوبٌ أيضاً، وفَضحتَنِي أمامَ الناس، دَللتَ عليها عيون الناس، بعدها أَمرتَ بي إلى النار، بعد ذلك حُلتَ بيني وبينَ الأبرار، إذن هذا العبد، كلّ هذه الأشياء هي حرمانه من نعيم الله تعالى. إذا كان العبد مستوجباً ليفعل الله تعالى به هذه الأفاعيل، هل هناك أمل؟ هل يأمن الإنسان على نفسه في الآخرة بلا عمل؟! الجواب: لا!. الأمل ناشئٌ عن اعتقاد، هذا الذي أقوله، فلا بُدّ من وجود علاقةٍ بين الشرط والجزاء، ليس أملاً أن تقول (لو كنتُ غنيّاً لطار الطائر)! فأيّ ربطٍ بينهما؟! بل هذا الذي فعلته أنت بي يا ربّي وأنا مستحقّه فيه نتيجة، فما هي؟ قال (ما قطعتُ رجائي منكَ وما صرفتُ تأميلي للعفو عنك)، يعني لم أصرف نفسي عنك، (ولا خرَجَ حبّكَ من قلبي). هذه خمسة أمور لو حدثت معي وكلّها فيها استحقاق، سأقابلك يا إلهي مع ذلك بشيءٍ أستمطر فيه رحمتك. لا أيأس، الرجاء من الصفات الممدوحة، على الإنسان أن يتّكل راجياً الله تعالى، وأن لا يخرج هذا من قلبه، أن يبقى دائماً يرجو تلك اللحظات التي يُنقذُه الله سبحانه وتعالى فيها. فحتى لو فعل الله بي هذه الأفاعيل، قرنتني، منعتني، أنت دَلَلتَ، أنت أمرتَ بي للنار، أنت حُلتَ بيني وبين الأبرار، كلّ هذه استحقاقي، لكنّي مع ذلك ادّخرتُ شيئاً لعلّك به ترحمني، وهذا منتهى الأمل، لأنّه -كما ذكرنا- حتى الذين يدخلون النار يوجد لديهم أمل أن يخرجوا منها، ولله تعالى في هذه الأمور استحقاقات، لكن تبقى الرحمة -كما قلنا- تسبق الغضب، فإذا أنا ادّخرتُ شيئاً عظيماً مهمّاً، لا أتنازل عنه. وكأنّ لسان حالي يقول، سأبقى مع ذلك أستعمل الخيارات الأُخَر الرابحة، كما نقول، هناك خيارات خسرناها، فعليه أستعمل آخر الخيارات الرابحة وهي الرجاء، لعلّها تكون سبباً في نجاتي، وهذا مهمّ سنأتي إليها إن شاء الله تعالى أن أبقانا الله في الغد، والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على محمّدٍ وعلى آله الطيّبين الطاهرين. رابط الحلقة كاملة:
https://www.youtube.com/watch?v=GCDnWwCZs-A