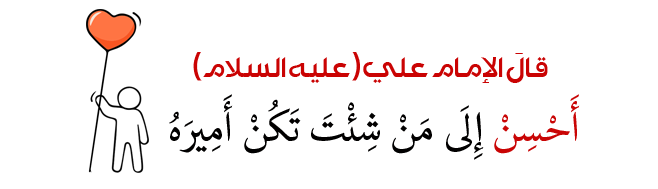
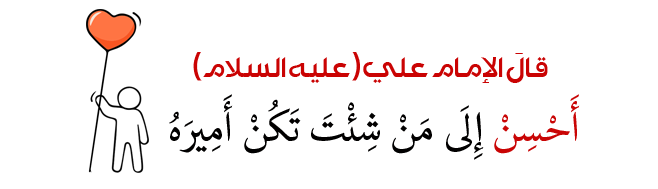

 المسائل الفقهية
المسائل الفقهية
 الطهارة
الطهارة
 احكام الاموات
احكام الاموات 
 التيمم (مسائل فقهية)
التيمم (مسائل فقهية)
 الجنابة
الجنابة 
 الطهارة من الخبث
الطهارة من الخبث 
 الوضوء
الوضوء
 الصلاة
الصلاة
 مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
 افعال الصلاة (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
 الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
 الصوم
الصوم 
 الاعتكاف
الاعتكاف
 الحج والعمرة
الحج والعمرة
 الجهاد
الجهاد
 الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
 الخمس
الخمس 
 الزكاة
الزكاة 
 زكاة الفطرة
زكاة الفطرة 
 ماتكون فيه الزكاة
ماتكون فيه الزكاة 
 علم اصول الفقه
علم اصول الفقه
 الاصول العملية
الاصول العملية 
 المصطلحات الاصولية
المصطلحات الاصولية 
 القواعد الفقهية
القواعد الفقهية
 المصطلحات الفقهية
المصطلحات الفقهية
 الفقه المقارن
الفقه المقارن
 كتاب الطهارة
كتاب الطهارة 
 احكام الاموات
احكام الاموات
 احكام التخلي
احكام التخلي
 الاعيان النجسة
الاعيان النجسة
 الوضوء
الوضوء
 المطهرات
المطهرات
 الحيض و الاستحاظة و النفاس
الحيض و الاستحاظة و النفاس
 كتاب الصلاة
كتاب الصلاة 
 افعال الصلاة
افعال الصلاة
 الصلوات الواجبة والمندوبة
الصلوات الواجبة والمندوبة
 كتاب الزكاة
كتاب الزكاة 
 ماتجب فيه الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
 زكاة الفطرة
زكاة الفطرة
 كتاب الصوم
كتاب الصوم 
 كتاب الحج والعمرة
كتاب الحج والعمرة
 اعمال منى ومناسكها
اعمال منى ومناسكها |
أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-9-2016
التاريخ: 2024-07-07
التاريخ: 4-1-2020
التاريخ: 21-9-2016
|
إذا غربت الشمس، من يوم عرفة، فليفض الحاج، من عرفات إلى المزدلفة وإن أفاض بعد غروب الشمس، لم يكن عليه إثم، إذا أدرك المشعر الحرام في وقته، ووقته من طلوع الفجر، من يوم النحر، إلى طلوع الشمس، من ذلك اليوم، وذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه، إلى أنّ وقت المشعر، ليلة العيد (1) وهو مذهب المخالفين، والأول هو المذهب، وهو اختياره في نهايته (2) ولا يجوز الإفاضة قبل غيبوبة الشمس، فمن أفاض قبل مغيبها متعمدا، كان عليه بدنة، فإن عاد إليها قبل مغيبها ثم أفاض عند مغيبها لم يكن عليه كفارة.
والبدنة، ينحرها يوم النحر، بمنى، فإن لم يقدر على البدنة، صام ثمانية عشر يوما، إمّا في الطريق، أو إذا رجع إلى أهله.
وإن كانت الإفاضة قبل مغيب الشمس، على طريق السهو، أو يكون جاهلا، بأن ذلك لا يجوز، لم يكن عليه شيء.
فإذا أراد أن يفيض ، فيستحب له أن يقول: (اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف، وارزقنيه أبدا ما أبقيتني، واقلبني اليوم، مفلحا، منجحا، مستجابا لي، مرحوما، مغفورا، بأفضل ما ينقلب به اليوم، أحد من وفدك عليك وأعطني أفضل ما أعطيت أحدا منهم، من الخير، والبركة، والرحمة، والرضوان، والمغفرة، وبارك لي، فيما أرجع إليه، من مال، أو أهل، أو قليل، أو كثير، وبارك لهم في) واقتصد في السير، وسر سيرا جميلا، فإذا بلغت إلى الكثيب الأحمر، عن يمين الطريق، فقل: (اللهم ارحم موقفي، وزد في عملي، وسلّم لي ديني، وتقبل مناسكي).
ويستحب ألا يصلي المغرب والعشاء الآخرة، إلا بالمزدلفة، وإن ذهب من الليل ربعه، أو ثلثه.
ويستحب له أن يجمع بين الصلاتين، بالمزدلفة ليلة النحر، بأذان واحد، وإقامتين، وحدّ الجمع، ألا يصلّي بينهما، نوافل، فإن فصل بين الفرضين بالنوافل، لم يكن مأثوما، غير أنّ الأفضل ما قدّمناه.
وحدّ المشعر الحرام، ما بين المأزمين، بكسر الزاء، إلى الحياض، وإلى وادي محسّر، فلا ينبغي أن يقف الإنسان، إلا فيما بين ذلك، فإن ضاق عليه الموضع، جاز له أن يرتفع إلى الجبل، فإذا أصبح يوم النّحر، صلّى فريضة الغداة، ووقف للدعاء، وليحمد الله تعالى، وليثن عليه، وليذكر من آلائه، وحسن بلائه، ما قدر عليه، ويصلّي على النبي صلى الله عليه وآله.
ويستحب للصرورة، وهو الذي لم يحج، إلا تلك السنة، أن يطأ المشعر برجله.
وإن كان الوقوف واجبا عليه، وركنا من أركان الحج عندنا، من تركه متعمدا، فلا حج له، وأدناه، أن يقف بعد طلوع الفجر، إمّا قبل صلاة الغداة، أو بعدها، بعد أن يكون قد طلع الفجر الثاني، ولو قليلا، والدعاء، وملازمة الموضع، إلى طلوع الشمس مندوب، غير واجب.
وإذا طلعت الشمس، رجع إلى منى، ورجوعه الآن إلى منى واجب، لأنّ عليه بها يوم النحر، ثلاثة مناسك، مفروضة.
ويكره له أن يجوز وادي محسّر، إلا بعد طلوع الشمس، ولا يجوز الخروج من المشعر الحرام، قبل طلوع الفجر، للمختار، فان خرج قبل طلوعه متعمدا، فلا حج له، وقال شيخنا أبو جعفر، في نهايته: كان عليه دم شاة (3).
والصحيح الأوّل، وما ذكره رحمه الله، خبر واحد، أورده إيرادا، لا اعتقادا، والذي يدل على صحة ما قلناه، أن الوقوف بالمشعر الحرام، في وقته ركن من أركان الحج، بغير خلاف بيننا، ولا خلاف أنّه، من أخلّ بركن من أركان الحج متعمدا، بطل حجه، فإن كان خروجه ساهيا، أو ناسيا، لم يكن عليه شيء.
وقد رخص للمرأة، والرجل، الذي يخاف على نفسه، أن يفيضا إلى منى، قبل طلوع الفجر، فإذا بلغ وادي محسّر، فليهرول فيه، حتى يقطعه، وذلك على طريق الاستحباب، فإن كان راكبا، حرّك مركوبه.
ويستحب له أن يأخذ حصى الجمار من المشعر الحرام، ليلة النحر، وإن أخذه من منى، ومن سائر الحرم، كان أيضا جائزا، سوى المسجد الحرام، ومسجد الخيف، ومن حصى الجمار، ولا يجوز أخذ الحصى من غير الحرم، ولا يجوز أن يرمي الجمار، الا بالحصى، فحسب.
وقال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه: لا يجوز الرمي، إلا بالحجر، وما كان من جنسه، من البرام، والجوهر، وأنواع الحجارة، ولا يجوز بغيره كالمدر، والآجر، والكحل، والزرنيخ، والملح، وغير ذلك، من الذهب، والفضة (4) إلى هاهنا آخر كلامه.
وما ذكرناه، هو الصحيح، لأنّه لا خلاف في إجزائه، وبراءة الذمة معه، وما عدا الحصى، فيه الخلاف، وروي عنه عليه السلام، أنّه قال غداة جمع، التقط حصيات من حصى الخذف، فلما وضعهن في يده، قال: بأمثال هؤلاء، فارموا، بأمثال هؤلاء فارموا، ومثل الحصى حصى (5). وروي أنّه قال عليه السلام، لمّا هبط مكان محسّرا: أيّها الناس عليكم بحصى الخذف (6) وقد رجع شيخنا أبو جعفر، في جمله وعقوده، عما ذكره في مسائل خلافه، فقال: لا يجزي غير الحصار (7).
ويكره أن تكون صما، ويستحب أن تكون برشا، ويستحب أن يكون قدرها، مثل الأنملة، منقطة، كحلية، ويكره أن يكسر من الحصى شيء، بل يلتقط بعدد ما يحتاج الإنسان إليه، ويستحب ألا ترمي، إلا على طهر، فإن رميت على غير طهر، لم يكن عليه شيء.
فإذا رماها، فإنه يجب أن يرميها خذفا، والخذف عند أهل اللسان، رمي الحجر، بأطراف الأصابع، هكذا ذكره الجوهري في كتاب الصحاح، يضع كل حصاة منها، على بطن إبهامه، ويدفعها بظفر السبّابة، ويرميها من بطن الوادي.
وينبغي أن يرمي يوم النحر، جمرة العقبة، وهي التي إلى مكة، أقرب، بسبع حصيات، يرميها من قبل وجهها، وحدها ذلك اليوم فحسب.
ويستحب أن يكون بينه وبين الجمرة، قدر عشرة أذرع، إلى خمسة عشر ذراعا، ويقول حين يريد أن يرمي، الحصى: (اللهم هؤلاء حصياتي، فأحصهن لي، وارفعهن في عملي) ويقول مع كل حصاة: (اللهم أدحر عني الشيطان، اللهم تصديقا بكتابك، وعلى سنة نبيّك، صلى الله عليه وآله، اللهم اجعله حجا مبرورا، وعملا مقبولا وسعيا مشكورا، وذنبا مغفورا).
ويجوز أن يرميها راكبا، وماشيا، والركوب أفضل، لأنّ النبي صلى الله عليه وآله رماها راكبا، ويكون مستقبلا لها، مستدبرا للكعبة، وإن رماها عن يسارها، جاز.
وجميع أفعال الحج، يستحب أن يكون مستقبل القبلة، من الوقوف بالموقفين، ورمي الجمار، إلا رمي جمرة العقبة، يوم النحر، فحسب.
ولا يأخذ الحصى، من المواضع التي تكون فيها نجاسة، فإن أخذها، وغسلها، أجزأه وإن لم يغسلها، ترك الأفضل، وأجزأه، لأنّ الاسم يتناولها.
__________________
(1) النهاية: كتاب الحج، باب الإفاضة من عرفات والوقوف بالمشعر الحرام.
(2) النهاية: كتاب الحج، باب الإفاضة من عرفات والوقوف بالمشعر الحرام.
(3) النهاية: كتاب الحج باب الإفاضة من عرفات والوقوف بالمشعر الحرام.
(4) الخلاف: كتاب الحج، مسألة 163.
(5) الخلاف: ذيل مسألة 163.
(6) الخلاف: ذيل مسألة 163.
(7) الجمل والعقود: كتاب الحج، فصل في نزول منى وقضاء المناسك بها، رقم 4.



|
|
|
|
تحذير من "عادة" خلال تنظيف اللسان.. خطيرة على القلب
|
|
|
|
|
|
|
دراسة علمية تحذر من علاقات حب "اصطناعية" ؟!
|
|
|
|
|
|
|
شركة اللواء العالمية تعرض منتجاتها في الأسبوع الزراعي السادس عشر في بغداد
|
|
|