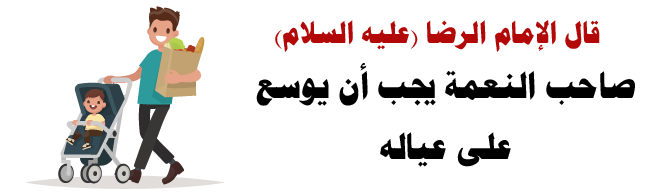
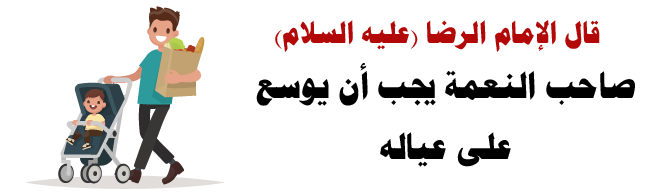

 النحو
النحو
 الصرف
الصرف
 المدارس النحوية
المدارس النحوية
 المدرسة البصرية
المدرسة البصرية
 جهود علماء المدرسة البصرية
جهود علماء المدرسة البصرية
 المدرسة الكوفية
المدرسة الكوفية
 جهود علماء المدرسة الكوفية
جهود علماء المدرسة الكوفية
 الخلاف بين البصريين والكوفيين
الخلاف بين البصريين والكوفيين
 المدرسة البغدادية
المدرسة البغدادية
 جهود علماء المدرسة البغدادية
جهود علماء المدرسة البغدادية
 المدرسة المصرية
المدرسة المصرية
 جهود علماء المدرسة المصرية
جهود علماء المدرسة المصرية
 المدرسة الاندلسية
المدرسة الاندلسية
 جهود علماء المدرسة الاندلسية
جهود علماء المدرسة الاندلسية
 اللغة العربية
اللغة العربية 
 فقه اللغة
فقه اللغة
 جهود القدامى والمحدثين ومؤلفاتهم في فقه اللغة
جهود القدامى والمحدثين ومؤلفاتهم في فقه اللغة
 اللغة ونظريات نشأتها
اللغة ونظريات نشأتها
 نظريات تقسيم اللغات
نظريات تقسيم اللغات
 فصائل اللغات الجزرية (السامية - الحامية)
فصائل اللغات الجزرية (السامية - الحامية)
 تقسيم اللغات السامية (المشجر السامي)
تقسيم اللغات السامية (المشجر السامي)
 اللهجات العربية
اللهجات العربية
 خصائص اللغة العربية
خصائص اللغة العربية
 الاشتقاق
الاشتقاق
 الخط العربي
الخط العربي
 أصوات اللغة العربية
أصوات اللغة العربية
 المعاجم العربية
المعاجم العربية
 علم اللغة
علم اللغة
 مناهج البحث في اللغة
مناهج البحث في اللغة
 علم اللغة والعلوم الأخرى
علم اللغة والعلوم الأخرى
 مستويات علم اللغة
مستويات علم اللغة
 تكون اللغات الانسانية
تكون اللغات الانسانية
 علم الدلالة
علم الدلالة 
 جهود القدامى في الدراسات الدلالية
جهود القدامى في الدراسات الدلالية 
 التطور الدلالي
التطور الدلالي
 المشكلات الدلالية
المشكلات الدلالية
 نظريات علم الدلالة الحديثة
نظريات علم الدلالة الحديثة|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-7-2016
التاريخ: 19-7-2016
التاريخ: 21-7-2016
التاريخ: 19-7-2016
|
الاشتقاق
1 ـ تعريفه: الاشتقاق في اللغة هو (أخذ شق الشيء وهو نصفه، والاشتقاق الأخذ في الكلام وفي الخصومة يمينا وشمالا مع ترك القصد. واشتقاق الحرف من الحرف أخذه منه). أما في الاصطلاح، فقد أعطي الاشتقاق تعريفات عدة، منها: (اقتطاع فرع من أصل، يدور في تصاريفه حروف ذلك الأصل)، و (أخذ كلمة من أخرى بتغيير ما، مع التناسب في المعنى)، و (رد كلمة إلى أخرى لتناسبهما في اللفظ والمعنى)، و (نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معنى وتركيبا ومغايرتهما في الصيغة) ... إلخ. وقد ذكر التهانوي شروط الاشتقاق واختلاف الناس فيه، فقال: (اعلم أنه لا بد في المشتق، اسما كان أو فعلا، من أمور أحدها أن يكون له أصل، فإن المشتق فرع مأخوذ من لفظ آخر، ولو كان أصلا في الوضع غير مأخوذ من غيره لم يكن مشتقا. وثانيها أن يناسب المشتق الأصل في الحروف، إذ الأصالة والفرعية، باعتبار الأخذ، لا تتحققان بدون التناسب بينهما، والمعتبر المناسبة في جميع الحروف الأصلية، فإن الاستباق من السبق مثلا، يناسب الاستعجال من العجل، في حروفه الزائدة
والمعنى، وليس مشتقا منه بل من السبق.
وثالثها المناسبة في المعنى، سواء لم يتفقا فيه أو اتفقا فيه، وذلك الاتفاق بأن يكون في المشتق معنى الأصل، إما مع زيادة كالضرب فإنه للحدث المخصوص والضارب فإنه لذات ما له ذلك الحدث، وإما بدون زيادة سواء كان هناك نقصان كما في اشتقاق الضرب من ضرب على مذهب الكوفيين، أو لا بل يتحدان في المعنى كالمقتل مصدر من القتل. والبعض يمنع نقصان أصل المعنى في المشتق، وهذا هو المذهب الصحيح. وقال البعض لا بد في التناسب من التغاير من وجه، فلا يجعل المقتل مصدرا مشتقا لعدم التغاير بين المعنيين، وتعريف الاشتقاق يمكن حمله على جميع هذه المذاهب).
2 ـ أنواعه: كانت دائرة الاشتقاق، حتى النصف الأخير من القرن الرابع الهجري، لا تتعدى الكلمات المتناسبة في اللفظ والمعنى مع ترتيب الحروف، وهذا ما يسمى بالاشتقاق الصغير أو الأصغر. لكن ابن جني أضاف إليه في أواخر القرن الرابع الهجري، بابا آخر يشمل الكلمات المشتقة من تقاليب اللفظة الواحدة، مفترضا أن هذه الكلمات تشترك في معنى عام. كما أن الحاتمي اعتبر إبدال الحروف من الاشتقاق. فأصبحت أنواع الاشتقاق ثلاثة، أضاف إليها أحد المعاصرين نوعا رابعا هو باب النحت مطلقا عليه اسم (الاشتقاق الكبار). وسنتناول بالدراسة كلا من هذه الأنواع الأربعة.
الاشتقاق الأصغر
هو الاشتقاق الصغير.
راجع: الاشتقاق الصغير.
الاشتقاق الأكبر
هو القلب اللغوي، والقلب الصرفي.
راجع: القلب اللغوي، والقلب الصرفي.
الاشتقاق الصغير
1 ـ تعريفه: الاشتقاق الصغير أو الأصغر، أو العام هو (نزع لفظ من آخر آصل منه، بشرط اشتراكهما في المعنى والأحرف الأصول وترتيبها). كاشتقاقك اسم الفاعل (قاتل)، واسم المفعول (مقتول)، والفعل (تقاتل) وغيرها من المصدر (القتل) على رأي البصريين، أو من الفعل (قتل) على رأي الكوفيين.
وهذا النوع من الاشتقاق هو أكثر أنواع الاشتقاق ورودا في العربية، وأكثرها أهمية، وعليه تجري كلمة (اشتقاق)، إذا أطلقت دون تقييد).
2 ـ تقسيم اللغات بالنسبة إليه: تقسم اللغات بالنسبة لهذا النوع من الاشتقاق إلى ثلاث فئات :
أ ـ اللغات الفاصلة: (setnalosi) وهي التي تحافظ فيها الكلمة المفردة على شكل واحد مهما اختلفت وظائفها في الجملة، ومنها اللغة الصينية. فإذا كان الضمير (أنا) في العربية، يصبح (ت) في نحو: (أكلت)، و (ني) في نحو (كافأني)، و (ي) في نحو (كتابي)، فإن الصيني يقول :
(أكل أنا ـ كافأ أنا ـ كتاب أنا). أي إن الضمير في اللغة الصينية لا يتغير من حالة الرفع إلى النصب إلى الجر بالإضافة.
ب ـ اللغات اللاصقة: (sevitamitullga) وهي التي تضيف إلى أوائل الكلمات الأصلية فيها صدورا أو سوابق (prefixes)، وإلى أواخرها كواسع أو لواحق (suffixes) (وقد احتفظت اللغة الإنكليزية ببعض خصائص هذه الفئة من اللغات (1).
3 ـ اللغات المتصرفة
، وهي التي نستطيع أخذ صيغ مختلفة من المادة الواحدة منها، للدلالة على المعاني المختلفة. ومنها اللغات الهنود ـ أوروبية، واللغات السامية التي منها اللغة العربية (2).
واختلف البصريون والكوفيون في أصل الاشتقاق، فقال البصريون: إن المصدر هو أصل الاشتقاق، وإن الفعل مشتق منه.
وذهب الكوفيون إلى عكس ذلك وكان لكل منهما حجج منطقية تؤيد وجهة نظره.
وتتلخص حجج البصريين بما يلي :
1 ـ إن المصدر يدل على زمان مطلق، أما الفعل فيدل على زمان معين. وكما أن المطلق أصل للمقيد، فكذلك المصدر أصل للفعل.
2 ـ إن المصدر اسم، والاسم يقوم بنفسه، ويستغني عن الفعل، لكن الفعل لا يقوم بنفسه، بل يفتقر إلى الاسم، وما يستغني بنفسه ولا يفتقر إلى غيره أولى بأن يكون أصلا مما لا يقوم بنفسه ويفتقر إلى غيره.
3 ـ إن المصدر إنما سمي كذلك لصدور الفعل عنه.
4 ـ إن المصدر يدل على شيء واحد وهو الحدث، أما الفعل فيدل بصيغته على شيئين: الحدث والزمان المحصل. وكما أن الواحد أصل الاثنين فكذلك المصدر أصل الفعل.
5 ـ إن المصدر له مثال واحد نحو (الضرب)، و (القتل)، والفعل له أمثلة مختلفة، كما أن الذهب نوع واحد وما يوجد منه أنواع وصور مختلفة.
6 ـ إن الفعل يدل بصيغته على ما يدل عليه المصدر. فالفعل (ضرب) مثلا يدل على ما يدل عليه (الضرب) الذي هو المصدر، وليس العكس صحيحا. لذلك
كان المصدر أصلا والفعل فرعا، لأن الفرع لا بد وأن يكون فيه الأصل.
7 ـ لو كان المصدر مشتقا من الفعل لكان يجب أن يجري على سنن في القياس، ولم يختلف كما لم يختلف أسماء الفاعلين والمفعولين، ولوجب أن يدل على ما في الفعل من الحدث والزمان، وعلى معنى ثالث، كما دلت أسماء الفاعلين والمفعولين على الحدث وذات الفاعل والمفعول به، فلما لم يكن المصدر كذلك دل على أنه ليس مشتقا من الفعل.
وأما حجج الكوفيين فأهمها ما يلي :
1 ـ إن المصدر يصح لصحة الفعل ويعتل لاعتلاله نحو: قاوم قواما وقام قياما.
2 ـ إن الفعل يعمل في المصدر نحو: ضربت ضربا. وبما أن رتبة العامل قبل رتبة المعمول، وجب أن يكون المصدر فرعا على الفعل.
3 ـ إن المصدر يذكر تأكيدا للفعل، نحو: ضربت ضربا. ورتبة المؤكد قبل رتبة المؤكد.
4 ـ إن ثمة أفعالا لا مصادر لها وهي: نعم، بئس، عسى، ليس، فعلا التعجب، وحبذا، فلو كان المصدر أصلا لما خلا من هذه الأفعال، لاستحالة وجود الفرع من غير أصل.
5 ـ إن المصدر لا يتصور معناه ما لم يكن فعل فاعل، والفاعل وضع له (فعل) و (يفعل)، فينبغي أن يكون الفعل الذي يعرف به المصدر أصلا للمصدر.
والواقع أن أصل الاشتقاق في اللغة العربية ليس واحدا، فقد اشتق العرب من الأفعال والأسماء (الجامد منها والمشتق)، والحروف، ولكن بأقدار، فأكثر ما اشتق منه الأفعال، ثم الأسماء، فالحروف.
فقد اشتقوا من الأفعال أفعالا، فقالوا: (يعلم)، و (اعلم)، و (تعالم)، و (تعلم)، و (استعلم) من (علم)، كما اشتقوا منها أسماء، فقالوا: (عالم) و (معلوم) من (علم).
كذلك اشتقوا من الأسماء أسماء، فقالوا: (فارس) من (الفرس)، و (تامر) (صاحب التمر) من (التمر)، و (مسؤولية) من (مسؤول)، كما اشتقوا منها أفعالا، فقالوا: (برق) من (البرق)، و (استحجر) من (الحجر).
وكذلك اشتقوا من الحروف أفعالا، فقالوا: (لاليت لي) (أي: قلت: لالا) من الحرف (لا)، و (فأفأت) (تلعثمت في النطق بالحرف الفاء) من الحرف الفاء كما اشتقوا منها أسماء، فقالوا: (الفأفأة) (التلعثم في النطق بالحرف الفاء) من الفاء.
وكذلك اشتقوا من الجملة، فقالوا: (بسمل) و (البسملة) من (باسم الله) ،
و (حمدل) و (الحمدلة) من (الحمد لله)، وهذا ما يعرف بالنحت.
راجع: النحت.
الاشتقاق العام
هو الاشتقاق الصغير.
راجع: الاشتقاق الصغير.
الاشتقاق الكبار أو الكبار
هو النحت.
راجع: النحت
الاشتقاق الكبير
هو القلب اللغوي.
راجع: القلب اللغوي.
الاشتقاق المركب
هو، في الاصطلاح، أخذ كلمة من أخرى مشتقة نحو: (تمسكن) (من (مسكين))، وهي بدورها مشتقة من: (سكن).
الاشتقاق النحتي
هو، في الاصطلاح، النحت.
__________________
(1) فهي تضيف، مثلا، إلى جذر form السوابق الآتية: de, per, in, con, re وغيرها، فيتغير المعنى تبعا لمعنى السابقة غير أن الجذر form لا يتغير.
(2) عن فقه اللغة العربية وخصائصها للدكتور اميل يعقوب ص 188 ـ 190.
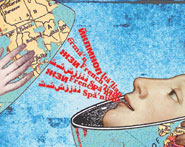


|
|
|
|
مقاومة الأنسولين.. أعراض خفية ومضاعفات خطيرة
|
|
|
|
|
|
|
أمل جديد في علاج ألزهايمر.. اكتشاف إنزيم جديد يساهم في التدهور المعرفي ؟
|
|
|
|
|
|
|
العتبة العباسية المقدسة تقيم ندوة علمية عن روايات كتاب نهج البلاغة
|
|
|