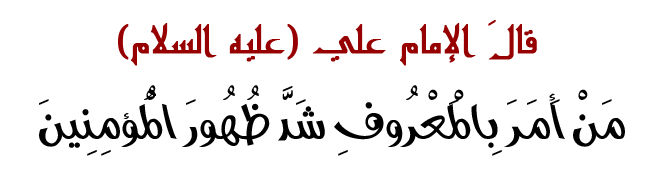
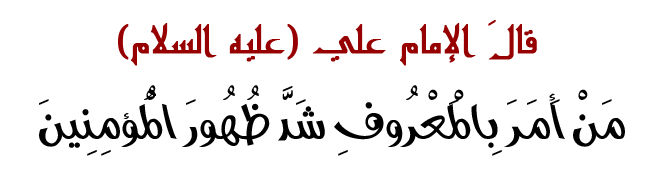
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-03-2015
التاريخ: 31-7-2019
التاريخ: 24-03-2015
التاريخ: 24-03-2015
|
ظلت الموضوعات القديمة المألوفة من مدح وغير مدح وهجاء تسيطر على الشعر والشعراء، وكأنما كان هناك إصرار قوى أن تظل للشعر العربي شخصيته وموضوعاته وأن يظل حيّا على الألسنة مع حياة الأمة، فلا يضعف ولا يذوى عوده، بل يقوى ويزدهر، غير متحوّل عن أصوله، مهما غذّته الثقافات الفلسفية وغير الفلسفية ومهما عبّر عن الحضارة العربية الحديثة، فهو موصول دائما بقديمه، شأنه في ذلك شأن الآداب الحية التي لا تنقطع صلتها بماضيها، مهما وقع عليها وعلى أهلها من تأثيرات حضارته وثقافته، إذ تظل متصلة بها اتصالا يمكّن لها في التاريخ وفى الخلود. وحقّا تنعكس على موضوعات الشعر حينئذ آثار حضارية وثقافية كثيرة، ولكنها لا تحدث تعديلا في جوهرها، فجوهرها ثابت، إنما تحدث بعض إضافات تكثر وتقل حسب ملكات الشعراء وحسب ما كانوا يتغذون به من الثقافات وما كان يداخلهم من إعجاب إزاء مظاهر الحضارة الجديدة.
وأول ما نتحدث عنه من الموضوعات المديح، ومعروف أن الشاعر الجاهلي كان يصوّر فيه المثل الخلقي الرفيع في عصره، من الكرم والشجاعة والوفاء وحماية الجار والحلم والحزم وإباء الضيم وحصافة العقل، حتى إذا كان العصر الإسلامي أخذ الشاعر يضيف إلى هذه المثالية الدين، وخاصة إذا كان يمدح خليفة، وكانوا يسجلون أعمال الخلفاء والولاة وما ينشرون من الأمن والعدالة التي لا تطيب حياة الناس بدونها، وسجلوا أيضا مواقع القواد مع الترك وغيرهم وبطولاتهم الحربية المختلفة. وبذلك كانت المدحة في العصرين الجاهلي والإسلامي تشتمل بما تعرض من مثاليات على أسس قويمة خلقية ودينية لتربية الشباب، كما كانت تشتمل على أعمال الدولة وأمجاد العرب الحربية. وكل ذلك اضطرم اضطراما في المدحة عند
ص204
شعراء العصر العباسي الأول، مع محاولاتهم الجادة في التطور بمعاني المديح عمقا وسعة وتنوعا، وظلت رغباتهم ومحاولاتهم في هذه الإضافة تزداد خصبا في هذا العصر، وهم في ذلك لا ينسون مثالية المديح الموروثة، فإذا مدحوا خليفة أو واليا أو قائدا تمثلوا فيه الفضائل العربية مرسومة، وكذلك الفضائل الإسلامية، وتمثلوا أيضا العدل الذي يعصم الحاكم من الطغيان ويعصم الشعب من العبث والظلم والفساد.
ويتردد ذلك دائما على ألسنة الشعراء من مثل قول البحتري في المتوكل، وكان اسمه جعفرا (1):
خلق الله جعفرا قيّم الدّن … يا سدادا وقيّم الدين رشدا
أظهر العدل فاستنارت به الأر … ض وعمّ البلاد غورا ونجدا
وقد مضى الشعراء يضفون هذه المثالية على الخلفاء في الحكم وفى التقوى وأيضا في الخلق والشيم، مهما كانت سيرتهم وكأنهم لم يكونوا يفكرون فيهم من حيث هم إنما كانوا يفكرون فيهم من حيث خلافتهم وقيامهم على حكم الرعية، وهم لذلك يرفعون أمام أعينهم ما ينبغي أن يكون عليه الخليفة في خلقه وفى دينه وفى سيرته وفى حكمه، وكأنما هو رمز، رمز للأمة في حاكمها الرشيد، وهم يبرزونه لها بالصورة التي تريدها ويريدونها معها، صورة الحاكم المخلص الأمين الذي ينكر الظلم أشد الإنكار، والذي يعمل بكل ما في وسعه على إشاعة العدالة بين أفراد رعيته حتى يتساووا في الانتفاع بالحياة تساويا تامّا. وكان هناك من يبالغون في مديح الخلفاء حتى ليضفون عليهم صفات قدسية، وهي صفات خلعها شعراء الشيعة على أئمتهم منذ عصر بني أمية، وأخذ شعراء الخلفاء من حينئذ يستعيرونها ليسبغوها بدورهم على الخلفاء الأمويين والعباسيين، من مثل قول ابن الجهم في المتوكل (2):
إمام هدى جلّى عن الدين بعد ما … تعادت على أشياعه شيع الكفر
وقوله (3):
له المنّة العظمى على كل مسلم … وطاعته فرض من الله منزل
ص205
فهو الهادي المهدي الذي تجب طاعته على جميع المسلمين، وكان الشعراء من وراء ابن الجهم يبالغون في بيان ذلك مبالغات شتى، مما سنعرض له في غير هذا الموضع. ونرى كثيرين منهم يسجلون الأعمال الكبرى في عصور الخلفاء ولنأخذ مثلا المتوكل، فجميع أعماله مثبتة في دواوين الشعراء وفى كتب التاريخ، فمن ذلك أمره لأهل الذمة بلبس الطيالسة العسلية والزنانير مما وقفنا عنده في الفصل الأول، فقد تغنى بهذا العمل ابن الجهم في أشعاره (4)، ومن ذلك عقده البيعة لبنيه الثلاثة:
المنتصر والمعتز والمؤيد، فقد تغنى شعراؤه بهذا الصنيع طويلا (5).
ويكثر في عهده بناء القصور على نحو ما أسلفنا، وكلما شاد قصرا نوّه الشعراء به وبروعة بنائه وما يدل عليه من مظاهر الحضارة والعمران لعصره. وليس هناك حادثة جلّى من سجن وزير وتعذيبه مثل ابن الزيات، أو غضب على قاض وتصفية أمواله مثل ابن أبى دؤاد، أو على طبيب وقبض أمواله مثل بختيشوع أو على كاتب من كتاب الدواوين أو على بعض الولاة إلا ويسجل الشعراء ذلك في أشعارهم مما يجعلها بحق وثائق تاريخية، وأروع ما سجلته هذه الوثائق أمجاد قوادنا وأبطالنا وجيوشنا في حومات الوغى شمالا وشرقا، وهى ليست تاريخا يسرد كما تصنع كتب التاريخ، وإنما هي أناشيد انتصارات رائعة لجنودنا وقوادهم البواسل في حروب الروم والترك والأرمن، وماتنى الجيوش العربية تخوض إليهم بحورا من الدماء منزلة بهم صواعق الموت التي لا تبقى ولا تذر: وكان من أبطال هذه المعارك لعهد المتوكل يوسف بن محمد الثغري، وكان المتوكل قد ولاه بعد وفاة أبيه على أرمينية، وكانت قد نشبت بها ثورات فأخذ يسحقها بجنوده المغاوير سحقا، وفيه وفى انتصاراته على بعض البطارقة الأرمنيين يقول البحتري (6):
هو الملك المرجوّ للدين والعلا … فلله تقواه وللمجد سائره
له البأس يخشى والسماحة ترتجى … فلا الغيث ثانيه ولا الليل عاشره (7)
كسرتهم كسر الزّجاجة حدّة … ومن يجبر الوهى الذي أنت كاسره
حسام وعز كالحسام وجحفل...شداد قواه محصدات مرائره(8)
وليست هناك وقائع حربية كبيرة إلا ودوّن الشعراء فيها البطولات العربية، وكان من أهم هذه الوقائع ثورة الزنج، وقد تغنى الشعراء فيها ببطولة الموفق غناء مدوّيا، ونرى الطبري يسجل في تاريخه طائفة كبيرة من أشعار هذا الغناء.
وبالمثل نراه يدوّن أغاني وأناشيد أخرى في حروب القرامطة، وكأنما استقر في نفوس المؤرخين أن الشعر الذى تغنّى بهذه الحروب ووصفها لا يقل أهمية عن وثائق التاريخ، فهو ليس مديحا للبطولات وتمجيدا فحسب، بل هو أيضا تاريخ، وهو تاريخ نابض بالحياة. ومن المحقق أنه حتى الآن لم يستغلّ هذا التاريخ الشعرى في كتابة تاريخ العصر، إذ كثيرا ما يحوى من التفاصيل ومن دقائق الأحداث مالا نجده مصورا في كتب التاريخ، ولذلك كان ينبغي على المؤرخين ألا يكتفوا بما يقرءون في كتب التاريخ عن الأحداث والوقائع الحربية، بل يضموا إلى ذلك وصف تلك الوقائع والأحداث المبثوث في دواوين الشعراء، حتى يطلعوا على كل جوانبها اطلاعا مضبوطا دقيقا.
وظل شعراء المديح في كثير من مدائحهم يقلدون الأقدمين في الوقوف على الأطلال والبكاء على الدمن والآثار العافية، وفى رأينا أن استبقاء الشاعر العربي على مدى العصور الماضية لهذا المطلع في كثير من قصائده لم يكن لبيان صلته بأسلافه ولا استبقاء لصورة من صور حياتهم الرعوية في العصر الجاهلي وما كان يتصل بها من الرحلة الدائرة حول مساقط الغيث والكلأ، وإنما كان لإحساس الشاعر إحساسا عميقا بتعبير هذا المطلع عن كل ما ينمحي من حياة الإنسان إلى غير مآب، سواء في ذلك حبه وغير حبه، فدائما لحظات ماضيه تذهب منه إلى غير مآب في الشباب وغير الشباب ولا يستطيع لها رجعة ولا أوبة. وكأنما تصوّر الأطلال نوازع الفناء التي تطبق مخالبها على كل ما يمضى من حياة الإنسان، وعادة تطبق هذه المخالب عليه آخر الأمر، فيصبح أثرا بعد عين، وهو لذلك يقف بالأطلال باكيا بدموع غزار، متمنيا لو عادت إليها نضرة الحياة القديمة، ولذلك قد يستسقى لها السحاب حتى تعود إليها النباتات والظلال وحتى تدبّ فيها الحياة، فمن ذلك قول ابن المعتز يصف دارا وأطلالا (9):
ص207
لا مثل منزلة الدّويرة منزل … يا دار جادك وابل وسقاك
بؤسا لدهر غيّرتك صروفه … لم يمح من قلبي الهوى ومحاك
لم يحل للعينين بعدك منظر … ذمّ المنازل كلّهن سواك
أىّ المعاهد منك أندب طيبه … ممساك بالآصال أم مغداك
أم برد ظلّك ذي الغصون وذي الجنا … أم أرضك الميثاء أم ريّاك (10)
وكأنما سطعت مجامر عنبر … أوفتّ فأر المسك فوق ثراك
وكأنما حصباء أرضك جوهر … وكأن ماء الورد دمع نداك
وكأنما أيدى الربيع ضحيّة … نشرت ثياب الوشى فوق رباك
وابن المعتز يلمّ بتلك الدار، ويراها وقد فقدت بهجتها القديمة وغيّرتها صروف الزمان حتى محت أطلالها الدوارس، ولا يزال هواه بها ماثلا في قلبه، وهو يدعو لها الغيث أن يجودها حتى تستعيد حلّتها الداثرة. وتتراءى له من خلال ذكرياته وعهود حبه الماضية، فيرى كل الديار دونها ولا تقاس إلى جمالها، ويبكيها ويندبها، ويندب كل معهد فيها وما كان ينتشر فيه من طيب على الصباح الباكر وعلى الآصال في المساء وعلى الغصون ذات الظلال والثمار، وتفوح الأرض برائحتها الساطعة، وكأنما تفوح مجامر عنبر، أو كأنما تفوح فأرة مسك، وحتى الحصى كأنه جواهر سقطت من أهل تلك الدار، وكأن قطرات الندى ماء ورد عاطر، والربيع ينشر بها وشيا عجيب الألوان. وهو وصف يحمل حنينا ووجدا لا نهاية لهما للدار وما كان بها من لقاء بين الأحبة، لقاء جعل كل ما حولهم يبدو في هذه الصورة القاتنة المحفورة في ذهن ابن المعتز حفرا لا يمكن أن يطمس أو تأتى عليه الأيام.
وكان الشاعر القديم ينزع نفسه من الأطلال وما يتصل بها من ذكريات الهوى والشباب الدائرة مفضيا إلى وصف رحلة له في الصحراء يتحدث فيها عن طول سراه وعن الفلوات وحيوانها الاليف والوحشي ومدى ضَنَا بعيره في رحلته
ص208
الطويلة الشاقة، وكأنما يريد أن يجذب نفسه جذبا من أفكار الغناء ويتغلغل في نوازع الحياة. وتبعه الشاعر العباسي مستبقيا على كل هذه العناصر في قصيدة المديح، وقد يفرد لوصف هذه الرحلة قصائد أو مقطوعات طريفة، وهى متناثرة في دواوين الشعراء من مثل قول على بن الجهم (11):
كم قد تجهّمنى السّرى وأزالنى … ليل ينوء بصدره متطاول
وهززت أعناق المطىّ أسومها … قصدا ويحجبها السواد الشامل
حتى تولّى الليل ثاني عطفه … وكأن آخره خضاب ناصل
ورأيت أغباش الدّجى وكأنها … حزق النّعام ذعرن فهي جوافل (12)
وهو يصور سراه في ليل متطاول يجثم سواده على آفاق الكون، وما زال يقطعه حتى نصل خضابه الأسود وبدت أغباشه وبقاياه وكأنها نعام مذعور، فهي تفر فرارا من الضوء الذى أخد ينتشر على قطع الظلام. وطالما وصف الشعراء نحول إبلهم وضناها كناية عن طول سراها ومدى ما عانته من نصب في وعثاء السفر الطويل الذى لا يكاد ينتهى. وألمّ شعراء العصر كثيرا بهذا المعنى كقول البحتري في وصف ابله (13):
يترقرقن كالسّراب وقد خض … ن غمارا من السّراب الجاري
كالقسىّ المعطّفات بل الأس … هم مبريّة بل الأوتار (14)
فهي لا تكاد تبين نحولا وهزالا حتى لكأنها أصبحت سرابا، وإنها لتشبه القسىّ المنحنية، بل هي أكثر نحولا فهي كالأسهم، بل هي أيضا أكثر ضنا وهزالا حتى غدت كالأوتار ضمورا. وكانوا في أثناء ذلك يعرضون لوصف حمر الوحش وأتنها التي يصادفونها في الفلاة، وكذلك لوصف الظباء وبقر الوحش، وكل يحاول أن ينفذ إلى صورة دقيقة من مثل قول ابن المعتز (15):
ص209
وجرت لنا سنحا جآذر رملة … تتلو المها كاللؤلؤ المتبدّد (16)
قد أطلعت إبر القرون كأنها … أخذ المراود من سحيق الإثمد (17)
وكان ابن المعتز قد سبق بوصف إبر القرون وأطرافها المدبّبة بالمراود المغموسة في الكحل شديد السواد واللمعان، فما زال يحاول النفوذ إلى صورة جديدة حتى قال يصف ثورا وحشيّا يقود إجلا أو قطيعا من بقر الوحش (18):
كأني على طاو من الوحش ناهض … تخال قرون الإجل من خلفه غابا
فقرون البقر تتكاثر حتى ليخالها ابن المعتز غابة نبتت في الفلاة فجأة.
وكان الشعراء يعرضون أحيانا مع الربيع ووصفه للحديث عن الخمر، على نحو ما كان يصنع أسلافهم العباسيون، وشاعت حينئذ التهنئة بعيد النيروز وبيوم المهرجان الكبير، وكانت بغداد وضواحيها تتحول فيه إلى ساحات كرنفالات ضخمة على نحو ما مر بنا في غير هذا الموضع، وكان الشعراء يهنئون الخلفاء والولاة به، وكثيرا ما كانوا يتحدثون عن ملاهيه، وقد يسوقون الحديث إلى الخمر، على نحو ما يلقانا عند ابن الرومي في قصيدة يوم المهرجان التي مدح بها عبيد الله بن طاهر محافظ بغداد حينئذ، ونراه يصور تصويرا رائعا ما كان بمجلسه من قيان يتغنين غناء يأسر القلوب، يقول (19):
وقيان كأنها أمّهات … عاطفات على بنيها حوان
مطفلات وما حملن جنينا … مرضعات ولسن ذات لبان (20)
كلّ طفل يدعى بأسماء شتّى … بين عود ومزهر وكران (21)
أمه دهرها تترجم عنه...وهو بادي الغنى عن الترجمان
غير أن ليس ينطق الدهر إلا ... بالتزام من أمه وحتضان (22)
ص210
وقد مضى يتحدث عن تأثير هؤلاء القيان بغنائهن وبماكن يحملن من آلات الطرب على صدورهن، وكأنها أطفال لهن، فهن يعانقنها وكأنما يرضعنها، ولكن لا بلبن وإنما بألحان شجية تشفى المحزون من دائه، ولكل منهن جمالها وسحرها وفتنتها وصوتها الذى يدلع الحزن والفرح جميعا، صوت تمده وتعلو به كما أرادت أو كما يقول في قصيدته:
ذات صوت تهزّه كيف شاءت … مثلما هزّت الصّبا غصن بان
وإنما أردنا بذلك كله أن نصور كيف أن شاعر المديح في هذا العصر حاول أن يضيف إلى عناصره الموروثة عناصر مستمدة من بيئته الحضارية، ممثلا فيها كثيرا من المعاني والصور الدقيقة، وكانوا دائما يلائمون بين مدائحهم وممدوحيهم، فإذا مدحوا وزيرا مثلا عرضوا لسياسته وتفننه في الكتابة، وإذا منحوا قائدا عرضوا لوقائعه وأمجاده الحربية، وإذا مدحوا عالما أشادوا بعلمه، وكذلك إذا مدحوا مغنيا أشادوا بغنائه. واضطرم حينئذ الهجاء كما اضطرم المديح، ولم يكد يترك الشعراء خليفة ولا وزيرا ولا قاضيا ولا عالما ولا مغنيا إلا كالوا له الهجاء كيلا، وأدّاهم تنافسهم إلى أن يتبادلوا الهجاء ويريشوا كثيرا من سهامه. واقرأ في أي ديوان من دواوين العصر فستجد دائما هجاء كثيرا على نحو ما يلقانا في ديوان البحتري مثلا، وقد اشتهر بهجائه بعض ممدوحيه حين يقلب لهم الدهر ظهر المجن، مثل أحمد ابن الخصيب ممدوحه، فإنه حين نكبه المستعين أنشده قصيدة يحثه فيها على مصادرة أمواله وسفك دمه، وظل يسلقه بلسانه طويلا بمثل قوله (22):
لابن الخصيب الويل كيف انبرى … بإفكه المردي وإبطاله
كاد أمين الله في نفسه … وفي مواليه وفي ماله
والرأي كلّ الرأي في قتله … بالسيف واستصفاء أمواله
وله قصائد كثيرة يمجد فيها المستعين وعهده، حتى إذا خلع وولّى الترك بعده المعتز أصلاه نارا حامية من هجائه في ثنايا مديحه للخليفة الجديد. ولم يكن البحتري حاذقا في هذا الفن، غير أنه كان هناك كثيرون يتقنونه، مثل على
ص211
ابن بسام، وكان يتعرض في هجائه كثيرا للخلفاء والوزراء وقلما سلم أحد من لسانه ومن قوله في العباس بن الحسن وزير المكتفي (23):
وزارة العباس من نحسها … تستقلع الدولة من أسّها
شبّهته لما بدا مقبلا … في حلل يخجل من لبسها
جارية رعناء قد قدّرت … ثياب مولاها على نفسها (24)
وكان أكثر ما يعتمدون عليه في الهجاء من معان التهوين والتحقير والتصغير وما إلى ذلك من طعنات مصمية نافذة، بما تحمل من سموم الانتقاص والسخرية المريرة، كقول إبراهيم بن العباس في صديق تنكر له وجحد معروفه (25):
ولما رأيتك لا فاسقا … تهاب ولا أنت بالزاهد
وليس عدوّك بالمتقي … وليس صديقك بالحامد
أتيت بك السوق سوق الرقيق … فناديت هل فيك من زائد
على رجل غادر بالصديق … كفور لنعمائه جاحد
فما جاءني رجل واحد … يزيد علي درهم واحد
سوى رجل حار منه الشّقا … وحلّت به دعوة الوالد
فبعتك منه بلا شاهد … مخافة أدرك بالشاهد
وأبت إلى منزلي سالما … وحلّ البلاء على الناقد (26)
والمقطوعة تمسخ هذا الصديق مسخا، حتى لتجعله حيّا كميت وموجودا كمعدوم، فلا هو من أهل المجون ولا من أهل الزهد ولا يخشى بأسه عدو ولا يحمده صديق، إنه كنود مهين، ولذلك ذهب ببيعه الصولي في سوق الإنسان الكبيرة، معلنا عيوبه من الغدر وكفر النعمة والجحود، مما جعل الناس يكفّون عن شرائه إلا
ص212
أن يكون بدرهم واحد، إلا ما كان من رجل سيئ الحظ كأنما استجيبت فيه دعوة لأبيه، أقدم على شرائه، فباعه منه بدراهم معدودة، وولى الصولي على وجهه يطلب السلامة من هذا البلاء الذي كان حلّ به. وكان مما يؤذي المهجوين حينئذ إيذاء شديدا أن يوصفوا بالقذارة، إذ كان العرب قد تحضروا وأسرفوا في صور النظافة وفي التطيب بالعطور، وكأن من يوصف بنتن الرائحة يتلطخ بعار ما بعده عار، ويستغل ذلك الصولي في أحد مهجويه قائلا له (27):
وكن كيف شئت وقل ما تشا … وأبرق يمينا وأرعد شمالا
نجابك لؤمك منجى الذباب … حمته مقاذيره أن ينالا
فليكن كما يشاء فإن أحدا لن يستطيع التعرض له لحقارته وقذارته. ومعروف أن ابن الرومي هو أكبر شعراء الهجاء في العصر وأكثرهم سهاما لمهجويه، وكان يعرف كيف يصب عليهم التصغير والحقارة والضعة، كقوله المشهور في وصف بخيل (28):
يقتّر عيسى على نفسه … وليس بباق ولا خالد
فلو يستطيع لتقتيره … تنفّس من منخر واحد
ففتحة أنف واحدة كانت تكفيه، ولو أنه رأى فيها حقّا كفاية ما انتفع بالفتحة الأخرى، ولا حاول ذلك حرصا وبخلا وشحّا جبل عليه. وكانت لابن الرومي حاسة تلتقط العيوب الجسدية وتستطيع تكبيرها على نحو ما يصنع أصحاب الصور الكاريكاتورية الهزلية، فإنهم يعرفون كيف يستغلون دقائق العيوب في الوجوه والأجسام، وتستحيل مقطوعات وقصائد كثيرة في ديوان ابن الرومي إلى صور ساخرة من مهجويه، حتى ليأخذوا أحيانا شكل حيوانات مجترة وغير مجترة، كقوله في بعض مهجويه (29):
ما ظننت الإنسان يجترّ حتى … كنت ذاك الإنسان عين اليقين
ص213
أما أبو سليمان الطنبوري المغنى فقد استمع إلى غنائه القبيح يوما، فتراءى له في صورة بغل لطحّان ما يزال يحرك فكيه في أكل طعامه من الفول وغيره، أو كما يقول (30):
وتحسب العين فكيه إذا اختلفا … عند التنغم فكّى بغل طحّان
وهو جانب طريف عند ابن الرومي سنعرض له ثانية في ترجمته، والمهم أن نعرف الآن أنه استطاع أن ينمى الهجاء في هذا الجانب الساخر إلى ذروة لم يصل إليها الشعر العربي قبله ولا بعده.
وظل الفخر نشطا في العصر، وكان قد ضعف الفخر القبلي منذ العصر الماضي وظل ضعيفا في هذا العصر لضعف الشعور بالعصبية القبلية، وإن كنا نجد هذا الشعور من حين إلى حين. ولكنه على كل حال كان شعورا خافتا، ونجده أحيانا على لسان البحتري حين يفتخر بطيئ قبيلته. وكذلك على لسان ابن الجهم القرشي حين يفتخر بقريش وجدها فهر بن مالك قائلا (31):
أبت لي قروم أنجبتني أن أرى … وإن جلّ خطب خاشعا أتضجّر
أولئك آل الله فهر بن مالك … بهم يجبر العظم الكسير ويكسر
هم المنكب العالي على كل منكب … سيوفهم تفنى وتغنى وتفقر
وبقيت من ذلك بقية عند ابن المعتز، إذ نراه يفخر طويلا على بنى عمومته العلويين، وهو فخر سياسي يدور حول الخلافة وأن العباسيين أولى بها من العلويين، وربما كان أروع من هذا الفخر عنده فخره العام الذى يخلطه بشكواه، والذى يتحدث فيه عن حبه مقدما لبعض صواحبه فضائله من الشجاعة والبأس والكرم الفياض والوفاء، ومن طريف فخره قوله (32):
لا أشرب الماء إلا وهو منجرد … من القذى ولغيري الشّوب والرّنق (33)
عزمي حسام وقلبي لا يخالفه … إذا تخاصم عزم المرء والفرق (34)
ص214
ميت السّرائر ضحّاك على حنق … ما دام يعجز عن أعدائي الحنق
فهو يشرب الماء صفوا وغيره يشربه كدرا وشوبا وطينا، وهو قوي العزيمة، يكتم سره ونيته، أو هو بعبارة أخرى رجل كامل المروءة، وقد تغنى الشعراء معه طويلا بالكرامة والعزة والأنفة والشيم العربية الرفيعة التي ظلت لا تبرح ذاكرة العرب على مر العصور.
واحتدم الرثاء في العصر، فلم يمت خليفة ولا وزير ولا قائد ولا نابه مشهور إلا رثاه الشعراء، وكان يحدث أن يقتل الخليفة أو يخلع ويموت في سجنه، وكان من الشعراء من يتأثر لذلك تأثرا عميقا، فتتفجر لوعاته على لسانه رثاء حارّا، ومما يصور ذلك مقتل المتوكل الذى مرّ بنا الحديث عنه، وكان البحتري حاضرا مقتله فتعمق التأثر نفسه، فبكاه بقصيدته (35):
محلّ على القاطول أخلق داثره … وعادت صروف الدهر جيشا تغاوره
ويقال إنه نظمها حين ولى ابنه المعتز الخلافة وهي ليست رثاء ولا تأبينا فحسب، بل هي أيضا ثورة على الجناة وفى مقدمتهم ولى العهد المنتصر، إذ تحول صدره إلى ما يشبه بركانا لا يزال يقذف بالحمم الملتهبة، حتى ليحرم على نفسه كل متاع إلا أن يهب من يأخذ بثأر المتوكل ويسفح دماء قاتليه دما بدم، ويعجب أن ابنه وولى عهده يشترك في دمه، ويدعو الله ألا يمتعه بتراثه، يقول:
حرام علىّ الرّاح بعدك أو أرى … دما بدم يجرى على الأرض مائره (36)
أكان ولىّ العهد أضمر غدرة … فمن عجب أن ولّى العهد غادره
فلا ملّى الباقي تراث الذي مضى … ولا حملت ذاك الدعاء منابره (37)
وكان ابن المعتز صديقا حميما للخليفة المعتضد، وكان لا يبارى في شجاعته وبأسه. وكانت أيامه أيام أمن وسعود للخلافة، فلما وافاه القدر جزع عليه ابن المعتز جزعا شديدا، وبكاه وبكى دولته بطائفة من المراثي الحارة، منها مرثيته (38):
ص215
يا دهر ويحك ما أبقيت لي أحدا … وأنت والد سوء تأكل الولدا
وقد مضى فيها يندب سكناه في دار موحشة، وقد خلّف من ورائه الجيوش والكنوز التي لم تكن تحصى عددا، والسرير أو العرش الذى كان يملؤه مهابة وسؤددا، ويذكر سحقه للأعادي سحقا لا يبقى ولا يذر، والجياد والرماح تغدو عليهم وتروح، كما يذكر قصوره ووصائفه وملاهيه وأمجاده الحربية، يقول:
ثم انقضيت فلا عين ولا أثر … حتى كأنك يوما لم تكن أحدا
وعلى نحو ما تفجعوا على الخلفاء تفجعوا على أبنائهم وعزّوهم فيهم، وبالمثل صنعوا مع الوزراء وذوى النباهة والشأن، ومرّ بنا في حديثنا عن خزانات الكتب ما أقام على بن يحيى المنجم في ضيعة له من خزانة ضخمة للكتب كان الناس يؤمونها من كل بلد، فيجدون فيها نفقتهم وما يشاءون من كتب لا تكاد تحصى، وكأن الخلفاء منذ المتوكل يسبغون عليه عطايا جزيلة، فكان ينفقها على مكتبته وعلى الناس من شعراء وغير شعراء، فلما توفى رثاه على بن بسام رثاء رائعا على هذا النمط (39):
قد زرت قبرك يا علىّ مسلّما … ولك الزيارة من أقلّ الواجب
ولو استطعت حملت عنك ترابه … فلطالما عنى حملت نوائبي
ودمى فلو أني علمت بأنه … يروي ثراك سقاه صوب الصائب
لسكبته أسفا عليك وحسرة … وجعلت ذاك مكان دمع ساكب
فلئن ذهبت بملء قبرك سؤددا … لجميل ما أبقيت ليس بذاهب
والقطعة تفيض حسرة ولوعة، حتى ليتمنى ابن بسام أن لو فداه بروحه ومات مكانه وحمل عنه ترابه، ويقول إنه لو عرف أن دمه يروى ثراه لسكبه عليه ولم يسكب دموعه المنهلة. ثم يسترجع نفسه فجميل ما أسدى إلى الناس من صنع لن يذهب سدى، بل سيظل خالدا على مر الزمان. وكانوا يعزون الآباء في البنات وأن يحتسبوهن عند الله، ولهم فيهن تعزيات طريفة، من ذلك تعزية ابن الرومي
لابن المنجم المذكور في ابنة له على هذه الشاكلة (40):
لا تبعدنّ كريمة أودعتها … صهرا من الأصهار لا يخزيكا
إني لأرجو أن يكون صداقها … من جنّة الفردوس ما يرضيكا
لا تيأسنّ لها فقد زوّجتها … كفؤا وضمّنت الصداق مليكا
وكانوا يحاولون النفوذ إلى العزاء بأن الموت مصير لا بد منه، وأن أحدا لن يعيش إلا إلى أجل محدود فنحن دائما مشدودون إلى الموت، وكل لحظة تمضى تموت ولا تعود إلى الحياة أبدا، فالدهر لا يعيدها ولا تعيدها أيامه، بل لكأن الأيام خلقت لكى تنزل الكوارث على الناس، أما ما قد تجلبه لهم من حسن ونعم فهي إنما تجلبه عن غير عمد، وفى ذلك يقول ابن المعتز في بعض مراثيه (41):
ألست ترى موت العلا والمحامد … وكيف دفنّا الخلق في قبر واحد
وللدّهر أيام يسئن عوامدا … ويحسنّ إن أحسنّ غير عوامد
وسعر موت الأبناء وذوى الرحم قلوب الشعراء، فبكوهم بدموع غزار وأنوا أنينا حارّا من قلوب جريحة كوتها نار الفراق الملتهبة، ومضوا يتأوهون وجذوات الحزن الممض تلذع أفئدتهم لذعا، ويشتهر في هذا الجانب ابن الرومي برثائه لابنه الأوسط وقد مات منزوفا وهو لم يزل في المهد صبيّا، وأحس كأن القدر اختطف منه فلذة كبيرة من كبده، فامتلأت نفسه حزنا وشقاء، وقعهما على قيثارته ودموعه تنحدر على خديه، وإنه ليخاطب عينيه أن ترسل الدموع غزيرة، علّها تنفس عنه شيئا من محنته في ابنه، يقول (42):
بكاؤكما يشفى وإن كان لا يجدى … فجودا فقد أودى نظيركما عندي (43)
أريحانة العينين والأنف والحشا … ألاليت شعري هل تغيّرت عن عهدي
كأني ما استمتعت منك بضمّة … ولا شمّة في ملعب لك أو مهد
وأنت وإن أفردت في دار وحشة … فإني بدار الأنس في وحشة الفرد
ص217
والقصيدة جميعها على هذا النمط من التحسر الممض واللوعة المحرقة، حتى لكأنما أصبحت الدنيا كلها في عين ابن الرومي قبرا موحشا كبيرا، قبرا يصبّ عليه حزنا ثقيلا. وممن رزئ بابنين له وبكاهما طويلا إبراهيم بن العباس الصولي، وكان الموت قد فاجأه في أولهما، ثم لم يلبث أن فاجأه في الثاني، فقال (44):
كلّ لساني عن وصف ما أحد … وذقت ثكلا ما ذاقه أحد
ما عالج الحزن والحرارة في الأ … حشاء من لم يمت له ولد
فجعت بابنىّ ليس بينهما … إلا ليال ما بينها عدد
وكلّ حزن يبلى على قدم ال … دّهر وحزني يجدّه الكمد
وشاعرية الصولي كانت دون شاعرية ابن الرومي، ولذلك لم يبلغ في تصوير حزنه وأساه على فلذتي كبده ما بلغه ابن الرومي من تصوير كارثته في ابنه وفاجعته فيه.
وذكرنا في كتاب العصر العباسي الأول أن شعراء هذا العصر بكوا بغداد حين أصابتها كوارث النهب والتحريق في حروب المأمون والأمين، وبذلك عرف الشعر العربي لأول مرة رثاء المدن، ونجد في هذا العصر الجديد بقية لهذا الرثاء حين هجم صاحب الزنج بجموعه على البصرة وأنزل بها النهب والسلب والحرق وفتك بأهلها فتكا ذريعا، حتى قيل إنه قتل منهم في هذا الهجوم ثلاثمائة ألف على نحو ما مر بنا في هذا الموضع، وقد أشرنا هناك إلى مراثي الشعراء لتلك المدينة وفى مقدمتها مرثية ابن الرومي:
ذاد عن مقلتي لذيذ المنام … شغلها عنه بالدموع السّجام
وهو يستهلها ببيان ضخامة الحادثة وخطورتها، فقد نزل بالبصرة من ضروب الذل والهوان والخسف والعسف ما ملأ نفسه ألما وهو لا وحسرة ولوعة، حتى إنه ليبكي بكاء مرّا طوال نهاره وطوال ليله، فقد انتهك الزنج محارم الإسلام، وإن
لهفته عليها لتدلع لهبا في قلبه كلهب النار التي حرقتها، وإنه ليندب مجدها وأمنها ومن سفكوا الدم فيها، حتى كان الأخ لا يفكر في أخيه ولا الأب في بنيه، فالجميع مشغولون بأنفسهم كل يريد النجاة ولا منجى فالسيوف تحصدهم حصدا، أما النساء فساقوهن سبايا حاسرات الوجوه، وباعوهن بيع الرقيق. وخرّت المدينة الكبيرة عند أقدام الزنج تترنّح إعياء، وأصبحت القصور بالتحريق تلالا، وأصبح الناس أشلاء مبعثرة في كل مكان، وأصبح المسجد الجامع قفرا من عبّاده ونسّاكه. ويتحول ابن الرومي من وصف الكارثة المروعة إلى استصراخ الناس كي يردوا سيل الزنج الكاسح عن البصرة ومدن العراق، ويرفع لهم شعارات الجهاد الديني، ويستحثهم بما يكون بينهم وبين الله من حوار إزاء تلك الفاجعة إن هم قعدوا عنها، ويناديهم بلسان الرسول صلى الله عليه وسلم أن يردّوا عدوان الزنج الأثيم، ويستنفرهم في حماسة بالغة لرد هذا العار وللثأر والانتقام، ويختم ابن الرومي المرثية ببيان فضل المجاهدين وما أعدّ لهم من الجنان والرضوان العظيم. وهى بذلك تعدّ مرثية من جهة واستصراخا واستنفارا لحرب الزنج من جهة ثانية، وهو استنفار يكتظ بالغيظ والحنق الشديد.
ومن موضوعات الرثاء التي استحدثت في العصر العباسي الماضي رثاء المدلل من الحيوانات المستأنسة، ونرى شعراء هذا العصر يحاكون أسلافهم في هذا الباب، ومن أروع ما نظموه فيه مرثية الحسن بن على بن أحمد بن بشار المعروف بابن العلاّف الضرير النهرواني، وكان من أصدقاء ابن المعتز وابن الفرات وزير المقتدر، وكان له هر يأنس به تعوّد أن يدخل أبراج الحمام لدى الجيران ويأكل أفراخها، وكثر ذلك منه، فأمسكه بعض أربابها وذبحوه، وحزن عليه ابن العلاف، فرثاه رثاء حارّا وكأنه يرثى صديقا عزيزا لديه نكبه بعض الخلفاء، ولذلك قيل إنه كنى بالهر عن ابن المعتز وقيل عن ابن الفرات، خوفا على نفسه من المقتدر الذى نكبهما إن هو صرّح بالاسم الحقيقي، ويضيف ابن خلكان إلى هذين القولين قولا ثالثا، هو أنه كانت لعلى بن عيسى وزير المقتدر جارية هويت غلاما لابن العلاف، ففطن بهما فقتلا، وبكى ابن العلاف غلامه وكنى عنه بالهر. وفى رأينا أن روعة هذه المرثية هي التي جعلت القدماء يظنون بها هذه الظنون، وهى خمسة وستون بيتا،
ص219
كلها من عيون الرثاء وغرره. وفيها يقول (45):
يا هرّ فارقتنا ولم تعد … وكنت منّا بمنزل الولد
فكيف ننفكّ عن هواك وقد … كنت لنا عدّة من العدد
تطرد عنا الأذى وتحرسنا … بالغيب من حبّة ومن جرد (46)
وتخرج الفأر من مكامنها … ما بين مفتوحها إلى السّدد
حتى اعتقدت الأذى لجيرتنا … ولم تكن للأذى بمعتقد
وحمت حول الرّدى بظلمهم … ومن يحم حول حوضه يرد
صادوك غيظا عليك وانتقموا … منك وزادوا ومن يصد يصد
ما كان أغناك عن تصعّدك ال … برج ولو كان جنة الخلد
والمرثية كلها تفجع على هذا المنوال، وتزخر بالحكم مع الحسرة على فقد الهرّ ومع التأمل في الموت وحقائق الحياة. ومن طريف ما نجد من مرثيات في العصر رثاء أبى الشبل البرجمي التميمي لقنديل حطمه كبش دخل بيته وعاث فيه (47) وكذلك بكاؤه قرطاسا سرق منه خلسة (48).
وأكثر الشعراء في العصر من العتاب والاعتذار، سواء بين المتحابين أو بين الأصدقاء، وقد تفننوا في ذلك على صور شتى تسعفهم ملكاتهم العقلية الخصبة بمعان وخواطر لم تفد على سابقيهم، أو لعلها وفدت ولكنهم أبرزوها إبرازا جديدا، تسعفهم في ذلك مشاعرهم المرهفة وأذواقهم المتحضرة الرقيقة ومهارتهم في الإتيان بالمعاني التي تروق وتروع العقول والقلوب جميعا، وربما كان من أجمل ما صاغوه في العتاب قول سعيد بن حميد (49):
أقلل عتابك فالبقاء قليل … والدهر يعدل تارة ويميل
ص220
لم أبك من زمن ذممت صروفه … إلا بكيت عليه حين يزول
ولعل أحداث المنيّة والرّدى … يوما ستصدع بيننا وتحول
فلئن سبقت لتبكينّ بحسرة … وليكثرنّ عليك منك عويل
ولتفجعنّ بمخلص لك وامق … حبل الوفاء بحبله موصول
ولئن سبقت-ولا سبقت-ليمضين … من لا يشاكله لدىّ خليل
وأراك تكلف بالعتاب وودّنا … صاف عليه من الوفاء دليل
ولعل أيام الحياة قليلة … فعلام يكثر عتبنا ويطول
إنها حماقة أن يتمادى الأصدقاء في العتاب، والحياة من شأنها ألا تجرى سويّة، وكل ما نبكي منه يوما نبكي عليه في يوم تال، فأولى بنا ألا نفضي إلى التشاؤم.
إذ سرعان ما يطوى بساط الحياة، ولذلك خليق بالأصدقاء أن يعفوا عما قد يظنون بصداقتهم من كدر. ويعرض ابن حميد على صديقه الفراق الأخير الذي لا بد منه فراق الموت وكيف سيملأ صديقه عليه الفزع ويلتاع لوعة لا ينفعه إزاءها صراخ ولا عويل، وكذلك شأنه إن سبقه صديقه، وقيم العتاب وصداقتهما كلها صفاء وبرّ، وحري بهما أن ينعما بتلك الصداقة قبل أن يقرع الموت الأبواب ويفترق الصديقان افتراقا لالقاء بعده. ولابن الرومي في العتاب كثير من المعاني البارعة، من مثل قوله في آل وهب (50):
تخذتكم درعا وترسا لتدفعوا … نبال العدا عنى فكنتم نصالها
وقد كنت أرجو منكم خير ناصر … على حين خذلان اليمين شمالها
فإن أنتم لم تحفظوا لمودّتي … ذماما فكونوا لا عليها ولا لها
وعفاء على هؤلاء الأصدقاء فقد كان يتخذهم دروعا وتروسا، فإذا هم عون للأعداء، وإذا هم يخذلونه خذلانا مروعا، خذلان اليمين للشمال، وإنه ليتوسل إليهم إن لم يحفظوا ذمام مودته وحرمته أن يكفوه شرهم كما كفوه خيرهم، فيكونوا
لا عليه ولا له. ولعل أشهر شعراء العصر في الاعتذار وأكثرهم تفننا فيه البحتري، وقد أجمع القدماء على الإعجاب باعتذاراته للفتح بن خاقان وزير المتوكل ومن طريف ماله فيها قوله من قصيدة ميمية مدحه بها (51).
عذيري من الأيام رنّقن مشربي … ولقّينني نحسا من الطير أشأما (52)
وأكسبنني سخط امرئ بتّ موهنا … أرى سخطه ليلا مع الليل مظلما (53)
وقد كان سهلا واضحا فتوعّرت … رباه وطلقا ضاحكا فتجهّما (54)
أعيذك أن أخشاك من غير حادث … تبيّن أو جرم إليك تقدّما
ولو كان ما خبّرته أو ظننته … لما كان غروا أن ألوم وتكرما (55)
أقرّ مما لم أجنه متنصّلا … إليك على أني إخالك ألوما (56)
لي الذنب معروفا، وإن كنت جاهلا … به فلك العتبى علىّ وأنعما (57)
ومثلك إن أبدى الفعال أعاده … وإن صنع المعروف زاد وتمما (58)
ولم ننقل الاعتذار كله في القصيدة لطوله، وجميعه يجرى علي هذه الشاكلة من التلطف ورقة الحاشية، وحسن التأتي، ودقة التنصل، مع التضخيم للذنب الذي لا يعرفه والذي جعل الفتح يتغير عليه. وهو لذلك يقدم شتى المعاذير، فقد أتى جرما لا يغتفر، جرما لم يجنه، كدّر ورده، وأحال أيام سعده نحسا لا يطاق، إذ غضب عليه الفتح، وكأنما اسودّت الدنيا في عينه، ومثل الفتح حرىّ بالعفو لو أن هناك جريرة حقيقية، فما بالنا ولا جريرة ولا جرم ولا ذنب، ويسلّم البحتري بذنبه رقة وتلطفا، منوها بالفتح وفعاله الحميد ومعروفه الذي يواليه، وكيف أنه من أهل الصفح الجميل.
ولا نغلو إذا قلنا إن أهم موضوع استغرق الشعراء واستنفد أشعارهم الغزل، وكانوا ينظمونه تعبيرا عن عاطفة الحب الإنسانية الخالدة، وتلبية لحاجات الناس
ص222
الوجدانية وحاجات المغنين والمغنيات من المقطوعات والأشعار التي كانت توقّع على الآلات والمعارف الموسيقية، ولذلك تطلبها دائما دور القيان والطرب، وكان الشعراء يختلفون إلى هذه الدور لسماع الغناء في أشعارهم ولمغازلة الجواري والإماء.
وكان منهن من يتقنّ نظم الشعر، ومنهن من كن يطارحن الشعراء في أغاني الحب وأناشيده. ولعبن دورا واسعا في دفع المجتمع العباس نحو الصبابة والعشق، وكان منهن من ينحرفن عن الطريق السوىّ، كما كان من الشعراء والشباب من حولهن شياطين لا يعرفون دينا ولا خلقا ولا عرفا. وكان ذلك سببا في أن يكثر الغزل الإباحي، الذى لا يحتشم فيه الشاعر، بل الذى يعبر فيه أحيانا عن جوعه الجسدي وغرائزه الحيوانية. ومن الحق أن ذلك كان امتدادا لموجة الغزل المكشوف الذى شاع في العصر العباسي الأول. وكأنما ظلت لتلك الموجة حدّتها، وكانت دور القيان آنفا من أسباب هذه الحدة، إذ كان بعض جواريها يتحولن أدوات للإغراء والريبة والمجون، وساعدهن على ذلك أنهن كن يبعن ويشرين ولم يكن يشعرن
من الكرامة. وكن يعشن بين الخلعاء والمجّان وبين كثيرين ممن لا يعرفون دينا ولا صيانة مروءة ولا يفكرون في عقاب ولا ثواب، إنما يفكرون في المتاع المادي وغرائزهم النوعية ومآربهم الرخيصة، وطبيعي لذلك أن يشيع الغزل الإباحي المكشوف الذى لا يعرف للمرأة كرامة ولا للرجل مروءة، إنما يعرف الهوان والابتذال البغيض.
وعلى نحو ما ظل الغزل الماجن الخليع شائعا في هذا العصر ظل كذلك الغزل الشاذ بالغلمان الذى يزرى بكرامة الرجال. وأكبر الظن أن كثيرا من هذا الغزل وسالفه لم يكن يصور حقائق واقعة. إنما كان يصور حقائق خيالية من بعض الوجوه.
إذ كان يراد به إلى التندير والفكاهة في مجالس هؤلاء المجان الخليعين. فهم ينظمونه ويتداولونه للضحك والدعابة. وعادة يصحبه الشاعر في إنشاده بحركات ليزيد من ضحك السامعين. ونظن ظنّا أنه فات مؤرخي الأدب العباسي أن يلاحظوا هذه الظاهرة، وكأنه يشبه من بعض الوجوه ما قد يجرى على بعض الألسنة في عصرنا من نكت جنسية. وليس معنى ذلك أننا نريد أن ننكر إنكارا باتّا الغزل المكشوف وأخاه الشاذ في العصر العباسي الأول والثاني. إنما نريد أن نلفت إلى أن كثيرا منه صنع للتندير والفكاهة. وأنه غاب ذلك عمن أرخوا للأدب العباسي.
وتاريخهم لذلك في حاجة إلى غير قليل من التصحيح. ولا بد أن نلاحظ من جهة
ص223
ثانية أن هذا الغزل المادي الماجن كانت تحفّه دائما وتتخلله معانى الغزل العربي العفيف الذى شاع في العصر الأموي، وكانت هذه المعاني تخفف من ماديته كما كانت تشعل فيه جذوة الحب الظامئ وآلامه الثقال، فلم يسقط في كثير من جوانبه ومقطوعاته، إذ ظلت فيه الحيرة والحنان والتضرع والاستعطاف وظل الشوق الجامع الذى يملك على النفس عواطفها وحسها وشعورها وأهواءها.
وأيضا لا بد أن نلاحظ بجانب ذلك أن الغزل العذري العفيف نفسه ظل حيّا لا من خلال معانيه التي تسربت في الغزل المادي الصريح كما ذكرنا آنفا، وإنما من خلال بعض الشعراء الذين ارتفعوا عن أدران الحسّ وأعراضه، وعاشوا في حبهم معيشة طاهرة نقية أعظم ما يكون الطهر والنقاء على نحو ما هو معروف عن محمد ابن داود الأصبهاني صاحب كتاب «الزهرة» في الحب وأشعاره. وملاحظة أخيرة هي أن الضربين من الغزل المادي الإباحي والعذري العفيف استطاعت تكلّف؟ ؟ ؟ الشعراء الخصبة حينئذ أن تستثير فيهما كثيرا من خطرات الحب ودقائقه البديعة، وابن الرومي لا يبارى في نفوذه إلى هذه الدقائق، كقوله في العناق وطموحه إلى امتزاج الروحين (59).
أعانقها والنفس بعد مشوقة … إليها، وهل بعد العناق تدان
وألثم فاها كي تزول حرارتي … فيشتد ما ألقى من الهيمان (60)
كأن فؤادي ليس يشفى غليله … سوى أن يرى الروحين يمتزجان
فالعناق لا يروى ظمأه، وفي قلبه جذوة لا تطفئها القبلات، بل تزيدها تلظيا واشتعالا، ويحسّ أن عذابه بحب صاحبته لن يخلصه منها إلا أن تمتزج روحه بروحها، حتى ينعم بالوصل الحقيقي. وكثيرا ما يلم بالعناق وكثيرا ما يودع فيه صورا طريقة، كقوله (61):
طالما التفّت إلى الصّب … ح لنا ساق بساق
في قناع من لثام … وإزار من عناق
ص224
فقد كانا مكسوّين طوال الليل كسوة غريبة من اللثام والعناق، ونحس دائما عنده بطفرات الفكر العبقري وأخيلته كأن نراه يقول في الصدور (62):
صدور فوقهنّ حقاق عاج … وحلى زانه حسن اتّساق
يقول الناظرون إذا رأوها … أهذا الحلى من هذى الحقاق
وهي صورة لا تفد بحق في ذهن شاعر من هذا العصر سوى ذهن ابن الرومي الذى كان يشبه متحفا كبيرا ما يزال يستخرج منه الدرر والتحف النفيسة، من مثل قوله في جمال العيون ومدى تأثيرها وسحرها في العشاق (63):
نظرت فأقصدت الفؤاد بسهمها … ثم انثنت عنه فكاد يهيم
ويلاه إن نظرت وإن هي أعرضت … وقع السهام ونزعهنّ أليم
وكان من حوله من الشعراء لا يزالون يحاولون بكل ما وسعهم أن يأتوا بدرة أو تحفة تخلب الباب سامعيهم، ولتكن خاطرة طريفة أو صورة بديعة، ولا يهم أن يكون أصلها قد دار على ألسنة الشعراء، فالمهم طرافة العرض وتحوير المعنى أو الصورة، من مثل قول ابن المعتز (64):
يا غصنا إن هزّه مشيه … خشيت أن يسقط رمّانه
وقول أبي العباس الناشي في بكاء إحدى صواحبه وقد أحسّت أن فراقه لها سيطول أمده، فقال وهو محزون الفؤاد (65):
كأن الدموع على خدّها … بقيّة طلّ على جلنّار
وينفذ أحمد بن صالح بن أبى فنن إلى معنى دقيق فإنه حين ينظر إلى صاحبته تتورد وجنتها خجلا، فتقتص منه في قلبه بما تصيبه به من سهام عينيها المصمية، يقول (6):
أدميت باللحظات وجنتها … فاقتصّ ناظرها من القلب
ص225
ومرّ بنا في فصل الحياة الاجتماعية أن موجة المجون ظلت على تفاقمها وحدتها في هذا العصر، وظل معها شرب الخمر المعتقة، وكانت حاناتها تكتظ بها الكرخ في بغداد ودور النخاسة والبساتين كما كانت تكتظ بدنانها وكئوسها الديارات. وكان سقاتها أخلاطا من النصارى والمجوس واليهود، وأقبل يعبّها المجّان؟ ؟ ؟ والفسّاق وكان منهم المتمرد على الدين الحنيف، ومنهم المجوسي، ومنهم من لا يؤمن بأي دين، فأكبوا عليها جميعا، دون رادع أو وازع، ويفيض كتاب الأغاني بأخبارهم، وكذلك كتاب الديارات للشابشتي، حيث يتوقف مع كل دير ليترجم لماجن كبير مثل الحسين بن الضحاك وأبى الشبل البرجمي وعبد الله بن العباس الربيعي، وغيرهم ممن كانوا يعكفون على الشراب في الأديرة وغير الأديرة، وممن عاشوا سكارى لا يفيقون إلا لكي يعودوا إلى الشراب والمجون، وهم في أثناء ذلك يصفون الخمر والنشوة بها وكئوسها ودنانها وسقاتها مضيفين إلى ذلك غزلا مسعورا بالجواري والغلمان. ويخيل إلى الإنسان كأنما تردّى في حمأة هذه الرذيلة أكثر شعراء العصر، ولذلك تزخر دواوينهم وأشعارهم بنعت الخمر والنشوة بها، وجعلوا يحاولون فيها ما حاولوه في أغراض الشعر الأخرى من النفوذ إلى معان وأخيلة تبهر السامعين، من مثل قول ابن المعتز (67):
شربنا بالكبير وبالصغير … ولم نحفل بأحداث الدهور
وقد ركضت بنا خيل الملاهي … وقد طرنا بأجنحة السرور
وهو يصور نشوته بتلك الخمر التي شربوها بالقداح الكبيرة والصغيرة، فملأتهم مسرة وفرحة، حتى لكأنما يحملهم الاغتباط على خيوله، بل على جناحيه، فهم يطيرون طيرانا، ولم يبلغ شاعر مبلغ ابن الرومي في بيان ما تفسح الخمر من آمال السكران حتى ليتمنى المستحيلات، يقول (68):
ومدامة كحشاشة النّفس … لطفت عن الإدراك والحسّ
لنسيمها في قلب شاربها … روح الرجاء وراحة النفس
وتمدّ في أمل ابن نشوتها … حتى يؤمّل مرجع الأمس
وكأنها وكأن شاربها … قمر يقبّل عارض الشمس
ص226
وقد صور ابن الرومي في البيتين الأولين رقة المدامة وخفتها حتى لتكاد تدق عن الحس، كما صور أثرها في قلب شاربها وما تمنحه من أمل بعد يأس وراحة بعد تعب، بل إنها لتمد في أمله، حتى ليظن أن ما يستحيل رجوعه سيعود ثانية وأنها تخلو من كل كدرة.
وينبغي أن نؤمن بأن حركة المجون في العصر لم تكن تعم الناس جميعا، إنما كانت تعم في بعض قصور ذوي السلطان ومن كانوا يفيضون عليه من أموالهم من المغنين والشعراء، أما عامة الشعب فكانت تربض في مسغبة شديدة وقلما عرفت شيئا من الترف أو من الفراغ والثراء.
وكان الموضوع الذي يتصل بالعامة حقّا هو الزهد وما نشأ عنه من التصوف، وبدون شك كانت الحانات والأديرة لا تقاس من حيث الكثرة ولا من حيث عدد من يؤمونها إلى المساجد، وكانت تكتظ بالفقهاء والمحدثين والعبّاد والنسّاك الذين رفضوا متاع الحياة الدنيا، وعكفوا على عبادة الله. وكان بينهم كثيرون من الوعاظ الذين يعظون الناس صباح مساء، وقد رفعوا نصب أعينهم ثواب الآخرة من الجنان والفراديس وعقابها من الجحيم والعذاب المقيم، وهم في أثناء ذلك يدعون إلى الزهد وازدراء المتاع الفاني والإقبال على ما عند الله من المتاع الباقي، مكررين الحديث عن الموت وأن الحياة إنما هي رحلة قصيرة والناس فيها كركب وقوف ينتظر كل منهم دوره، وسرعان ما يختطفهم الموت، فأولى لهم أن يتدبروا حياتهم وأن يتزودوا زادا كبيرا لآخرتهم، زادا من التقوى والصلاح والقناعة. ويكثر الشعر الزاهد في العصر حتى ليتّخذ أحيانا مقدمة للمديح من مثل قول علي بن الجهم (69):
وعاقبة الصبر الجميل جميلة … وأفضل أخلاق الرجال التفضّل
وما المال إلا حسرة إن تركته … رغنم إذا قدّمته متعجّل
وللخير أهل يسعدون بفعله … وللناس أحوال بهم تتنقّل
ولله فينا علم غيب وإنما … يوفّق منا من يشاء ويخذل
وبلغ من شيوع شعر الزهد حينئذ أن اشترك فيه كثير من الشعراء الذين تطفح
دواوينهم بالحديث عن الخمر والمجون، لما كانوا يتنفسون فيه من ترف بالغ مثل ابن المعتز، فكانوا ينظمون منه مقطوعات وأحيانا قصائد طويلة، ولابن الرومي فيه قصائد، بل مواعظ بديعة، من مثل قوله (70):
نبل الرّدى يقصدن قصدك … فأجدّ قبل الموت جدّك (71)
ودع البطالة والغوا … ية جانبا وعليك رشدك
فكأنني بك قد نعي … ت وقد بكى الباكون فقدك
وتركت منزلك المش … يد معطّلا وسكنت لحدك
وخلوت في بيت البلى … وخلا بك الملكان وحدك
وسلاك أهلك كلهم … ونسوا على الأيام عهدك
يتمتّعون بما جمع … ت ولا يرون عليه حمدك
متنعّمين وأنت تح … ت الرّمس يرعى الدود جلدك
وهو يرفع الموت نصب أعين الناس، وكأنه مطبق عليهم، حتى يرتدعوا عن البطالة والغىّ، فعمّا قريب سينزل بهم، وسيرتفع الصياح والضجيج عليهم، وسيتركون القصور المشيدة وينزلون اللحود المقفرة، ويسألهم الملكان عما قدمت أيديهم، ويسلوهم الأهل وينسونهم كأن لم يكونوا شيئا مذكورا، على حين يتمتعون بأموالهم التي جمعوها دون حمد لهم أو ثناء عليهم، وعلى حين يرعى الدود جثثهم وجلودهم، فحرى بالعاقل أن يتدبر أمره، وأن يتزود للآخرة زادا كبيرا من التقوى، فإن الموت له بالمرصاد، وهنيئا لمن انتفع بالموعظة وقدم من يومه وبره لغده.
وقد أخذ ينمو من هذا الزهد موضوع جديد من موضوعات الشعر العربي هو التصوف وسنعرض له في غير هذا الموضع.
ص 228
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الديوان 2/ 712.
(2) الديوان ص 222.
(3) الديوان ص 164.
(4)الديوان ص 192 .
(5)الطبري 9/181.
(6)الديوان 2/877.
(7)عاشره : يبلغ معاشره .
(8)محصدات :محكمات .مرائره:قواه ،وأصلها طاقات الحبال .
(9)الديوان (طبعة دار صادر ببيروت) ص 354 وزهر الآداب 1/ 166.
(10)الجنا :الثمر .الميثاء :السهلة . الريا :الرائحة .
(11) الديوان ص 168.
(12) أغباش: بقايا. حزق: جماعات. جوافل: منزعجة.
(13) الديوان 2/ 987.
(14) المعطفات: المنحنيات.
(15) الديوان ص 159.
(16)سنحا : عرضا أو مارة من اليمين .الجآذر : جمع جؤذر وهو ولد البقرة. المها :بقر الوحش .
(17)الاثمد: الكحل .
(18)الديوان ص38وطاو :جائع .
(19)الديوان ص84.
(20)لبان :لبن .
(21)الكران والمزهر من آلات الطرب الوترية .
(22)التزام : اعتناق .
(22)الديوان 3/ 1637.
(23) زهر الآداب، 3/ 88.
(24) قدرت: فصّلت وقطّعت
(25) ديوان المعاني 1/ 183.
(26) الناقد: المشترى.
(27) الديوان في مجموعة «الطرائف الأدبية» ص 163.
(28) الديوان ص 375.
(29) الفن ومذاهبه في الشعر العربي (الطبعة السابعة بدار المعارف) ص 214.
(30) الديوان ص 361.
(31) الديوان ص 132.
(32) الديوان ص 330.
(33) الشوب: الماء المخلوط. الرنق: الكدر.
(34) الفرق: الخوف.
(35) الديوان 2/ 1045.
(36) مائره: سائله.
(37) ملى: متّسع؟ ؟ ؟ .
(38) النجوم الزاهرة 3/ 127.
(39)زهر الآداب 3/ 88 وانظر معجم الشعراء للمرزباني ص 147.
(40) زهر الآداب 2/ 173.
(41) الديوان ص 187.
(42) الديوان ص 29.
(43) يجدى: يفيد. أودى: هلك.
(45) انظر في القصيدة وترجمة ابن العلاف ابن خلكان (طبع مطبعة الوطن) 1/ 245 وانظر طبقات الشعراء لابن المعتز (طبع دار المعارف) ص 359 وتاريخ بغداد 7/ 379 ونكت الهميان ص 139.
(46) الجرد: الفأر.
(47) الأغاني (طبعة دار الكتب المصرية) 14/ 204.
(48) الأغاني 14/ 209.
(49) زهر الآداب 2/ 246.
(51) الديوان 3/ 1982.
(52) رنقن: كدرن. الطير: التطير.
(53) الموهن: نحو منتصف الليل.
(54) التجهم: عبوس الوجه.
(55) غروا: عجبا. ألوم: ألؤم.
(56) ألوما: ، : أكثر لوما.
(57) وأنعم هنا: وزيادة على ذلك.
(58) الفعال بفتح الفاء: الصنع الجميل.
(59) الديوان ص 27.
(60) الهيمان: العشق الشديد
(61) ديوان المعاني 1/ 244.
(62) ديوان المعاني 1/ 253.
(63) ديوان المعاني 1/ 236.
(64) الديوان ص 422.
(65) زهر الآداب 2/ 216.
(66) تاريخ بغداد 4/ 202.
(67) الديوان ص 238.
(68) الديوان ص 107.
(69)الديوان ص 163.
(70) الديوان ص 127.
(71) أجد جدك: اجتهد في الإخلاص لله والتوبة إليه.
 |
|
| دلَّت كلمة (نقد) في المعجمات العربية على تمييز الدراهم وإخراج الزائف منها ، ولذلك شبه العرب الناقد بالصيرفي ؛ فكما يستطيع الصيرفي أن يميّز الدرهم الصحيح من الزائف كذلك يستطيع الناقد أن يميز النص الجيد من الرديء. وكان قدامة بن جعفر قد عرف النقد بأنه : ( علم تخليص جيد الشعر من رديئه ) . والنقد عند العرب صناعة وعلم لابد للناقد من التمكن من أدواته ؛ ولعل أول من أشار الى ذلك ابن سلَّام الجمحي عندما قال : (وللشعر صناعة يعرف أهل العلم بها كسائر أصناف العلم والصناعات ). وقد أوضح هذا المفهوم ابن رشيق القيرواني عندما قال : ( وقد يميّز الشعر من لا يقوله كالبزّاز يميز من الثياب ما لا ينسجه والصيرفي من الدنانير مالم يسبكه ولا ضَرَبه ) . |
 |
|
| جاء في معجمات العربية دلالات عدة لكلمة ( عروُض ) .منها الطريق في عرض الجبل ، والناقة التي لم تروَّض ، وحاجز في الخيمة يعترض بين منزل الرجال ومنزل النساء، وقد وردت معان غير ما ذكرت في لغة هذه الكلمة ومشتقاتها . وإن أقرب التفسيرات لمصطلح (العروض) ما اعتمد قول الخليل نفسه : ( والعرُوض عروض الشعر لأن الشعر يعرض عليه ويجمع أعاريض وهو فواصل الأنصاف والعروض تؤنث والتذكير جائز ) . وقد وضع الخليل بن أحمد الفراهيدي للبيت الشعري خمسة عشر بحراً هي : (الطويل ، والبسيط ، والكامل ، والمديد ، والمضارع ، والمجتث ، والهزج ، والرجز ، والرمل ، والوافر ، والمقتضب ، والمنسرح ، والسريع ، والخفيف ، والمتقارب) . وتدارك الأخفش فيما بعد بحر (المتدارك) لتتم بذلك ستة عشر بحراً . |
 |
|
| الحديث في السيّر والتراجم يتناول جانباً من الأدب العربي عامراً بالحياة، نابضاً بالقوة، وإن هذا اللون من الدراسة يصل أدبنا بتاريخ الحضارة العربية، وتيارات الفكر العربية والنفسية العربية، لأنه صورة للتجربة الصادقة الحية التي أخذنا نتلمس مظاهرها المختلفة في أدبنا عامة، وإننا من خلال تناول سيّر وتراجم الأدباء والشعراء والكتّاب نحاول أن ننفذ إلى جانب من تلك التجربة الحية، ونضع مفهوماً أوسع لمهمة الأدب؛ ذلك لأن الأشخاص الذين يصلوننا بأنفسهم وتجاربهم هم الذين ينيرون أمامنا الماضي والمستقبل. |
|
|
|
|
لخفض ضغط الدم.. دراسة تحدد "تمارين مهمة"
|
|
|
|
|
|
|
طال انتظارها.. ميزة جديدة من "واتساب" تعزز الخصوصية
|
|
|
|
|
|
|
بمناسبة مرور 40 يومًا على رحيله الهيأة العليا لإحياء التراث تعقد ندوة ثقافية لاستذكار العلامة المحقق السيد محمد رضا الجلالي
|
|
|